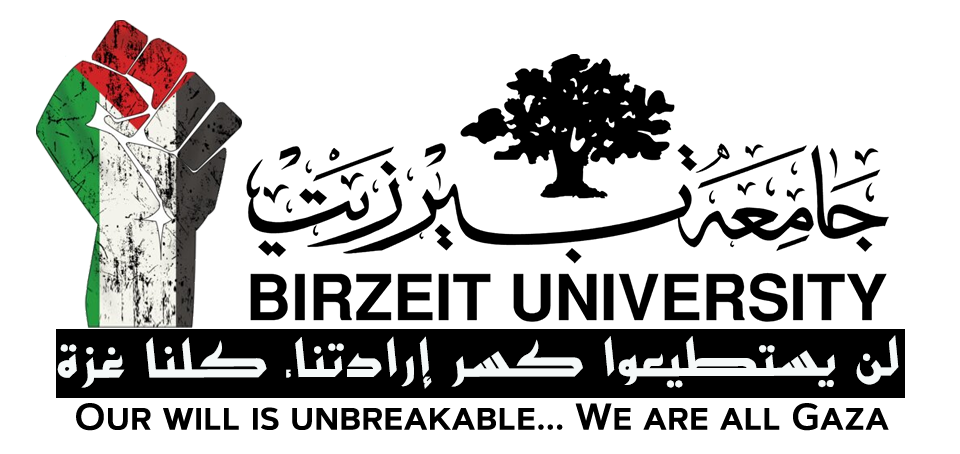في الأيام الأولى عام 1982، تمت مقابلتي في فندق رباح من قبل فريق أعتز بهم فيما بعد: د. نبيل قسيس (رئيس دائرة الفيزياء)، و أ. رمزي ريحان، و د. سامي الصيرفي (عميد كلية العلوم)، و د. غسان ياسين.
كانت مقابلة مهمة، ما زلت أذكر تفاصيلها، فأنا كنت قد عملت في جامعة الكويت التي تخرجت منها كمعيد، ومسؤول الوقاية من الأشعة في وزارة الصحة الكويتية، وفي الجامعة الأردنية، ورغم عملي المؤقت في المدرسة الهاشمية الثانوية التي تخرجت منها، إلا إني كنت تواقاً للعمل في جامعة بيرزيت.
في المقابلة سألني د. نبيل: لماذا تركت الكويت؟ حاولت أن أقرأ ما وراء سؤاله، ثم أتزنت قليلاً، فقلت: مثلنا لا يستطيع الابتعاد عن الوطن. فسارع كعادته في طرح سؤال ثاني: ماذا تقصد مثلنا؟ قلت بهدوء رغم ارتباكي الخفي: الذي عاش في هذا الوطن. وكان قد سأل قبل المقابلة، حين قصد بقالة ابن عمي (قطيفان) على المنارة، حيث لم يكن هناك عنوان محدد أو صندوق بريد: لماذا يتعامل أقاربك بهذه الحساسية حين سألت عنك؟ قلت له: حرصا منهم علي. قال: ولماذا هذا الحرص الزائد؟ قلت: لأنهم لا يعرفونك.
بعد أيام من فتح الجامعة، بعد إغلاق احتلالي، كان د. نبيل، يحمل معي مكتباً من الطابق الثاني، لنضعه في غرفة مكتبي في المبني الجديد. شعرت بالخجل وهو يفعل ذلك، لكنه ابتسم وغمز بعينه، وقال: نحن نتعامل ببساطة، والمراسلات بيننا ببساطة المذكرة التي رأيتها. وبعد سنوات استضفناه في اتحاد الكتاب ليتحدث عن العلاقة بين الشعر/الفن والفيزياء.
اكشتفت أن د. سامي الصيرفي، عميد كلية العلوم وقتها، هو جاري، بالإضافة ل: د. شادي الغضبان، و د. عثمان أبو لبدة، و د. أحمد حرب، و د. وصفي الكفري، و د. نافذ نزال، واساتذة كثر منهم: تيسير العاروري و زياد سعيد وغيرهم، فوجدت نفسي بين أهلي وناسي.
سألني د. غسان ياسين مرة: أتعرف لماذا قبلنا بتوظيفك في دائرة الفيزياء؟ بسبب شاربيك المميزين. ابتسمت، وأنا أعرف أني حاولت تقليد دريد لحام بشاربيه، رغم ما سببه ذلك من بعض المشاكل الشخصية لي، من الأقارب بالذات، فمنهم من دعاني: أبو شنب، وأبو شارب، ولم أستطع حل مشكلتي النفسية معه، حيث كنت أقضمه بأسناني، وأصيبه بالتشوه. رضيت بهذه الصفة، ورضيت أن تكون علامة مميزة لي بالإضافة إلى ميزات كثيرة. غسان ياسين أصبح صديقاً، حتى أننا لعبنا الورق في أكثر من مكان، وكان يحاكي الورق كما يحاكي البشر، وهو نفسه الذي كان يتحدث مع الفوتونات والالكترونات وهو يشرف على مختبر الفيزياء الحديثة.
الأستاذ رمزي ريحان، ظل صديقاً بين شد وجذب، فهو يمشي في ممرات كلية العلوم وغيرها، يحفظها عن ظهر قلب، كما يحفظ أسماء خريجي الجامعة، يدقق رأسه في الأرض، فنعرف أن أمراً ما يشغله، فهو كان بمثابة وزير تخطيط الجامعة، على علاقة مباشرة ب د. حنا ناصر و د. جابي برامكي، حاول بكل جهد أن تكون الجامعة بوجهها الأكاديمي الليبرالي، وهو من أوائل الناس الذين نسقوا مع منظمة التحرير من أجل إنشاء الجامعة (كما علمت لاحقاً)، وهو الفنان الموسيقي، وهو المثقف القارئ، وهو الذي يمتلك رؤية تربوية للتعليم المدرسي والجامعي.
في نهاية الشهر الأول لدوامي في الجامعة، قبضت الراتب الأول، وكان كاملاً. استغربت ذلك، فرغم توقيعي العقد قبل فتح الجامعة، إلا أن الدوام كان في 10 تشرين الأول، وظللت أطالب أني أخذت مبلغاً أكثر مما أستحق حتى خصموه في الشهر التالي.
في رحلة إلى الأردن، تعرفت إلى د. حنا ناصر (رئيس الجامعة)، ووجدت إنساناً بسيطاً، متوقداً، سعيداً بالتعرف على طاقم الجامعة. أحببته، وحملت معي بعض الكتب للمكتبة. شعرت بالفخر بالتعرف إليه، ودامت هذه العلاقة طويلاً، حتى بعد عودته بعد الإبعاد، وكنت أراه صباحاً قبل الثامنة وهو يتجول في أروقة الجامعة، وكنا أحيانا نتناول القهوة الصباحية معاً، وشاركت فيما بعد في عمل بعض العروض العلمية التي كان يراها مهمة في العلوم والفيزياء بالذات، وشاركت في بعض المؤتمرات وحفلات تخريج معلمين قمنا بتدريبهم على بعض التجارب العملية، وساعدته في إنشاء المرصد الفلكي، حتى أنه طلب مني إدارته.
بعد هذا العمر، وهذه السنوات سعدت بالتعرف عن قرب برؤساء الجامعة كلهم، ورغم الخلافات النقابية (وكنت ناشطاً فيها)، إلا أن الاحترام كان له مكانته. سمعت ذلك من أكثر من رئيس جامعة يقول: ما تنجزونه نقابياً سيعود علينا بالفائدة أيضاً.
أصبحت روائيا
كنت قد قررت أن أصبح روائياً قبل الرجوع إلى رام الله التي عشت فيها معظم عمري. بدأت بتقليد الروائيين العرب: عبد الرحمن منيف و حنا مينا، فكتبت ما يشبه "حين تركنا الجسر"، تناولت فيها البيئة القروية، وصيد العصافير الذي لم أفلح يوما في فعله، ولم تطاوعني نفسي لأفعل ذلك، وكنت أتمنى أن لا تقع في الفخ، لكني كنت أراقب الفتيان وهم يفعلون ذلك خاصة الحسون، الذي لم يكن الهدف من صيده أكل لحمه بل اقتنائه. المهم أفلحت في كتابة رواية "الحاج إسماعيل" وقت مرض أبي بالسكري، وكنت أرى نهايته في الرواية قبل نهايته في الحياة، حيث كانت مقولته الأساسية "أحيا بكامل جسدي وأموت به" رداً على محاولتنا قطع رجله ليحيا. فازت الرواية بجائزة اتحاد الكتاب عام 1989 مناصفة مع زميلي "أسعد الأسعد" في روايته "ليل البنفسج"، فأصبحت روائياً، بعد أن نشرت قصصاً قصيرة معظمها في مجلة الكاتب. توالت الأيام وتوالى نشري للروايات التسع.
لا شك أن بيئة جامعة بيرزيت كانت محفزة للكتابة، فأنا أعيش بين ثلة من الأصدقاء والمعارف من دائرة اللغة العربية (محمود العطشان، وعيسى أبو شمسية، وناجي عبد الجبار، وسمير شحادة، وعمر مسلم، وعبد الكريم أبو خشان، وعلي الخواجا، و عبد اللطيف البرغوثي، وغيرهم)، وحظيت بصداقات مهمة (عزت الغزاوي و أحمد حرب و حسين البرغوثي، وغيرهم).
قصدت أن ألف نفسي بهذه العلاقات التي من خلالها أعيشها كإنسان، وتكون ملهماً لي في الكتابة الأدبية، خاصة أني وددت أن أبتعد عن العمل السياسي، وأكون محطة ثقافية، وفعلت.
إغلاقات الجامعة
أغلقت الجامعة عدة مرات، لأسباب وطنية في كل الأحوال، ولا يمكن مقارنة الجهات الداخلية مع الاحتلال، فكلها أسباب وطنية، وطنية الجامعة التي تعززت مع الأيام، وأصبحت صرحاً أكاديمياً وطنياً مميزاً.
جرت نقاشات عديدة حول انقطاع الجامعة عن أداء دورها الأكاديمي، وتأخر تخريج بعض الطلبة. هذا صحيح، ولكن تعريفنا لأنفسنا باعتبار أننا ما زلنا نعيش مرحلة تحرر وطني، يصبح كل شيء مقبولاً.
ليس صحيحاً أن الطالب، والعاملين يتعلمون فقط في الغرف الصفية والمعامل، فما يجري في ساحة الجامعة يعادل بل ربما يزيد عما يحدث داخل الغرف الصفية، فتعلم الطلبة الانتماء وصناعة الهوية وحرية التعبير واحترام رأي الآخر، والتعدد والتنوع. إن جامعة بيرزيت هي حقل تعليمي صفي ولا صفي، فمشاركة الطلبة في يوم الأرض، وفي انطلاقات الحركات السياسية المختلفة، ومواسم الحملات الانتخابية، والوقوف مع الأسرى، وتشييع الشهداء، والانخراط مع شعبنا في مناطقه المختلفة وقضاياه، والتضامن مع شعبنا في الشتات، والتضامن مع الشعوب الأخرى، يفتح أذهان الطلبة لما هو أوسع من صفحات كتاب رغم أهميته.
إن شرط تخرج الطلبة هو اجتياز المساقات المقرة لكل تخصص في إطار تعاوني، مقاوم للظلم بأشكاله كافة، الظلم المحلي والظلم على امتداد الكرة الأرضية. نحن فلسطينيون عرب إنسانيون. هذه المقولة تتحقق من خلال انخراط الطلبة بالنشاطات الموازية سواء قامت بها الجامعة (المعارض، المسارح، الندوات، المحاضرات، الفنون بأنواعها، ...الخ)، أو قامت بها النقابة (الحفاظ على حقوق العاملين والحفاظ على المستوى الأكاديمي وتطويره، ...الخ)، أو مجلس الطلبة (الحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة أكاديمية وطنية، ..الخ). إن كل ما يحدث يومياً وعلى مدار العقود الماضية شكل بيئة خصبة للتعلم، يختار الطالب النشاطات التي يجدها مناسبة وبما لا يتعارض مع الرؤية الوطنية ورؤية الجامعة.
ليس غريباً أن تكون هذه النسبة المحترمة من القيادات المختلفة في مجالات عديدة، تقوم بدور وطني عام، كان ذلك من الأساتذة والموظفين والطلبة. أليس كذلك؟
لا أعرف ما هي المصادفة بين الاضرابات النقابية، ومرض أبي وأمي في الأعوام 1986 و 1987، وحينها وفر لي هذا الإضراب الطويل نسبياً رعايتهما في أيامهما الأخيرة، حتى أن بعض الأقارب رشحني لدخول الجنة مباشرة، لما قدمته لهما. رغم قضائي أشهر في المشفى الحكومي كمرافق، أنام تحت السرير، وأنظف غرفة المرضى، إلا أني لم أفوت أي نشاط جامعي من النقابة أو من الإدارة، مع اختلاف الأماكن. نعم كنا جميعاً في حالة مرضية، نقوم بما يلزم حسب اعتقادنا، وكنا سعيدين بذلك، إلى أن تدخلت القوى الوطنية لإنهاء الإضراب وإنجاز اتفاق ما.
القيادة الوطنية
كان الهم الوطني يشغل القوى السياسية جميعها، وكنت ناشطاً فيها، واختلط الهم السياسي بالثقافي، وكانت جامعة بيرزيت منارة في ذلك، فلم يقتصر العمل فيها على العمل الأكاديمي، ففي أفقها (إدارة ونقابة ومجلس طلبة) الوطن، وكأنه كان مطلوب منا أن نوثق القرى المدمرة، وأن نخلق اقتصاداً مقاوماً، وتراثاً مقاوماً. كانت عيوننا مفتوحة على كل تفصيل يحدث في الوطن، كل الوطن، وخارجه بما مثلته منظمة التحرير، فاغلقت الجامعة مرات عديدة، وتوالى الشهداء الذين ارتبطت أسماء بعضهم بجامعة بيرزيت، أولهم "شرف الطيبي".
من بيرزيت انطلقت المسيرات والمظاهرات انسجاماً مع ما حدث في غزة، والتي سميت فيما بعد انتفاضة، فكانت هناك قيادة وطنية تقرر ماذا بعد، وأين تتجه البوصلة، فكانت نواتها الأساسية جامعة بيرزيت، فاعتقل كثيرون، وأبعد بعضهم، أذكر واجهتها: تامر عيساوي وتيسير العاروري و عمر عساف وفتحية نصرو و سمير شحادة و عزت الغزاوي و محمد عقيل، و أحمد جبر، وعودة شحادة وجمال الشيخ وسامي خضر، وبسام الصالحي، وأحمد الديك ومروان البرغوثي وسمير صبيحات ونايف سويطات ووليد زقوت وناصر عبد الجواد وأحمد قواريق وعمر نزال وغيرهم.
لا عجب أن يحدث ذلك، فهؤلاء كانوا قادة نقابيين في الجامعة، تلك النقابة الفاعلة في ثمانينيات القرن الماضي، حتى أن العديد من النقابيين في الوطن حاولوا الأخذ بتجربتها، ولم تكن فقط الهيئة الإدارية هي الفاعلة، فلجانها كانت بالمستوى نفسه، وكان للجنة المهتمين الدور الفاعل والمقرر، حتى أن الهيئة الإدارية كانت بالمستوى نفسه.
روح بيرزيت
لا أعلم من أول من جاء بهذا المصطلح، ربما د. جابي برامكي الذي كان جاراً لنا ونحن فتيان، لكن هذه الروح كانت تسري في دمنا، فلم نكن نحن موظفين أو أساتذة أو عمالا بالمعنى الحرفي للكلمة، كانت بيرزيت لنا، ونحن لها. لم يكن المقياس بساعات الدوام هو الدليل، فكنا نتأخر في الجامعة أو نأتي مبكرين كلما كان ذلك ضرورياً، ولم تكن الجمع والآحاد هي عطل بالمعنى المتعارف عليه، فيمكنني أنا كما الآخرون أن نعيش في الجامعة حتى ساعات متأخرة، نناقش ونعمل، ونتطوع في مشاريع داخل الجامعة وخارجها. هناك العديد من الأمثلة: يوم الشجرة، يوم الأرض. كان كل وقتنا عمل وحوار ونقاش وعصف وفكاهة.
روح بيرزيت هي روح الحياة، ومن خلالها نشعر بالرضى. من منا لا يذكر مسيرة يوم استشهد شرف الطيبي؟ ومحاولة اقتحام الحواجز وقت إغلاقها، والتسلل للعمل فيها، والتدريس في البيوت الخاصة والمستأجرة، ومهرجانات التراث السنوية، ...الخ. لم نندمج نحن العاملين فقط في الجامعة في هذه النشاطات، بل أسرنا أيضاً وأقاربنا، ومعارفنا وأصدقاؤنا.
لم تكن الفروق بين المدرسين والموظفين والعمال واضحة، وكنت أشعر بالراحة حين أساعد موظفاً من الدائرة أو خارجها، وكذلك مهام العمال. كل العمل الذي نقوم به هو في خدمة الجامعة، وزبائنها الأساسيين، الطلبة. زبائنها! إنها لهم، وهم لها، وما زلنا نلتقي أحياناً ونذكر الزمن الجميل.
قمنا بتدريس المساقات بدل الذين لم يستطيعوا الوصول إلى الجامعة نتيجة الإغلاقات أو الاعتقالات أو المرض أو لأسباب طارئة، ولم نفكر بأن نأخذ بدلاً مالياً، كان يكفينا أننا نقوم بالمهمة، فنحن أسرة واحدة، تتداعى كلما كان ذلك ضرورياً.
أذكر أن رئيس الدائرة طلب مني أن أرفق فواتيري البيتية، لأني استخدمت الكهرباء والماء والغاز أثناء تدريسي بعض المساقات في بيتي، ليتم صرفها من الجامعة. رفضت أن أفعل ذلك رغم انخفاض سعر الدينار إلى النصف.
عندما كنت أقوم على العروض العلمية، وكان يأخذ مني جهداً مضاعفاً، كنت أقضي أيام العطل والأعياد في الجامعة أنا وزملاء لي، كما كنت أجوب المحال التي لها علاقة بالعروض المنوي القيام بها، ذهبت إلى القدس ونابلس والخليل، وكنت أقضي ساعات بعد الدوام في المناطق الصناعية في البيرة ورام الله. كنت سعيداً بذلك، كنت مثل طائر أشعر بقيمة الذي أقوم به وأنا أحلق باسمي وباسم الجامعة، وسعدت أكثر بزيارات طلبة المدارس والجامعات الأخرى وهم يثنون على عملي، وسعدت أكثر وأكثر حين زارنا خبير المتحف في "سان فرانسيسكو"، وهو يربت على كتفي ويهنئني على هذا الإنجاز، وهذا التعدد في مواضيع مختلفة.
أعطيت جامعة بيرزيت كما أعطتني
لست بصدد ترجيح كفة على أخرى، فأنا أعطيتها كل ما أستطيع ليس في المجال الأكاديمي والفني والإداري فحسب، بل في المجالات المرافقة، من ثقافية وتراثية وفنية وأدبية، وأعطتني هويتها، وكان يكفي أنني من جامعة بيرزيت، ليس هنا في الوطن فقط وإنما خارجه، حتى حين ذهبت إلى جامعة رتجرز (نيوجرسي)، سألوني عن هنري جقمان و ناجح الجسراوي، وفي جامعة برنستون التي كانت لا تبعد كثيراً، واستضافني بعض المؤيدين للقضية الفلسطينية أمثال "رونالد ويتن" الذين كانوا يعرفون تيسير عاروري جيدا.
هذا دفعني لأن أكون على قدر التحدي، ليس في المجال الأكاديمي فقط، وإنما بالرؤية الليبرالية الساعية للحرية.
كنت قد أنشأت مجلة "الفيزياء للجميع" في العام 1983 واستمرت حتى نهاية الثمانينيات، و حملة "العلم للجميع" في العام 1998 بالتعاون مع مؤسسات أخرى خارج الجامعة، وقمت بصياغة اختبار مقنن وثابت لمادة المختبر الثالث، ما زال يستخدم حتى اليوم، وقمت بتركيب مساقات مخبرية على "مودل"، وساهمت بإنشاء العروض العلمية والمتحف العلمي والتكنولوجي، والمرصد الفلكي، وكنت عضواً في لجنة الوقاية من الأشعة، ومنسقاً في مهرجان العلوم في فلسطين، وشاركت في تحكيم العروض العلمية في الجامعة وخارجها بالتعاون مع مدارس أو مع وزارة التربية والتعليم، وتم ترشيحي لجائزة "كالنجا" لدوري في تبسيط العلوم العامة، وشاركت في لجان عديدة منها: اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الطلبة، ولجنة النظام، ولجنة التخريج، ولجنة انتخابات النقابة ولجنة تحكيمها.
زملاء أفتخر بهم
الجامعة ليست مباني فقط، وليست نظاماً فقط، وليست طلبة أو عاملين فقط، هي كل ذلك، ويمكن تعريف الجامعة برموزها الإدارية (د. حنا ناصر، د. جابي برامكي، د. عبد اللطيف البرغوثي، د. أحمد بكر، د. نبيل قسيس، د. خليل الهندي، د. عبد اللطيف أبو حجلة، ...الخ)، وطاقمها الأكاديمي (د. هنري جقمان، د. جورج جقمان، د. ليزا تراكي، د. شريف كناعنة، د. سري نسيبة، د. عبد السلام عبد الغني، و د. نضال صبري، و د. سعيد زيداني، و د. صالح عبد الجواد، و د. عزمي بشارة، و د. عبد الرحيم الشيخ، و د. سعيد هيفا، و د. مروان عورتاني، و د. محمد شتيه، و د. زياد أبو عمر، و د. علي الجرباوي ...الخ)، وطاقمها الثقافي (د. أحمد حرب، و عزت الغزاوي، و د. عبد الرحيم الشيخ، و د. حسين البرغوثي، ...الخ)، وافتخر إذا كنت ضمن هذا الطاقم.
زملاء عديدون صادقتهم وزاملتهم، أحمل لهم كل مودة (أ. زياد عزت، و أ. رمزي ريحان، و د. ادوارد صادر، و د. يوسف السلامين، و د. ناجح الجسراوي، و د. عزيز شوابكة، و د. هنري جقمان، و أ. غسان أندوني، و أ. غسان عباس، و د. نقولا ضبيط، و د. مايك سيلي، و د. غسان ياسين، و أ. سامي ناصر، و د. وائل قراعين، و د. يعقوب عنيني، و د. جمال سليمان، و د. وفاء خاطر، و د. إسماعيل بدران، و د. عبدالله السيد أحمد، و د. حازم أبو سارة، و د. خالد عيد ...الخ).
وفي دائرة التربية أذكر من درسوني في مرحلة ما ثم أصبحت زميلاً لهم ولغيرهم: د. عثمان أبو لبدة، د. أجنس حنانيا، د. ماهر الحشوة، د. فطين مسعد، د. أحمد بكر، د. فتحية نصرو، د. خولة الشخشير، د. جهاد الشويخ، د. ابتسام أبو دحو، د. موسى الخالدي، د. نادر وهبه، د. رفاء الرمحي، د. أحمد جنازرة، د. علا الخليلي، د. عبدالله بشارات، د. أحمد فتيحة، د. حسن عوض، أ. منير الرفيدي، أ. وائل كشك، وأخرين.
كل هؤلاء صنعوا هويتي، وربما ساهمت في صناعة هويتهم أو لامستها.
علاقات متشعبة

لم تتوقف علاقاتي داخل دائرة الفيزياء. كنت متعدد متشعب، لي في كل دائرة محطة أو أكثر، فدائرة اللغة العربية محطتي وبالذات بالعلاقة مع د. محمود العطشان، ودائرة اللغات والترجمة والأدب الإنجليزي من خلال عزت غزاوي و د. إلهام أبو غزالة، وكلية الهندسة: د. عفيف حسن، و د. وصفي الكفي، و د. شادي الغضبان، و د. فيصل عوض الله، وغيرهم كثير
امتدت علاقاتي خارج الجامعة، منها الملتقى الفكري/ القدس، وجمعية إنعاش الأسرة/ خالتي أم خليل و عبد العزيز أبو هدبة، وجمعية أصدقاء المجتمع/ رام الله، ودار الطفل/ القدس، وجمعية الدراسات العربية/ القدس، وباسيا/ القدس، ومسرح الحكواتي، ومسرح السراج، ودار الكاتب/ أسعد الأسعد، ومجلة الفجر/ علي الخليلي، وجريدة القدس، ورابطة الصحفيين، بالإضافة للجامعات المختلفة بالذات النجاح والقدس.
اتحاد الكتاب له قصة طويلة، أفتخر بالعديد ممن عرفتهم: عبد اللطيف عقل، والمتوكل طه، و عزت الغزاوي، وسمير شحادة، وجميل السلحوت، وإبراهيم جوهر، وديما السمان، وأسعد الأسعد، وخليل توما، وعبد الناصر صالح، و ربحي الشويكي، والكتاب العديدين من الكتاب الذين عادوا بعد إنشاء السلطة الفلسطينية.
ما الذي وددت أن يكون؟
- الحفاظ على جامعة بيرزيت متميزة أكاديمياً في إطر وطنية بتشكيلاتها المختلفة، ضمن رؤية واضحة مخطط لها.
- كان يمكن للمتحف العلمي والتكنولوجي أن يكون له مكانته في الجامعة وفي الوطن، ورغم أن الجامعة ابتعثت أحد طاقمها في أوائل الثمانينيات لهذا الغرض، إلا أنه لم يستكمل بعد، لكن الحاجة تبقى في غرف التدريس وفي الممرات، وفي موقع المتحف، وليحافظ على ما أنجز من جعل هذا النشاط منارة لطلبة الجامعة والمدارس والجمهور بشكل عام.
- يقوم المرصد الفلكي بنشاطات مهمة، لكن يمكن عمل الكثير باجتذاب جمهور من داخل الجامعة ومن خارجها، ونسج علاقات علمية مبنية على بيانات وخطط مع مؤسسات مثيلة في الوطن العربي وفي العالم.
- بما أنني تربوي، بالإضافة لكوني فيزيائي تجريبي على الأغلب، فإني أرى أن تكون العلاقات مفتوحة أكثر بين الكليات المختلفة، والدوائر والمراكز، ليكون التكامل أكثر وضوحاً، وليس مجرد صدفة، ويبقى السؤال: ما هي العلاقة الواضحة بين كلية التربية والكليات الأخرى ما دمنا نتحدث في النهاية عن مؤسسة تربوية؟
- بما أن الفيزياء شكلت المحور الأساس في الفلسفات الحديثة بالذات، فلماذا لا تقدم دائرة الفيزياء مساقاً عاماً لكل طلبة الجامعة، وبالذات في فلسفة العلوم وتاريخها، ورغم وجود مساقات تلامس ذلك في دائرة الدراسات الثقافية، لكن أن يكون ذلك بالتعاون مع الفيزيائيين، سيعطيه نكهة أخرى.
- ماذا عن الطاقات والخبرات التي تكونت، ثم وصلت إلى سن التقاعد؟ أليس من الضروري أن يكون هناك إطار رسمي يستفيد من خبراتهم والمشاركة الفاعلة في وضع مقترحات لبعض الملفات، أو فتح ملفات لم يستطع العامل القيام به وهو على رأس عمله؟
- هل تنقطع علاقة المتقاعدين مع الجامعة بمجرد وصولهم سن التقاعد؟ وأين مكانة هذا الارتباط لعقود مختلفة؟ حاولنا كنقابة وإدارة في زمن ما أن ننشء نادي جامعة بيرزيت، حيث يلتقي الناس، يتحاورون، ويتناقشون، ويتسلون، ويأكلون، ويشربون، فأين وصلنا؟
- كم وددت أن تكون الألعاب الشعبية جزءاً أساسياً أصيلاً في برنامج مشترك بين أكثر من دائرة، منها التربية الرياضية ودائرة اللغة العربية والدراسات الثقافية وعلم الاجتماع. كنت قد بدأت بكتابة المشروع بإشراف المرحوم عبد اللطيف البرغوثي، لكنه لم يستكمل لوفاته. إنني أتحدث عن برنامج متكامل يحاكي "تلي ماتش" الألماني و "الحصن" الياباني.
- كنت قد اقترحت مساقاً أولياً عاماً لكل الطلبة، يكون مدخلاً لجسر الهوة بين الجامعة والمدرسة، فيه: كيف نقرأ المقالة ونلخصها؟ كيف نبحث عن المقالات الضرورية؟ كيف نرسم خارطة مفاهيمية للمادة الدراسية؟ كيف نستخدم المكتبة العامة أو الالكترونية؟ كيف نبحث في الانترنت عما يساعدنا في البحث العلمي؟ كيف نكتب مخططاً لبحث علمي؟ كيف نقدم أفكارنا لآخرين؟ كيف نعمل جماعياً، ونوزع الأدوار بيننا؟ كيف نختار ما نود عمله من بين بدائل لامتناهية؟ ...الخ. هل هناك ضرورة لمثل ذلك الآن؟ لا أعرف، فجزء منه يتعلمه الطلبة في مساقات أخرى أو في برنامج مساري.