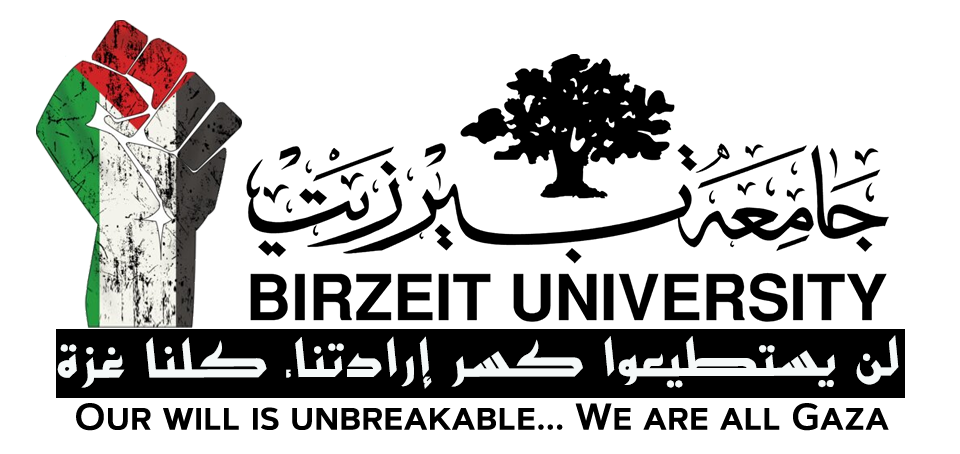مع أنَّ هذا المؤتمر يعنى بعدمِ النزاهةِ في الحكم، سأستخدمُ العباراتِ المرادفةَ والمتعارفَ عليها في أدبياتِ الموضوع، وعلى نطاقٍ عالمي؛ أي الفسادَ، والفسادَ السياسي. ولعلَّ ائتلافَ “أمان” اختارَ عبارةَ “عدمُ النزاهةِ في الحكم” بديلاً، من بابِ التلطفِ والتأدبِ والكياسة، ربما خشية من وقعها على أذن من لم يألف استخدامها بمعناها الدقيق، والخلط الخاطىء بينها وبين الموقف السياسي أو الرأي السياسي.
لذا، أشيرُ ابتداءً، إلى أن الفسادَ في السلطةِ العموميةِ يُعرفُ بأنه استخدامُ المنصبِ العامِّ لأغراضِ منفعةٍ شخصيةٍ أو مصلحةٍ خاصة، ويُعرف الفسادُ السياسيُّ بأنه استخدامُ المنصبِ العامِ لأغراضِ منفعةٍ سياسيةٍ خاصة، سواء أكانت شخصيةً أم حزبية. ولا يوجدُ فصلٌ مطلقٌ بين هذينِ النوعينِ من الفساد؛ إذ قد تجتمعُ المنفعةُ الشخصيةُ مع الحزبيةِ أو السياسيةِ في كثيرٍ من الأحيان، لكن الفصلَ بينهما ضروريٌ، لأنه ليس كلُّ منفعةٍ شخصيةٍ لها بالضرورةِ بعدٌ سياسي، حتى لو بدا أن كلَّ فسادٍ من أيِّ نوعٍ مهما كانَ صغيراً، يُحدِثُ ضرراً للقطاع العام.
في الحالةِ الفلسطينية، الأمثلةُ عديدةٌ على هذا النوعِ من عدمِ النزاهةِ في الحكم، لعل آخرَهَا تأجيلُ الانتخاباتِ النيابيةِ إلى أجلٍ غيرِ مُسمّى، بحجةٍ لم يقبلها أحدٌ غيرَ أصحابِها المستفيدينَ من التأجيل، وباعتقادٍ واسعٍ لدى الجمهورِ أن السببَ هو الخشيةُ من النتائج؛ أي إنَّ الفسادَ السياسيَّ يكمنُ في استخدامِ المنصبِ العامِّ لأغراضٍ حزبيةٍ خاصة. لكن، قد يقول قائل، إن في هذه الحالة، وبالاختلافِ عن حالاتٍ أخرى، لا يوجدُ نصٌ صريحٌ يمنعُ التأجيل إلا في حالاتٍ محددةٍ منصوصٍ عليها، وبالتالي لا يمكنُ اعتبارُه فساداً سياسياً من منظورِ القانون. والأمرُ ذاتُهُ قد ينطبقُ على كلِّ القوانينِ التي أصدرَها الرئيسُ كقرارات، وفي هذهِ الحالةِ بوجودِ نصٍّ في القانونِ الأساسيِّ يتيحُ ذلك في حالِ عدمِ انعقادِ المجلسِ التشريعي.
لا أريدُ الدخولَ مطولاً في هذا النوعِ من النقاش؛ ذلك أنني أريدُ أن أصلَ في النهاية إلى استخلاصٍ محددٍ حول أولوياتِ العملِ من أجلِ الإصلاح. لكن أشيرُ بسرعةٍ إلى أن الاعتمادِ على النصِ المشارِ إليه في القانونِ الأساسي، الذي يخوّلُ الرئيسَ إصدارَ قراراتٍ لها قوة القانون، تتعارضُ مع روحِ النص؛ ذلك أن القانونَ الأساسيَّ لم يتصور، وربما لم يتخيل، أن إصدارَ قوانينَ على شكلِ قرارات، “في غيرِ أدوارِ انعقادِ المجلسِ التشريعي” كما يجيءُ في النص، سيستمرُ إلى سنوات مديدة. لكن ما هو أهمُّ، إذا كان النص هو الحكم على ماهية الفساد السياسي، أن المادة الخامسة من القانون الأساسي تحددُ، بوضوح، أن نظامَ الحكمِ في فلسطينَ هو “نظامٌ ديمقراطيٌ نيابيٌ يعتمدُ على التعدديةِ السياسيةِ والحزبية”. وهذا بحكمِ التعريفِ يتضمنُ ثلاثَ سلطاتٍ مستقلةٍ عن بعضها البعض. والحاصلُ الآن هو انتفاءُ هذا الاستقلالِ باستحواذِ السلطةِ التنفيذيةِ على صلاحياتِ المجلسِ التشريعيِ وتفردِها في إجراءِ تغييراتٍ في السلطةِ القضائية، أيضاً، بما يخالفُ المادةَ 97 من القانونِ الأساسيِّ التي تنصُّ على استقلاليةِ السلطةِ القضائية. والنتيجةُ هي أن النظامَ السياسيَّ القائمَّ حالياً ككل، غيرُ قانونيّ، من منظور القانون الأساسي.
غيرَ أن القانونَ لا يوفرُ دائماً أساساً للشرعيةِ السياسية، فقد يكونُ عملٌ ما قانونياً ولكنه غير شرعي، مثلاً إن لم يحتوي القانونُ أو النظامُ الداخليُّ لوزارة ما على نصٍّ يمنع الوزيرَ نفسَه أن يوظفَ أقرباءَ له. والأصل في القانون هو الإباحة، وما لا يتعارض مع القانون ليس غير قانوني. صحيح قد يُسرعُ البعضُ إلى القولِ إن هذه ثغرةٌ في القانون، لكنها ثغرةٌ بموجبِ ماذا؟ بموجبِ ما هو في النهايةِ أحدُ أسسِ الشرعيةِ السياسيةِ التي تمنحُ القانونَ شرعيتَه، وإذا تعارضَ القانونُ مع أحدِ هذه الأسس، يصبحُ القانونُ نفسُه غيرَ شرعي. ما هي بعضُ هذهِ الأسسِ فيما يتعلقُ بموضوعنا؟
في أحدِ استطلاعاتِ الرأيِ التي أجراتها مؤسسة “أمان” قبلَ بضعةِ أعوام، أجابَ أغلبية من الجمهور عن السؤالِ حول أي نوعٍ من أنواعِ الفسادِ أكثرَ انتشاراً في القطاع العام، وكانت الإجابة: الواسطة والمحسوبية. ما هي الواسطة والمحسوبية؟ ما هي المشكلةُ هنا من منظور الجمهور؟ المشكلةُ هنا هي غيابُ معاملةِ الجميع بالمعيارِ نفسه. هم يفترضون أن غيابَ هذا المعيارِ يشكل انتهاكاً أساسياً للعدالةِ التي تتطلبُ معاملةَ الجميعِ بمعيارٍ واحد. وفي حالِ وجودِ استثناءاتٍ، فيجب أن تكونَ هذه معروفةً وعلنيةً ومبررة، وأن يُعاملَ جميعُ من ينطبق عليهم الاستثناء بالمعيارِ نفسه أيضاً. إن منطلقَ الجمهورِ، هنا، يكمنُ في مبدأ أخلاقيٍّ يعرفونه جميعاً، يوفرُ أحدَ أسسِ شرعيةِ النظامِ السياسيِ وشرعيةِ القانونِ أيضاً، ويمكنُ بموجبه اعتبارُ القانونِ شرعياً أو غيرَ شرعيٍّ في حالِ تعارضِهِ أو إغفالِهِ هذا المبدأ. ويعرفه الأطفالُ أيضاً. مثلاً، يأتي أبٌ أو تأتي أمٌ من سفرٍ بهديةٍ لأحد الولدينِ أو البنتينِ دونَ الآخر أو الأخرى، ودونَ سببٍ معروفٍ أو معلن. تعرفون ما سيكونُ موقفُ الطفلِ أو الطفلة. شعورٌ واضحٌ عارمٌ بالغبنِ والتمييزِ والمحاباةِ وعدمِ الإنصافِ وغيابِ العدل. هذا بمعزلٍ عمَّا إذا كان منشأ هذا المبدأ مسعى الإنسان إلى الحفاظِ على الذاتِ ككائنٍ بيولوجي، أو أيِّ سببٍ آخر. هذا لا ينتقص من أهميته كمبدأ أخلاقي مشترك لجميع البشر في عالم اليوم.
وتوجد مبادئٌ وقيمٌ أخلاقيةٌ أخرى تشكلُ أسساً للشرعيةِ السياسيةِ، ولشرعيةِ القانونِ أيضاً. على سبيل المثال، فصلُ السلطاتِ وعدمُ وجود تعارضٍ في الأدوار وتعارضٍ في المصلحة. هذا مبدأُ معروفُ في الحياةِ العامةِ وفي عملِ المؤسسات، مثلاً في التوظيف، أن لا يشاركَ أحدٌ في اتّخاذ قرار لوظيفة، إن كان في لجنة التوظيف في وزارة، أو في جامعة أو جمعية، أو ما شابه، إن كان أحدُ أبنائِه أو بناتِه أحدَ المتقدمين للوظيفة؛ أي منعاً للتعارضِ في المصلحةِ وفي الأدوار أيضاً؛ الدورَ المتوقعَ من عضو اللجنة، ودورَ الأبِ أو الأم. والمبدأُ نفسُهُ معروفٌ في التراث الشعبي، مثلاً في القول: لمن تشتكي إن كانَ غريمَك القاضي. وأيضاً في الشقِ الثاني من بيتِ المتنبي الشهير: فيك الخصامُ وأنت الخصمُ والحكم. وإذا كان الخصمُ السلطةَ التنفيذيةَ، لن تستقيمَ العدالةُ دونَ فصلٍ للسلطات. ويعرفه الأطفالُ أيضاً، في الرفضِ المتوقعِ لأن يكون أحدُ طفلين متخاصمين هو الحكمُ أيضاً.
ما علاقةُ هذا بالنظامِ السياسيِ الفلسطينيِ وبالفسادِ السياسي؟ سأبدأُ بالإشارةِ إلى الانقسامِ مقارنةً مع دولٍ أخرى فيها منافساتٌ حزبيةٌ أيضاً، قد تكونُ محتدمةً، كما في إسرائيلَ والولاياتِ المتحدة على سبيلِ المثال. تتم المنافسةُ باختلاف أنواعها بين الأحزابِ ضمنَ الإطارِ القضائيِّ والقانونيِّ للدولة. فالدولةُ ومؤسساتُهُا تبقى مستقلةً عن هذهِ المنافسة، وعن أيِّ حزبٍ من الأحزاب. لكن في الحالةِ الفلسطينيةِ، بسببِ تماهي حزبٍ واحدٍ مع الدولة، إن جازَ التعبير، أصبحتْ الدولةُ طرفاً في المنافسة، وطرفاً في الانقسام. وقد لعبت بيروقراطيةُ الدولة؛ أي الوظيفةُ العموميةُ في الوزاراتِ والمكاتبِ الحكوميةِ المختلفة، دورَ المعارضةِ من داخلِ النظامِ بعد تشكيلِ أولِ حكومةٍ برئاسةِ إسماعيل هنية، بعد انتخاباتِ كانونِ الثاني/يناير 2006. ولم تكن الوظيفةُ العموميةُ، في غالبها، مستقلةً عن هذا الصراع، كما هو الحالُ في الدولِ المستقرة. وبانَ بوضوحٍ غيابُ القضاءِ المستقلِ، وحكمُ القانون.
وفي الفترةِ القصيرةِ التي حكمتْ فيها حماس، سعتْ إلى توظيفِ أكبرِ عددٍ ممكنٍ من الموالين لها في وظائفَ عمومية، متخذةً من فتح قدوةً لها في التوظيف. ولما تم النقدُ والهجومُ عليها بسبب ذلك، كان ردُّها أن في هذا ازدواجيةً مجحفةً وغيرَ منصفةٍ في المعايير. وما زال مطلبُها حتى الآن، بعد الانقسام، هو “المشاركة”، ومعنى هذا في قاموسِ منظمةِ التحريرِ الفلسطينية، هو “المحاصصة”، التي انتقلتْ الآن إلى مطلبٍ من داخل بنيةِ النظامِ السياسيِ الجديدِ في ظلِ السلطةِ الفلسطينيةِ بعد إنشائها. هذا على الرغم من الحديثِ المتكررِ عن بناء الدولةِ ومؤسساتِها الذي ما زال معنا حتى الآن، وأحياناً في سياقاتٍ تثيرُ الاستغرابَ والاستعجاب، أو حتى ما هو أسوأ. فعندما تمَّ حلُّ المجلسِ التشريعيِ بقرارِ محكمةٍ مطعونٍ في صحته، قيل عندها، في نوعٍ من الهذيانِ السياسي، إنَ حلَّ المجلسِ يشكلُ مرحلةً أساسيةً من مراحل الانتقالِ من السلطةِ إلى الدولة. هذا، بينما كان حلُّ الدولتين يحتضرُ أمام أعينِ الجميعِ إن لم يكن قد توفي أصلاً. وقد شاهدنا، مؤخراً، بسبب هذا التماهي بين الدولة والحزب، كيف أن المجلس الثوري للحركة استحوذ على صلاحيةِ المجلسِ التشريعيِ من حيثُ منحِ الثقة أو عدمها، للتغييرِ الوزاري المزمعِ إجراؤه.
وخلالَ الأعوامِ الماضيةِ واجهت دولٌ عدة أزماتٍ داخليةً حادة، يوجدُ في بعضٍ منها لنا عِبرٌ حول أولوياتِ الإصلاح. وأشير تحديداً إلى الولاياتِ المتحدةِ في حقبةِ الرئيسِ السابقِ ترمب. فكما هو معروفٌ، يستفحلُ في الولاياتِ المتحدةِ عددٌ من الانقساماتِ المجتمعيةِ العميقة، مضافاً إليها الانقساماتُ السياسيةُ التي تتداخلُ معها في معظمِ الأحيان، إلى درجةٍ غير مسبوقة خلالَ عقودٍ خلت، وبخاصةٍ في حقبةِ الرئيس السابق ترَمب، أو أن حقبةَ ترَمب دفعتْها إلى صدارةِ الواجهةِ بسببِ استثمارِ هذه الانقسامات من قبله. وفي استطلاعِ رأيٍّ تمَّ في العام 2018، أقرَّ 80% من المستطلعينَ بوجودِ هذه الانقساماتِ العميقةِ التي تعبرُ عن نفسها سياسياً؛ إما بتأييدِ الجمهوريين، وإما الديمقراطيين. لكنهم منقسمون أساساً حول مجموعةٍ من القضايا ليست، في معظمها، سياسيةً بالمعنى الضيقِ للكلمة، منها النظرة إلى العرق، والمهاجرون، والحقُ في الإجهاض أو عدمِه، ومتى يصبحُ الجنينُ إنساناً وتحلُّ فيه الروح، وما إذا كانت للجنينِ روحٌ أصلاً، وما إذا كان الاحتباسُ الحراريُّ حقيقةً أو وهماً يروّجه البعض، وما إذا كانت وسائلُ الإعلامِ الرئيسيةُ موضعَ ثقةٍ أم تروجُ أخباراً كاذبةً كما إدعى ترَمب. وتضاف إلى هذا انقساماتٌ حول الحق في حملِ السلاحِ من عدمه، وحول المثليين، وترسباتُ الحربِ الأهليةِ التي انتهتْ العام 1865 بين الشماليين والجنوبيين، والتوجهاتُ العامةُ لسكانِ الأريافِ المزارعينِ المحافظين، مقابلَ سكانِ المدنِ الحضريين. وهذه ليست قائمة نهائية! وقد قام ترَمب ببناءِ قاعدةٍ انتخابيةٍ على مجموعةٍ من هذه الانحيازيات، أو أن هذه القاعدة الانتخابيةَ وجدت فيه تعبيراً عن آرائها وتظلماتها، بما في ذلك الاقتصاديةُ، فتبلورتْ هويتُها ككتلةٍ مجتمعيةٍ-سياسيةٍ بدرجةٍ أكبر مما كانتْ عليه سابقاً، وأوصلتْهُ إلى سُدةِ الحكم.
المهمُّ، هنا، هو أنه في حقبةِ هذا الرئيسِ الشعبويّ والغوغائي والمتقلبِ في مواقفه، تعمّقت هذه الشروخاتُ المجتمعيةُ والسياسيةُ إلى درجةٍ غيرِ مسبوقة، أو أنها ظهرت إلى السطح بقوة اندفاع لم توجد من قبل، وأصبحتْ تهددُ استقرارَ النظامِ السياسيِّ والسلمِ المجتمعي، وتنذرُ بانشقاقاتٍ وهُوَّاتٍ وانقساماتٍ سياسيةٍ ومجتمعيةٍ غيرِ قابلةٍ للردم، بما فيها من تبعاتٍ تهددُ النظامَ السياسيَّ ككل بالتفكك.
لكن، وهنا بيتُ القصيد، بقي النظامُ السياسيُّ متماسكاً على الرَّغم من الضغوطاتِ الكبيرةِ التي تعرّضَ لها، بقي متماسكاً بفعل عواملَ عدة؛ أهمُّها وجودُ قانونٍ نافذ، وقضاءٍ مستقلٍ حكم مراتٍ عدة ضد قرارات الرئيس، الأمرُ الذي اضطر ترَمب إلى التراجعِ عن قراراتٍ عدة. هذا، إضافة إلى سلطةٍ تنفيذيةٍ لا تحجمُ عن تنفيذِ قراراتِ المحاكم. لولا هذا، لتفسخت الدولةُ، وربما عادت إلى نظامٍ كونفدراليٍّ كما كانت قبل أن تتوحدَ في نظامٍ فيدراليِّ.
أعودُ الآن بإيجازٍ إلى موضوعِ الأولوية، واستخلاصِ عِبَرٍ ليس فقط من حالةِ الولاياتِ المتحدة، بل من حالاتٍ أخرى لم أتطرقْ إليها، فيها شروخاتٌ وهواتٌ سياسيةٌ ومجتمعيةٌ عميقة، من بينها عددٌ من الدول الأوروبية، لكن نظامها السياسي بقي متماسكاً، ولم ينهَرْ كما هو الوضع في الحالة الفلسطينية. إن مساعي الإصلاح، باختلافها وتنوعها وتعدد الأطرافِ التي تسهمُ فيها في السياقِ الفلسطيني، مستمرةٌ منذ سنوات، لكن النتائجَ محدودةٌ وضعيفة. والسبب الرئيسي في رأيي هو انهيارُ النظامِ القضائيِ ككل، وهيمنةُ السلطة التنفيذية عليه، وفقدان كل إمكانية للجوء إليه لتحدي السلطة التنفيذية، على سبيل المثال، في موضوع إلغاء الانتخابات النيابية دون مستند قانوني يعطي الصلاحية بذلك. لذا، إن الأولوية الأولى ينبغي أن تتمثل في تضافر الجهود في مجهودٍ جماعي، لكل مؤسسةٍ أو نقابةٍ أو هيئةٍ منظمةٍ في المجتمعِ للعملِ بشكلٍ منظمٍ ومبرمجٍ لغرضِ إصلاحِ النظامِ القضائيِ وجعله مستقلاً عن السلطة التنفيذية. دون ذلك، لن يحدثَ أيُّ إصلاح.
إن الوضعَ القائمَ الآن يكمنُ في أن كلَّ مؤسسةٍ أو هيئةٍ منظمةٍ تنظرُ إلى الإصلاح في الغالب، من منظور عملها التخصصي فقط. هذا خطأٌ كبيرٌ سيبقي الوضعَ على حاله، بل إن السلطةَ التنفيذيةَ قد ترحبُ بهذه المساعي التخصصيةِ المتفرقةِ نظراً لأنها يمكن أن تُصوَّرَ على أنها دليلٌ على حريةِ النقد والتعبير، وعلى وجود مساعٍ “إصلاحية” نشطة. وليس من قبيل المصادفة أن استحوذت السلطةُ التنفيذيةُ على الجهازِ القضائيِ ككل. فهي تدركُ تماماً “خطر” نزاهةِ القضاء واستقلالِه عليها. دون ذلك، سيبقى الوضعُ على ما هو عليه. وستبقى نظرةُ المواطنينَ للسلطةِ السياسية، حتى لو تحولتْ إلى دولة، على أنها دولةُ المحاسيب، أسوةً بعددٍ من الدول العربية التي ثارَ شعبُها عليها لأنها فاقدةٌ للشرعيةِ الداخليةِ من منظورِ تلك الشعوب. وحسبُك بها صفقةً خاسرة.