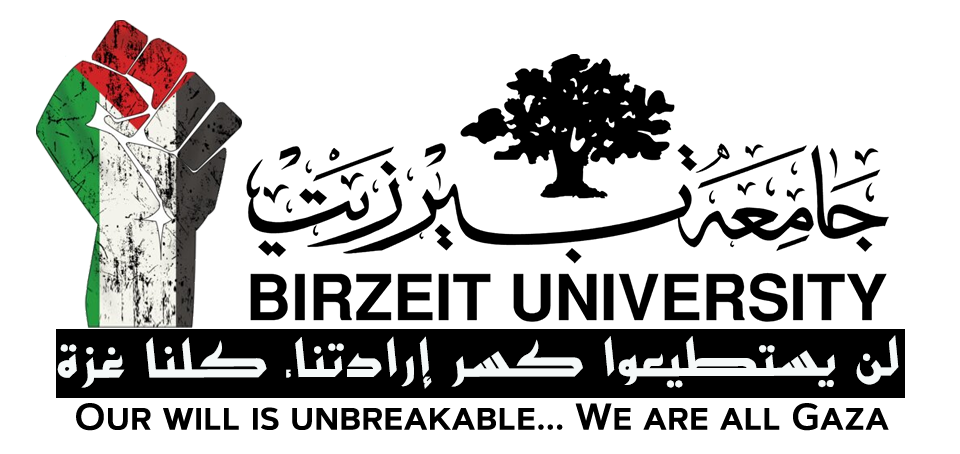ماهية الحرب
يحتار المتتبع لمسيرة الكفاح التحرري الفلسطيني الصعبة والطويلة في اعتماد فصل أو منعطف بعينه ليكون الأكثر قسوة وبشاعة والأشد إجراماً وترويعاً في حرب الإبادة الصهيونية ضد الفلسطينيين منذ نكبة 1948. وربما تتوارى هذه الحيرة قليلاً عند التمعن في تفصيلات الحرب الاستئصالية - الإبادية التي تشنّها دولة الاحتلال على غزة الآن في سنة 2023، مقترفة أبشع المجازر في حقّ المدنيين، ومدمرة لمقومات الوجود الإنساني إلى حد يصعب معه تمييزها، درجة ونوعاً، من الفظاعات التي اقترفتها النازية قبل ثمانية عقود. فقد قطعت دولة الاحتلال عن الناس الماء والغذاء والوقود قبل التهيئة لقتل وحشي ضد الأطفال والنساء وكبار السن، مستخدمة أضخم القنابل بما فيها تلك المحرمة دولياً. وبلغت تلك الوحشية المجبولة بحقد مطلق إلى حد إعادة قتل الجثامين والأشلاء، فضلاً عن تدمير المساكن والمدارس والمساجد والطرقات، الأمر الذي تسبب بتهجير مئات الآلاف من مناطقهم وتشريدهم وملاحقتهم جواً وبراً وبحراً لإجبارهم على النزوح إلى خارج قطاع غزة. وعلى الرغم من حَنَق البشرية واشمئزازها من بشاعة هذا القتل المرفوض في جميع السنن الآدمية والعقائد والمواثيق، فإن إصرار دولة الاحتلال على المضي في هذا القتل يضيف إلى مفردة "الشر" بُعداً وحشياً جديداً سينتظر العالم طويلاً قبل أن يرى أبشع منه. فهذا التقتيل المروِّع يتماهى ببشاعته مع شرور النازية على يد تلامذتها الجدد المتسترين بكونهم ضحيتها، والذين استدخلوا تلك الشرور ويعيدون إنتاجها في غزة اليوم علناً وعلى مرأى العالم. أمام هذا كله، يبرز السؤال: ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها عبر هذه الوحشية، وكيف يمكن تفسيرها؟
هناك طبقتان من الأهداف المفسّرة لهذه الحرب التي جاء هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 ليسلّط الضوء عليها: الهدف الأول آني مباشر يرتبط برغبة دولة الاحتلال في ترميم وعي ذاتها وصورة جبروت جيشها التي تصدّعت في اليوم الأول من الحرب، واستبدالها بأُخرى تبيّن "عظمة" ذلك الجيش الذي لا يُقهر عبر إظهار قدرته اللامحدودة على القتل والترويع والتدمير الهائل لمفردة الحياة. أمّا الهدف الثاني، فيتصل بما تراه إسرائيل إتماماً لحرب استقلالها اللامكتملة في سنة 1948، وبدءاً لفصل نكبوي جديد في حياة الفلسطينيين من أجل تأبيد قهرهم والإمعان في نزع كرامتهم عبر معركة إبادتهم. وإذا ما استثنينا حروبها العدوانية ضد الجيوش العربية، وحربها المستمرة والمسعورة على الفلسطيني وأرضه وموارده (من خلال مصادرة الأرض والاستيطان والإلحاق والضم والتهويد منذ سنة 1967)، فإننا نلاحظ أن دولة الاحتلال لاحقت الفلسطينيين أيضاً، وسعت لتصفيتهم مادياً وسياسياً في لبنان في سنة 1982، ونكّلت بهم من خلال قبضتها الحديدية في انتفاضتَي 1987 و2000، وبالتأكيد من دون أن ننسى عدوانها الإجرامي المتتالي على غزة خلال سنوات 2008، و2012، و2014، و2021، والهادف إلى كسر شوكة المقاومة المسلحة تهيئة لـ "تحييد" الفلسطينيين وإفنائهم.

جزء من معركة تطهير عرقي تشنّها دولة الاحتلال منذ عقود ولم تيأس منها بعد
وإلى جانب البُعد الوجودي لهذه الحرب من منظور دولة الاحتلال، هناك أيضاً أهداف أُخرى مهمة أكثر تحديداً مثل استئصال "حماس" ونسخ نموذج الضفة على غزة لإنتاج "الغزّي الجديد" المسالم والبعيد عن النشاط التحرري، والساعي لتأمين مكاسبه الفردية لا أكثر، وتمكين دولة الاحتلال من إزالة وتجاوز أهم العراقيل (الفلسطينيين) أمام التطبيع مع العالم العربي، وخصوصاً السعودية، فضلاً عن توظيف هذه الحرب لتكون رسالة تهديد واضحة لـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، مثلما هي رسالة لحالة المخاض التي تمر بها علاقات القوة في المسرح الدولي بشكل يخدم مصالح إسرائيل.[1] علاوة على ذلك، ربما يُقصد لهذه الحرب أن تجعل دولة الاحتلال منها ورقة ضاغطة على مصر لقبول صيغة ما لتهجير الفلسطينيين في مقابل تجميد العمل على قناة بن - غوريون المقترحة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، والتي من شأنها أن تنهي أهمية قناة السويس، الأمر الذي سيُلحق الضرر البالغ بمصر.[2]
إذاً، فالحرب الحالية على قطاع غزة والضفة الغربية هي في واقع الحال جزء من معركة تطهير عرقي تشنّها دولة الاحتلال منذ عقود ولم تيأس منها بعد، وتسعى من خلالها لتكثيف المعاناة الإنسانية كي يتسنى لها التهجير الكلي أو الجزئي، في الداخل و / أو الخارج. ولإنجاح هذه الحرب، لا بد من إحداث مزيد من الترويع لتشويه حياة الفلسطينيين وجعلها شبه مستحيلة وبالكاد مستدامة، عبر تعميق تشظّيها المادي والمعنوي من خلال السطو على الأرض والاستيطان والفصل والتمزيق وحشر الناس في جيوب مسوّرة ومعازل ليُحكم الاحتلال قبضته على مختلف تفصيلات حياتهم، بما في ذلك الغذاء والدواء وحركة الناس والبضائع، وليُعمّم بؤسهم ويستديمه كي يُجبرهم على الرحيل عن وطنهم. في هذه الحرب يسطو المحتل على كل شيء حتى الزمن فيصير منطقة محتلة لأنه مرآة تلك المعاني والقيم الدالّة على أزلية الحق، وعبر ذلك يسعى المحتل لبتر ذاكرتهم وتشويه وعيهم وهم غارقون في مشقّات حاضر مؤلم، ومنقطعون عن آمال مستقبل لم تتضح معالمه بعد ليُستَفرد بهم فيقبلوا بمزيد من التبعثر والتهجير.
على الرغم من هذا كله، فإن من الواضح أن فاعلية الاستراتيجيا الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التقليدية تعرضت في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 لخطر جدي بعد أن تصدعت، ولا يبدو أن دولة الاحتلال ستتمكن من تجاوز آثاره كلها (عبر تطوير استراتيجيا بديلة) في المستقبل المنظور. ويمكن فهم الإفصاح مؤخراً عن قدرة دولة الاحتلال النووية الرادعة كمؤشر أوّلي إلى ملامح تلك الاستراتيجيا البديلة التي تنطوي على تأمين درجة من الردع أكثر قسوة وترويعاً، وتأتي حرب الإبادة (أو ما تسميه دولة الاحتلال "تحييد" الفلسطينيين) الدائرة اليوم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كترجمة عينية لما يمكن أن تصل إليه تلك الاستراتيجيا من بشاعة قصوى. أمّا المبدأ الناظم لهذه الاستراتيجيا، فهو أن أي عمل "عدائي" ضد دولة الاحتلال سيقابل من جيشها بعواقب وخيمة غير متوقعة، بما في ذلك فداحة الخسائر في الأرواح والأملاك والمرافق العامة والخاصة. ويُشار إلى تلك الاستراتيجيا بـ "عقيدة الضاحية" القاضية بأن أي هجوم يُشَنّ ضد دولة الاحتلال ويُلحق بها الضرر، يقابَل برد انتقامي عنيف ومدمِّر وواسع النطاق مصحوباً بخسائر هائلة في الأرواح والأملاك والبُنى التحتية. بالتالي، فإنها استراتيجيا لثني أيٍّ كان عن مهاجمة دولة الاحتلال بعد التيقّن من حجم العواقب الجسيمة المرتبطة بذلك. ومثلما حدث في لبنان، فإن هذه العقيدة يتم تحديثها اليوم في قطاع غزة، وهي تأتي كاستجابة لصعوبة ترميم الصيغ السابقة، كشنّ الحروب الخاطفة وإخضاع الأعداء، والإفراط في الاعتماد على التكنولوجيا، والمبالغة بالثقة في الجيش والاستخبارات. ولأن عيوباً كثيرة اعترت هذه الصيغ، فقد زادت جاذبية الاعتماد على البطش العاري والقتل المروع واللامحدود، في إشارة بليغة إلى أن دولة الاحتلال ربما بلغت مرحلة حرجة في منحدر خسارة قوتها. إن الدول التي تفشل في مقارباتها الأمنية والعسكرية تلجأ إلى تورية ذلك بالغرور والنزوع نحو التوحش، كحال النازية والفاشية ودولة الاحتلال، عند انكفائها نحو التقهقر والانحدار وفقدان قدرتها على تجديد البقاء.
ليس متخيلاً ألّا يكون لحرب الإبادة والحرق التي تشنّها دولة الاحتلال على قطاع غزة ارتدادات عميقة وصعبة على حاضر المجابهة ومستقبلها مع منظومة الاحتلال فيما يسميه الاحتلال "يهودا والسامرة". وتعرض هذه المقالة، عبر مناقشة ماهية الحرب وشراكة الغرب فيها، ملامح تلك الارتدادات وسبل توظيفها إسرائيلياً لترسيخ سياسة "التحييد الجماعي" للفلسطينيين عبر الإبادة والتهويد والتهجير، ثم فرض صيغ ما دون وطنية لتسوية الصراع بين المستعمِر والمستعمَر. وتُختم المقالة بطرح بعض التصورات بشأن المطلوب فعله في المرحلة المقبلة فلسطينياً وعربياً وعالمياً.
الغرب الشريك
يلاحظ كارل فون كلاوزفيتز أن الحرب هي امتداد للسياسة، وعلى الرغم من وجاهة هذا الادعاء فإنه يمكن القول إن السياسة والحرب معاً هما أيضاً ترجمة وامتداد للأيديولوجيا، والحرب على غزة تدعم هذا الزعم. فمنذ هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، والذي لا يجوز بتره عن سياقه، اتخذت الدول الغربية مواقف عدائية ضد الفلسطينيين عُبّر عنها بصيغة متنكرة لأدنى حقوقهم الوطنية، وبلغة تطفح بالكراهية والعنصرية والفاشية، في مقابل التعبير عن تعاطف وتضامن ودعم مطلق غير محدود لدولة الاحتلال، ولما سمّته "حقها في الدفاع عن نفسها." فقد توافقت رؤى أغلبية الدول الغربية مع الخطاب الإسرائيلي الفاشي الذي يصور الفلسطينيين كإرهابيين قتلة لا يختلفون عن النازيين وعن تنظيم داعش، وأن الحرب عليهم هي معركة بين الحق والباطل، والنور والظلام، والخير والشر، والحضارة والتوحش، والأخلاق والهمجية. وكان جلياً منذ اليوم الأول أن حرب الإبادة هذه يتم تنسيقها بدقة عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً مع الحكومات الغربية بقيادة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، والتي تقاطر قادتها لإظهار دعمهم اللامحدود لـ "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وتنكّرها السادي لحقّ الفلسطينيين حتى في أن يبقوا أحياء، ورفضها القاطع لوقف إطلاق النار!
وسوّغت الحكومات الغربية مواقفها المتواطئة مع الشر بالقول إنه يحقّ لدولة الاحتلال في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، شنّ حرب إبادة ضد غزة، تماماً مثلما فعلت الولايات المتحدة في أعقاب هجوم بيرل هاربور في 7 كانون الأول / ديسمبر 1941، وبالتالي اندلاع الحرب العالمية الثانية. وفي أعقاب هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001، والتي دفعت واشنطن إلى إعلان حربها العالمية على الإرهاب وغزو كل من أفغانستان والعراق وقتل الملايين. عبر هذا كله، تجاهر الدول الغربية بمواقفها الفاشية ضد الفلسطينيين ممعنة بتناولهم كفائض من البشر يمتهنون القتل ويتقنون الإرهاب، وليس كشعب مُستعمَر يكافح لانتزاع حريته واستعادة كرامته من مستعمِر مجرم. لكن تواطوء تلك الحكومات ومواقفها الفاشية لم ينطلِ على ملايين الأحرار والشرفاء وأصحاب الضمائر من شعوب المعمورة، وهو ما اتضح في التظاهرات العارمة التي لم يحكمها عرق أو لون أو دين أو لغة أو منطقة، مثلما لاحظنا في واشنطن ولندن وبرلين وباريس وسيئول وطوكيو ومدن أُخرى في العالم، والتي تطالب ليس فقط بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، بل بالاستجابة الجادة والفورية لحقّهم المشروع في التحرر والانعتاق أيضاً.
وإلى جانب الهشاشة الأخلاقية التي ميّزت مواقف الحكومات الغربية إزاء جرائم دولة الاحتلال، هناك أيضاً بُعد آخر لا بد من الإشارة إليه يتعلق باهتزاز ثقة الحلفاء الغربيين بقدرة حليفتهم دولة الاحتلال وتدنّي قدرتها على حماية نفسها وحماية المصالح الغربية في المنطقة. وللوهلة الأولى، من البديهي أن يثير الفشل الذريع للمنظومة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية الذي أنجح هجوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر، أسئلة منها ما يرتبط بجدوى الدعم الغربي الهائل لدولة الاحتلال في ظل هذا الفشل الذريع، ومنها ما يتعلق بدولة الاحتلال وحدود اعتماديتها على الدعم الغربي للحفاظ على بقائها وعلى المصالح الغربية في المنطقة. لكن أسئلة كهذه لم تُطرَح، وإنما تم بدلاً من ذلك تأمين الدعم العسكري المدمر المطلوب، فحضرت السفن والبوارج الحربية الأميركية والبريطانية والفرنسية وغيرها إلى سواحل فلسطين المحتلة، وفُتحت مستودعات أسلحة القواعد الأميركية المنتشرة في الدول العربية من أجل مدّ دولة الاحتلال بالذخائر والقنابل الفتاكة والمحرمة دولياً. فبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أسقطت دولة الاحتلال على قطاع غزة ما قدره 25,000 طن من المتفجرات في أول ثلاثة أسابيع من العدوان، أي ما يقارب قنبلتين نوويتين.[3]
وتستمر الحرب!
بصرف النظر عن النتيجة النهائية لحرب الإبادة هذه، فإن من غير المرجح أن تُلَيّن دولة الاحتلال من سياستها الاستيطانية المسعورة في الضفة الغربية وشرقي القدس. ففي حالة "خسارة" الحرب فإنها، ومن باب رد الاعتبار، ستجد نفسها مضطرة إلى تعويض تلك الخسارة وتوريتها عبر تكثيف الاستيطان، وخصوصاً في المناطق المصنَّفة "ج" وكامل منطقة الأغوار إلى أعلى حد ممكن، أمّا في حالة "انتصارها" في الحرب، فإن نشوة الانتصار ستشجع دولة الاحتلال على توسيع الاستيطان وتكثيفه والمضي به حتى النهاية من دون عوائق. وهناك ثلاث ركائز مواتية لتكثيف الاستيطان: واحدة أيديولوجية باعثة عليه، وثانية سياسية لتسويغه ودعمه، وثالثة تتمثل في تجربة الاستيطان العينية ذاتها منذ سنة 1967 لاستكماله والمضي به وتطويره من دون توقف. أيديولوجياً، هناك اليوم صعود مطّرد للفكر الاستيطاني اليميني المتطرف في مختلف مستويات ومجالات الدولة والمجتمع والثقافة،[4] يلازمه تكثيف في استخدام تسمية الضفة الغربية "يهودا والسامرة"، وقد منح قانون "إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي" لسنة 2018 هذا التوجه اليميني دعماً كبيراً لتعزيز الاستيطان. وبالنسبة إلى الركيزة السياسية، فإن الأحزاب السياسية اليمينية المتبنّية للاستيطان باتت تشكّل اليوم قوة مهمة (62 عضو كنيست) تمكّنها من التأثير بشكل كبير في قرارات أي حكومة.
أمّا عينياً، فيرتبط الأمر بتجربة الاستيطان ذاتها وما يتصل بها من تخطيط وتنظيم وبناء وتمويل وما شابه، وهي تجربة أنتجتها وَرَعَتْها الحكومات (اليمينية واليسارية) المتعاقبة على حد سواء. إن عدد المستوطنين اليوم في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا يقل عن 750,000 مستوطن، وهناك تقارير كثيرة منها أوروبية تشير إلى وجود خطط كثيرة لتعزيز الاستيطان وتكثيفه عبر توسيع بناء مستعمرات جديدة وتوسيع أُخرى قائمة.[5] وقد أشار أحد هذه التقارير إلى أن عدد المستوطنين بين جنين ونابلس، والبالغ عددهم اليوم 170,000 مستوطن، سيقفز إلى مليون مستوطن بحلول سنة 2050. وفي حال كانت وتيرة التوسع الاستيطاني في مختلف أرجاء "يهودا والسامرة" هي ذاتها، فمن المتوقع ألّا يقل عدد مستوطني "دويلة المستوطنين" عن ثلاثة ملايين مستوطن بحلول سنة 2050. ولو افترضنا أن تُبدي "دويلة المستوطنين" قدراً من السخاء تجاه غير اليهود في أرض "يهودا والسامرة"، فليس من المرجح أن تسمح بأن يكونوا أكثر من 20% مثلما هي نسبة الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال، الأمر الذي يعني ضرورة التخلص من ملايين الفلسطينيين لاعتبارات أيديولوجية وسياسية يصعب تجاهلها. ومع أن التوسع الاستيطاني قد يخضع لسبب أو لآخر، للتبطيء أو التأجيل أو التعديل، إلّا إنه بصورة عامة سيستمر ولن يتوقف. فقد استمر قبل الانتفاضتين وبعدهما، وكذلك قبل وبعد توقيع اتفاق أوسلو الذي تضاعفت الأنشطة الاستيطانية خلاله سبع مرات، واليوم لا يوجد ما يحول دون استمرار ذلك.
وحتى إخلاء مستعمرات غزة في سنة 2005 تم استغلاله لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ولا بد من الإشارة إلى أن الاستيطان لم يُثر يوماً جدلاً ذا خطورة في الساحة الإسرائيلية الداخلية، وإنما استمر تعاظم تأثيره في الخريطة السياسية، والحياة السياسية الإسرائيلية عامة. وعلى الرغم من معارضة الدول الغربية للاستيطان، فإنها تبقى معارضة محدودة الأثر لأن تلك الدول لا تتخذ أي إجراءات عملية ملموسة لإيقافه. صحيح أن هناك تعاطفاً متنامياً وتأييداً لافتاً لدى الرأي العام العالمي لمصلحة الفلسطينيين بسبب ما تقترفه دولة الاحتلال من مجازر ضد الآلاف من الأطفال والنساء، ومن تدمير شامل لمقوّمات الحياة، إلّا إن من الواضح أن صعوبات جدية تحول دون توظيف ذلك التعاطف والتأييد لإجبار دولة الاحتلال فعلياً على وقف الاستيطان. وحتى التطبيع الذي مضت وتمضي به الدول العربية مع دولة الاحتلال لم يخدم كعامل ضاغط في هذا الشأن كونه لا يشترط وقف الاستيطان أصلاً. ويضاف إلى ذلك طبعاً ليس فقط ضعف السلطة الفلسطينية وعجزها التام عن التصدي الفاعل للاستيطان وعدم مشاركتها الجادة في التصدي لـ "تحييد" الفلسطينيين، وتبنّيها استراتيجيا هي أقرب إلى الأنين والنواح، بل أيضا جَلَدَها العجيب على التأقلم مع تزايد الاستيطان والتعايش مع تبعاته المدمّرة مكتفية بتأسيس صيغة بيروقراطية متواضعة القدرة والتأثير تسميها "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، تُصدر عبارات الشجب والاستنكار.[6]
ما العمل؟
على وقع هذا الشرّ المنفلت على غزة تُستدعى الإرادة وتُستنهض العزيمة لصدّه، ويجد الفلسطينيون أنفسهم مسلحين بغريزة الصمود، لكن بدمهم كي لا يرحلوا إلى جحيم نكبة أُخرى، مدركين أن هذا الشرّ لن يتلاشى ولن يتراجع ما داموا أحياء. صحيح أن هناك نقاط ضعف جدية تعتري دولة الاحتلال، كطارئيّتها وتناقضاتها الذاتية وجنوحها الفطري للتوحش، إلّا إنه صحيح أيضاً أن لديها ما يقابل ذلك من مكامن قوة ستظل تمكّنها من الاستمرار في إنتاج الشرّ وإعادة إنتاجه وتعميمه. وهنا أشير إلى ثلاثة منها: أولاً، بُنية الدولة والمجتمع (على الرغم من بعض التصدعات التي تواجهها أحياناً) وقدرتها على توفير مقوّمات الدعم اليميني - الفاشي المادي والأخلاقي لإبادة الفلسطينيين، فقد بلغت إسرائيل من السماجة الأخلاقية والانحطاط إلى حد تجنيد تلامذة المدارس للمشاركة بهياج قتل الأطفال في غزة! ثانياً، متانة العلاقة العضوية بين دولة الاحتلال وغطائها الاستعماري العالمي وتقديمه ليس فقط الدعم اللامحدود عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً، بل التسويغات السياسية الأخلاقية لإبادة الفلسطينيين أيضاً.[7] ثالثاً، نجاح دولة الاحتلال في تحقيق اختراقات إقليمية مهمة عبر اتفاقيات التطبيع، تلك التي وُقّعت، وتلك التي لا تزال في قائمة الانتظار، وكذلك تغذيتها الانقسام الفلسطيني الداخلي ورعايتها لآثارها التدميرية على الفلسطينيين وتعميق تلك الآثار.
في موازاة ذلك كله، من غير المنظور أن يخبو الحديث الملغّم عن رغبة حلفاء إسرائيل في توليد عملية سياسية بهدف الإيحاء بالرغبة في ترميم حل الدولتين الذي تهالك وصار ذكره يثير السخرية والتندّر لخوائه وعدم جديّته. لكن، كي لا ينجرّ الفلسطينيون إلى هذه المصيدة مرة أُخرى، فلا بد من التوافق على تطوير تصوّر فلسطيني مفصّل يتضمن عدداً من القضايا بينها: الإصرار على وقف حرب الإبادة وعلى تأمين المساعدات الإغاثية لقطاع غزة؛ تشكيل حكومة من كفاءات متوافق عليها تكون مقبولة سياسياً وصاحبة خبرة عملية تهيىء الحال الفلسطينية لانتخابات تُجدّد شرعية التمثيل؛ تأمين مرتكزات ومقوّمات عينية ملموسة لتعميق الصمود في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس؛ تحديد الجوهر التحرري للدولة الفلسطينية العتيدة بوضوح وبعيداً عن الفضفاضية والانفعال؛ الإصرار على تعديل الصيغة التي رعت المفاوضات في الماضي والمسماة "الرباعية"، وذلك عبر تضمينها دولاً وجهات أُخرى مثل الصين وإسبانيا وإيرلندا وتركيا وجنوب أفريقيا والجامعة العربية؛ المطالبة بإصدار قرار أُممي حمائي لضمان التزام دولة الاحتلال بما هو مطلوب منها؛ تحميل دولة الاحتلال تكلفة تدمير قطاع غزة وإعادة إعماره لاحقاً، وكذلك المطالبة بتعويضات من دولة الاحتلال شبيهة بتلك التي تتلقاها هي نفسها من ألمانيا.
نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية
المصادر:
[1] انظر:
Pepe Escobar, “Why the US Needs this War in Gaza”, “The Cradle”, 15/11/2023.
[2] Sarah Khalil, “What is Israel's Ben Gurion Canal Plan and Why Gaza Matters”, “The New Arab”, 17/11/2023.
[3] انظر:
“Israel Hits Gaza Strip with the Equivalent of two Nuclear Bombs”, “Euro-Med Human Rights Monitor”, 2/11/2023.
[4] إن مَيل الإسرائيليين نحو اليمين تكشفه استطلاعات الرأي العام، فوفق استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" في 10 تشرين الأول / نوفمبر فإن 44% من المستَطلعين أفادوا بأنهم يؤيدون البقاء في قطاع غزة بعد احتلاله، كما أفاد 22% منهم أنهم يؤيدون البقاء في قطاع غزة لإحياء الاستيطان هناك. ويتضح أيضاً أن حَنَق جزء مهم من الجمهور في دولة الاحتلال إزاء نتنياهو لا يرتبط بيمينيته وفاشيته بقدر ما يرتبط بعدم قدرته على كبح الفلسطينيين، إذ لم يعترض هذا الجمهور على استهداف الأطفال والنساء والمشافي وقطع الماء والغذاء والوقود والاتصالات لمليوني إنسان.
انظر موقع "ألترا فلسطين".
[5] انظر:
“2022 Report on Israeli Settlements in the Occupied West Bank, Including East Jerusalem, Reporting period: January - December 2022”, “European Union: Office of the European Union Representative (West Bank and Gaza Strip, UNRWA)”, 15/5/2023.
[6] انظر الموقع الرسمي لتلك الهيئة.
[7] لا تزال تقف خلف إسرائيل مجموعة من الدول المؤثرة كنواة صلبة ويحكم هذه الدول قدر عال من الانسجام وهي: الولايات المتحدة؛ بريطانيا؛ ألمانيا؛ فرنسا؛ كندا؛ أستراليا؛ الهند. ولا نلاحظ شبه ذلك في طبيعة الدول المؤيدة للفلسطينيين كالدول العربية وتركيا وإيران وروسيا والصين وغيرها، إذ إن دعمها للفلسطينيين غير مستدام