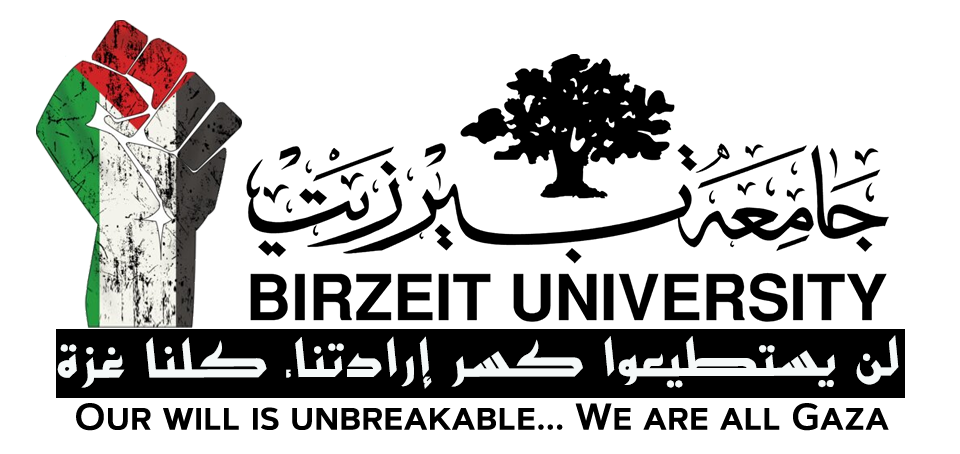أعادتني زيارتي لجامعة بيرزيت يوم أول من أمس لأكثر من ربع قرن من الزمن حين خطوت لأول مرة في حياتي داخل الجامعة التي أدين لها بالكثير. لم تكن بيرزيت، جامعة فقط للعلم، كانت بالنسبة لنا جامعة للحياة أيضاً. كانت أكثر من مقاعد دراسة، وحصص ومقررات ومتطلبات تخرج.
في بيرزيت كنا نتعلم أشياء كثيرة أيضاً عن الحياة وعن فلسطين والسياسة والعالم، وكانت أفكارنا تتصارع وتتحاور بحثاً عن إجابات لقلقنا بعد أن انتقلنا من عالم الطفولة والمراهقة إلى عالم الشباب. وكان هذا الصراع لا يبحث عن إجابة فقط، بل كان يجلب معه أيضاً المزيد من الأسئلة، إنها الأسئلة التي ترفض أن تكون برسم أي إجابة لا تحمل العقل إلى مغامرة أخرى.
كنت برفقة مجموعة من الأصدقاء في زيارة للجامعة وهي على أعتاب انتخابات مجلس الطلاب.
كل شيء في بيرزيت له رونق خاص. هل بيرزيت أكثر جامعة فلسطينية وربما في العالم مسيسة! ربما. ويمكن القول بكل تأكيد. تجرى عشرات الانتخابات في كل الجامعات الفلسطينية الآن، كما كانت تجرى سابقاً، لكن حين يتم تنظيم الانتخابات في بيرزيت يختلف الأمر كثيراً.

صورة من أمام مبنى مجلس الطلبة أيام التسعينيات، وفي الصورة تظهر خيمة اعتصام للطلبة
صحيح أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر ربما أهمها تعدد الجامعات وعدم مقدرة بيرزيت على الاحتفاظ بصيغتها التمثيلية جغرافياً، إذ مثلاً تكاد الجامعة بسبب أشياء كثيرة تخلو من طلبة قطاع غزة ، وبات طلابها في مجملهم من محافظات وسط الضفة الغربية، وهذا مرتبط بطبيعة التحولات في فلسطين وغير مرتبط بحقيقة ومكانة الجامعة ومدى جاذبيتها. لكن رغم ذلك لا تجد اهتماماً في أي انتخابات في كل الجامعات الفلسطينية مثل هذا الاهتمام الذي تحظى به جامعة بيرزيت، حتى تظن أنك على أعتاب انتخابات وطنية شاملة.
كان صديقي وزميلي من أيام الجامعة إياد نصر، يتحدث بشغف عن تلك الأيام ونحن نسير في ممرات الجامعة، عن المناظرات الانتخابية، والخطابات، وكان هو أحد ابرز نشطاء الشبيبة قبل ربع قرن. كأن الزمن توقف. نفس البهجة، ونفس القلق، وذات الزينة التي تملأ كل مكان. الجامعة توسعت وتمددت وكثرت مبانيها.
كنا في ذلك الزمن ألفين وبضع مئات، الآن الجامعة أضعاف أضعاف ذلك. نصف المباني لم تكن موجودة قبل ربع قرن، لكن بيرزيت رغم ذلك لم تتغير، ظلت كما هي، لها نفس الوقع والأثر في الروح وفي النفس. لم نشعر بالغربة، حتى الحنين ذاب بعد دقائق حين بتنا أكثر تأقلماً مع جامعتنا الأولى ونحن ننتقل من مكان لآخر.
الجيش الإسرائيلي يختطف رئيس مجلس الطلاب الحمساوي وقائد الشبيبة الفتحاوي.
في بيرزيت رغم كل شيء تجد فلسطين كلها حاضرة.
كانت المناظرة الانتخابية عشية الانتخابات لا تقل أهمية ربما عن مناظرات الرئاسة الأميركية الشهيرة، وحتى هذه اللحظة مازالت تجد اهتمام الصحافة ونشطاء التواصل لأنها تقليد لا تعرفه إلا بيرزيت.
الزمن لا يعود إلى الوراء، لكن مشاعرنا تفعل. ظللت وصديقي إياد نصر نتأمل كل شيء، مثلما نريد أن نحتفظ بأنفسنا في الزمن الماضي، نحبسها هناك، نحاول أن نعبر السنين لنعود شباناً حين سارت بنا السيارة من غزة إلى بيرزيت تعبر الأماكن تخترق طرقات فلسطين الحبيبة بقراها ومدنها التي ظلت أشجار الصبار على حواف الحقول تشهد بأن "الأرض بتتكلم عربي".
كانت الدراسة في بيرزيت خياراً من خيارات قليلة متوفرة لأبناء جيلي في ذروة الانتفاضة الأولى. لم تكن الجامعات قد انتشرت بذات الطريقة التي انتشرت بها بعد ذلك بسنوات. في غزة لم يكن إلا ثمة الجامعة الإسلامية، وفي الضفة الغربية كان هناك بعض جامعات في قلبها بيرزيت والنجاح وبيت لحم والخليل. الكثير من أصدقائي في الدراسة التحقوا بجامعات الاتحاد السوفييتي الذي كان قد بدأ عملية تفككه القهرية لجملة من الأسباب أهمها عدم ارتفاع تكاليف التعليم هناك.
الكثيرون يريدون أن يصبحوا أطباء، والكثيرات من الأمهات يردن أن يرين أبناءهن "دكاترة". ولم تكن أمي إلا من تلك الأمهات اللاتي يرين في الطبيب شيئاً كبيراً، ربما المهنة الأسمى، فالطبيب في المخيم الذي كان على العائلة أن تعيش فيه بعد النكبة تمتع دائماً بمكانة مرموقة بين الناس وحظي باحترام كبير.
الفلسطينيون وجدوا في التعليم بعد النكبة تعويضاً عن الخسارة الكبيرة التي تلقوها بعد طردهم الوحشي من بلادهم واقتلاعهم من حقولهم.
صحيح أن أقدامهم ظلت تبحث عن حقولها – بمجاز من معين بسيسو – إلا أن المقاربة الأخرى التي سعوا لتحقيقها هي التعويض، فاللاجئ وجد في التعليم فرصة لتحقيق مكانة أخرى تخفف من خسارته وتحقق له أمناً اجتماعياً واقتصادياً في ذات الوقت. لم أرغب في أن أصبح طبيباً، ولم التحق مثل أترابي بجامعات الاتحاد السوفييتي، وخيبت أمل والدتي للحظات، رغم أن هذا أدخل سعادة أخرى على قلبها بأنني لن "أتغرب" وأغيب لسنوات عنها.
عموماً كان الدخول لبيرزيت حلماً. الالتحاق بجامعة الفلسطينيين الأولى حلم كبير. لا أعرف كيف عرفت أمي أن بيرزيت أفضل جامعة موجودة، لكنها قالت إذا ولا بد تدرس هنا فادرس في بيرزيت. والتحقت بالجامعة التي ستظل الأعز على قلبي حتى بعد أن أواصل رحلة تعليمي الجامعي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في بريطانيا وإيطاليا. في السنة الأولى كانت الجامعة مغلقة وكنا ندرس في أماكن تستأجرها الجامعة من أجل أن تتيح للطلاب الدراسة رغم أنف رابين وجنرالاته. ومضى الوقت لأن نهر الحياة لا يتوقف، ليس أعنفها، لكنه النهر الذي لا يعرف السكون، وفتحت أسوار الجامعة بعد سنة من التحاقي بها في خريف العام 1991.
ثمة زفرة قهرية حين نظرت أنا وإياد نصر للخلف، كان ثمة شيء ظل عالقاً هناك. الشيء الذي حين تعود إليه تجده في انتظارك، كان شيئاً لا يتغير.
نشر المقال أيضاً في جريدة الأيام بتاريخ 7-5-2018