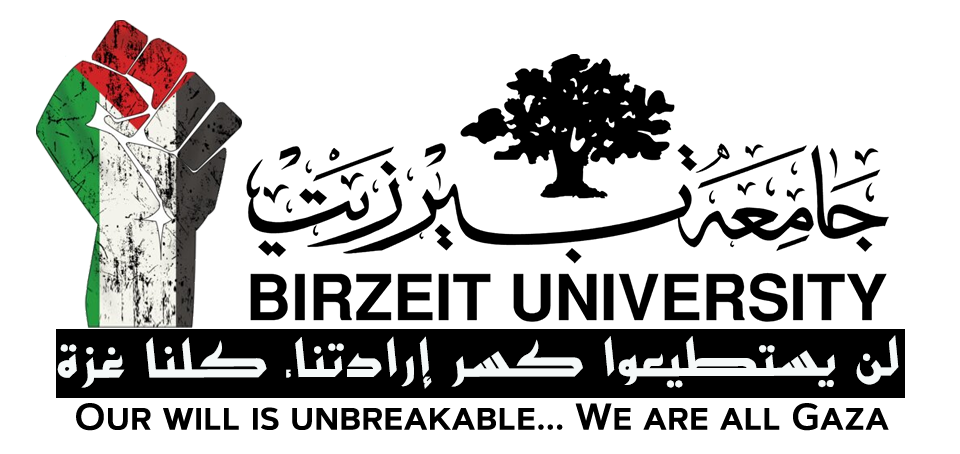أعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى بسبب أخطاء شائعة في الحديث عن حاجة السوق من الخريجين الجامعيين، والافتراض أن التخصصات المختلفة في الجامعات الفلسطينية هي السبب الأهم في البطالة الكبيرة بين هؤلاء الخريجين.
ويزداد الحديث عن هذا الموضوع كل عام مع تخرج دفعة أخرى من خريجي الجامعات، الذين ما يلبث الكثير منهم أن يصطدم بقلة فرص العمل في السوق المحلي، فيزداد الحديث عن التخصصات التي يُفترض أنها غير موجودة في الجامعات، والتي يحتاجها سوق العمل.
والحقيقة هي أن السبب الرئيسي لعدم وجود فرص عمل كافية لخريجي الجامعات، وللقوة العاملة عموماً، هو القيود الموضوعة على التنمية بفعل الاتفاقيات مع الاحتلال، وغياب السيادة على مقدرات الاقتصاد الفلسطيني. هذا ليس رأيي أنا، وإنما رأي البنك الدولي الذي "تعب" من إصدار التقارير التي تدلل على هذا. ويمكن الاطلاع على موقع البنك لقراءة تقاريره حول الموضوع. هذا ليس من باب تعليق الأمر على شماعة الاحتلال، وإنما تبيان حقيقة واقعة.
إضافة إلى ذلك، عندما يجري الحديث عن "حاجة السوق"، ما هو المقصود؟ طيلة ما يزيد على سبعين عاماً، منذ بداية العمل الفلسطيني في الكويت، أولاً كمعلمين في المدارس، ولاحقاً كمهن أخرى، لم يُعَرف السوق فلسطينياً على أنه الضفة الغربية وقطاع غزة فقط. وهذا ليس خاصاً بفلسطين، بل مشترك مع عدد من الدول العربية. ويكفي أن نشير إلى أن عدد العاملين من مصر في المملكة العربية السعودية وحدها هو ثلاثة ملايين مصري، وعددهم في الأردن 1.15 مليون حسب الجهاز المصري للإحصاء. وليس المقصود بهذا تشجيع الهجرة إلى الخارج، وإنما تبيانُ أمرٍ واقعٍ فقط، أسبابه متعددة.
أما الخطأ الثالث المرافق للحديث الفضفاض حول "حاجة السوق"، أنه ينطلق من وجود بطالة بين خريجي الجامعات، ليستنتج وجود نقص في التخصصات الملائمة لهذه الحاجة. لكن هذا يتم دون الرجوع إلى دراسة معتمدة حول حاجة السوق الفعلية، وفي أية تخصصات، والأهم، حدود هذه الحاجة. فماذا إذا تبين أن حاجة السوق محدودة، وأنه بعد تلبية هذه الحاجة المفترضة، ستبقى بطالة كبيرة بين الخريجين؟ هذا تماماً هو استنتاج البنك الدولي، أي أن سبب المشكلة يكمن إلى حد كبير في مكان آخر.
والواقع هو أنه مع ازدياد عدد مؤسسات التعليم العالي، وازدواجية التخصصات في معظم الحقول، بما فيها المهنية، من المتوقع سلفاً عدم وجود فرص عمل لكل هؤلاء الخريجين. والواقع، أيضاً، أن قضاء فترة أربع أو خمس سنوات في الجامعة هي بطالة مقنعة لعدد لا بأس به من الطلبة. وما تقوم به بعض الجامعات من تدريب على "الريادية" كما تسمى، أو أي "تدريب" على تعزيز فرص إيجاد عمل بعد التخرج، ما هو إلى تعزيز للمنافسة الفردية بين الزملاء والأصدقاء والأحباء من الدفعة الواحدة للخريجين، أو، موضوعياً وليس ذاتياً، كيف يتغلب بعضهم على الآخر في السباق للحصول على عمل. ومن يسبق، يسبق، والباقي هم الخاسرون؛ ذلك أن الحل في الغالب ليس في يد الجامعات، وإنما في قدرة السوق الاستيعابية للقوة العاملة ككل التي تبحث عن عمل. هنا يكمن مربط الفرس. فحتى لو تقلص عدد خريجي الجامعات إلى النصف مثلاً، أو حتى إلى ربع العدد الحالي السنوي، ستبان البطالة في مكان آخر، أي بعد المرحلة الثانوية.
وقد مررنا بظرف شبيه بالنسبة للقوة العاملة ككل التي تبحث عن عمل في الثمانينيات من القرن الماضي مع فارق أساسي، والفارق الأساسي لم يكن قلة عدد الجامعات مقارنة مع اليوم، ومن ثم قلة الخريجين، وإنما استيعاب ما يقارب نصف القوة العاملة في أعمال مختلفة في إسرائيل. ولم يكن الالتحاق بالجامعة أولوية أولى للكثيرين من الخريجين بعد المرحلة الثانوية من الدراسة، ولأسباب واضحة. وأرجح أنه لو سمح باستيعاب ما يقارب نصف القوة العاملة الحالية داخل الخط الأخضر، لانخفض عدد من يلتحق بالجامعات بعد المرحلة الثانوية، ورافق ذلك انخفاض حاد في نسبة البطالة، وخفت الحديث عن حاجة السوق.
أما الخطأ الرابع، فيكمن في أن حاجة السوق تكمن أساساً في تخصصات محددة. هذا جزئياً صحيح، لكن في الكثير من الحالات ليس التخصص هو العامل المرجح في التوظيف؛ ذلك أن مشغل خريجي الجامعات ينظر أيضاً، وربما أولاً، لحيازة أو عدم حيازة نوعين من المهارات والصفات: الأول، مهارات محددة مثل حيازة مستوى متقدم من المهارات التحليلية والنقدية، والمقدرة على الكتابة بدقة ووضوح وتسلسل منطقي، والمسماة خطأً مهارات كتابية، إذ إنها مهارات فكرية أساساً وتنعكس على ورق، أو هذه الأيام على شاشة. وليس المقصود هنا الإملاء والقواعد على أهميتهما، وإنما المنطق الداخلي للنص والمقدرة على بناء الحجة والاستنتاج. هذا إضافة إلى إتقان اللغة الإنكليزية كونها اللغة المعولمة في عالم اليوم.
أما النوع الثاني من معايير التوظيف، وبخاصة كونها ضرورية للترقي والتقدم في المنصب من منظور الخريج، وضرورية للكوادر العليا في الإدارة من منظور الطرف الموظِف والمشغِل، فهي مهارات أو صفات شخصية، مثل المقدرة على العمل الجماعي، والمقدرة على حل المشاكل بتنوعها، والمقدرة على التنظيم وتحديد الأدوار، والمقدرة على الإقناع، وهي من أهم صفات القيادة في المؤسسات، والمقدرة على التفكير خارج الصندوق كما يقال، من بين صفات أخرى. هذه صفات شخصية، والدور الأكبر هنا هو للتنشئة الاجتماعية وللمدرسة وللعناصر الطبقية والفرص التي توفرها لتطوير الشخصية.
لكن دور الجامعات يمكن أن يطور ويعزز النوع الأول من هذه المهارات، لكن هذا يلزمه تعليم جامعي لا يركز فقط على التخصص على حساب الثقافة العامة الواسعة وتعزيز المهارات المشار إليها. هنا يكمن الكثير من القصور في التعليم الجامعي الحالي في الغالب، وما يعزز هذا القصور النظرة الضيقة للتعليم لدى العديد من المدرسين، وبخاصة في الحقول المهنية، وبعض الإداريين أيضاً. هنا يكمن دور للجامعات يمكنها القيام به أو إيلاؤه اهتمام أكبر. لكن هذا يلزمه قيادة أكاديمية لها إطلالة واسعة على الحاجات الفعلية والمتنوعة للسوق في عالم اليوم، أو توفر دراسة تحدد الأوزان للصفات والعناصر المطلوبة في التوظيف بتعددها، لتبيان الأولويات لغرض الاسترشاد بها.