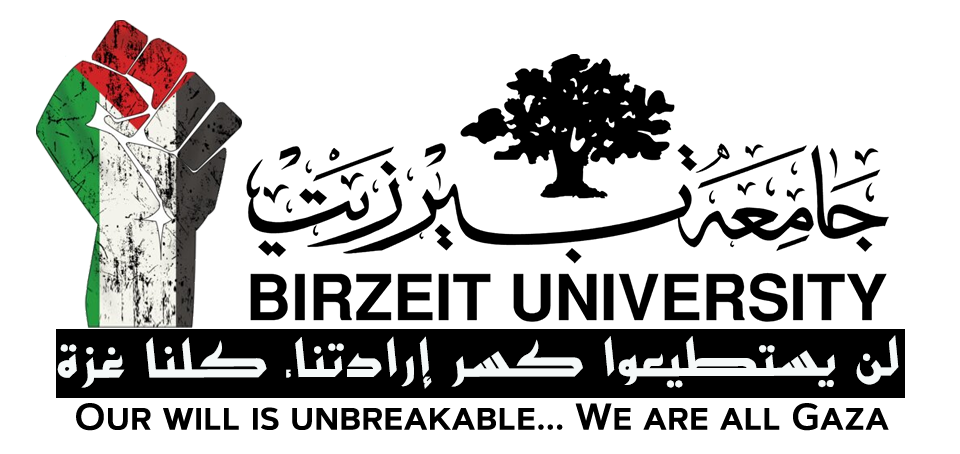أبدأ بقصة قصيرة جداً تدور بين أساتذة الجامعات ومعلمي المدارس حول أداء الطلبة:
يشكو أساتذة الجامعات الفلسطينية من ضعف قدرات الطلبة في فهم المقروء والكتابة بشكل مترابط (وأحياناً أبسط من ذلك)، حتى ضمن ذوي "المعدلات المرتفعة" في شهادة التوجيهي.
يبتسم معلمو المدارس ويعلقون: لا نفهم شكوى أساتذة الجامعة، فالطلبة الذين نرسلهم لهم هم نتاج المعلمين الذين يرسلوهم لنا.
هذه حلقة لوم متواصلة بين الجامعات (ليس فقط كليات التربية بالمناسبة) والمدارس منذ فترة ليست قصيرة (أنظروا مثلاً تعليق شريف كناعنة في مجلة التراث والمجتمع قبل أكثر من عقد)، ويبدو أنها ستستمر ما لم نحاول كسر تلك الحلقة. بالنسبة لي، أعتقد أن الجامعة (هذا يشمل جميع الجامعات المحلية) تستطيع كسر تلك الحلقة بالرغم من الضغوطات المالية الكبيرة عليها. حقيقة، وكما حاول رمزي ريحان وغيره قوله، يتطلب الأمر إعادة التفكير في أفكارنا ومعتقداتنا حول التعلم والتعليم أكثر منه وضع ميزانيات كبيرة تفوق قدراتنا، وتدفعنا الى قبول أعداد كبيرة غير مبررة من الطلبة في محاولة لمواجهة التحدي المالي. (لا أنكر هنا أن هناك أمورا أخرى تتعلق بكيفية التخطيط المالي، وإدارة الموارد، وغيره – لكن هذا ليس هدفي في هذه المقالة القصيرة.) ما أود التركيز عليه هو فهمنا للتعلم والتعليم الذي يحتاج الى تأمل وتفكير وتساؤل وإعادة بناء ذلك الفهم على أمل أن يتم التفكير به في خطة الجامعة الاستراتيجية للأعوام 22-27.
من خلال تدريسي وعملي في الجامعة، تتلخص النظرة الى (أو الخطاب السائد حول) التعليم على أنه إلقاء معلومات ينبغي على الطلبة إظهار أنهم يعرفوها عندما نسألهم عنها. أحد مظاهر تلك الفكرة، مثلاً، نسأل الطلبة "هل وصلت الفكرة؟". ويعني التعلم امتلاك الطلبة لتلك المعلومات ("وصلت الفكرة يا أستاذ"!) من خلال اظهار معرفتهم لها في الامتحانات التي لا تزال هي النمط السائد في تقييمنا للطلبة (لاحظوا للطلبة وليس لأداء الطلبة). يبدو لي أن جذور هذه النظرة تمتد الى عقود طويلة مع كل أشكال الحكم التي تناوبت علينا. كما يبدو أن التقاليد الاجتماعية والثقافية لعبت، ولا تزال، دوراً في تشكيل هذا الفهم (الخطاب) للتعليم والتعلم (والتقييم). وأعتذر أني لا أستطيع الاسهاب كثيراً هنا.
أقترح التركيز على التعلم. تعلم الطلبة وتعلم الأساتذة والمعلمين والمعلمات وغيرهم. وأدعي بأننا إن ركزنا على التعلم، من وجهة نظر مختلفة، فإننا نبدأ خطوة في الاتجاه الذي قد يؤدي الى تحسين التعليم والتقييم، ويظهر دور الجامعة المجتمعي، وقد يسهم في اقناع (أو اجبار؟) صانعي السياسات التربوية في مجتمعنا على إعادة النظر في تشريعاتهم وطرق تنفيذها.
التعلم، بالنسبة لي، هو تكوين معنى للخبرات التي نعيشها. خبرات في الجامعة (أقصد في قاعات التدريس وخارجها، وفي الكتب وفي التخصصات المختلفة، أو ما نسميه معرفة وعلوم – وهذا محور تركيزي هنا)، أو خبرات في المدارس (داخل حصص الرياضات واللغة والرياضة والفيزياء وغيرها، وخارجها)، أو خبرات خارج هذين السياقين. باختصار، ينخرط المتعلمون في عملية بحث عن المعلومات والآراء المختلفة حولها، ثم محاولة نقاشها والجدل حولها ومن ثم تقديم حجة أو رأي حولها. قارنوا للحظة الفرق بين جو تعلمي كهذا من جهة، وجو الاستماع الى "المعلومات الصحيحة" من المعلم، وحفظها، ووضعها في الامتحان أو تقرير المختبر المعروف نتيجته سلفاً من جهة أخرى. أيضاً لاحظوا دور الطالب/المتعلم هنا.
يعني التعليم، إذن، تصميم لأجواء التعلم تلك بحيث تتيح فرصة للمتعلمين تكوين معنى خاص بهم. قد يقول قائل: أليس هناك قضايا "صحيحة" ينبغي على الطلبة معرفتها؟ طبعا، هذا لا ينفي المعنى الذي نود للطلبة "الوصول" له. قد يهدف التصميم أحياناً الى تعرف الطلبة على قضايا أو معلومات معينة، لكنه يعني أيضاً التصميم المفتوح أو الاستكشافي الذي يتيح المجال لمعاني أخرى، لتفسيرات أخرى، لوجهات نظر مختلفة، وإثارة الجدل بين الطلبة أنفسهم، ومع المعلمين والأساتذة كي يتمكن الطلبة من الدفاع عن معانيهم الخاص ووجهات نظرهم المختلفة. أما المعرفة و"الحقيقة" وغيرها من تلك المفاهيم الفلسفية المختلفة، فيمكن الحديث عنها في مجال آخر. ما أود لفت الانتباه اليه هنا هو دور المعلم أو المعلمة أو أساتذة وأستاذات الجامعة. لقد استخدمت كلمة "تصميم" في تعريفي للتعليم، وهنا يكمن دور المعلم برأيي. نحن نخطط ونصمم ونفكر ونناقش الطلبة، لا إلقاء معلومات جاهزة (معلومات ميتة حقيقة، كما سماها حسين البرغوثي ومنير فاشة) ندعي أنها "الحقيقة" وعلى الطلبة تذكرها. لاحظوا كيف يتغير دور المعلم هنا ويصبح أكثر إثارة وتحدي ومتعة. وهذا ينعكس على طرق تقييمي كمعلم. وهذا موضوع يمكن تفصيله لاحقاً. لكن يمكنني الإشارة الى وجود مجموعة من الأساتذة من كلية التربية يعملون على تطوير فكرة (خطاب حول) التقييم الذي ينبني على ما "يحسنه" الطلبة في تعلمهم.
قد يؤدي هذا الفهم للتعلم والتعليم الى البدء في كسر حلقة اللوم في القصة أعلاه، والبدء في خلق علاقة بديلة من العمل المشترك بين الجامعة والمدارس بشكل خاص، والجامعة والمجتمع بشكل عام. هي محاولة أولية لوضع بذور نحو توسيع أو تغيير فهمنا (خطابنا) للتعلم والتعليم على أمل التأثير في تعلم المتعلمين الجدد وإتاحة المجال وخلق الفرص للتعبير عن أفكارهم بمسؤولية المتشككين، والباحثين المتسائلين عن معاني المعرفة، الذين يحاولون بناء هوياتهم الخاصة في هذا العالم والتعبير عنها بكلماتهم وأفكارهم.
لا أدعي مطلقاً أن الأمر سهل، ومحاولاتي في خلق أجواء تعلم وتعليم كما أصفها هنا غالباً ما تواجه تحديات كثيرة. مثلاً، يقاوم الطلبة أنفسهم هذا الدور، ويرغبون بالدور التقليدي لنا كمعلمين. ويحدث تقريباً كل فصل أن يحتج بعض الطلبة على طريقة تعليمي وينتظرون مني "القول الفصل". كما أن بعضنا كأساتذة ومعلمين يقاوم هذا الدور ويعتقدون أن هذا قد يعني قبول كل ما يقوله الطلبة على أنه "صحيح" لأنه "معنى خاص"، وهذا يبتعد كثيراً عما أدعيه في تعريفي للتعلم والتعليم وخلق أجواء تعلمية. أخيراً، التعلم والتعليم بالنسبة لي حرية، ويمكننا أن نخلق تلك المعاني وتلك الحرية بشكل مستمر ومتجدد. ولنا في قول محمود درويش ما يشجعنا: "الهوية هي: ما نُورث لا ما نَرِث. ما نخترع لا ما نتذكر. الهوية هي فسادُ المرآة التي يجب أن نكسرها كلّما أعجبتنا الصورة!"