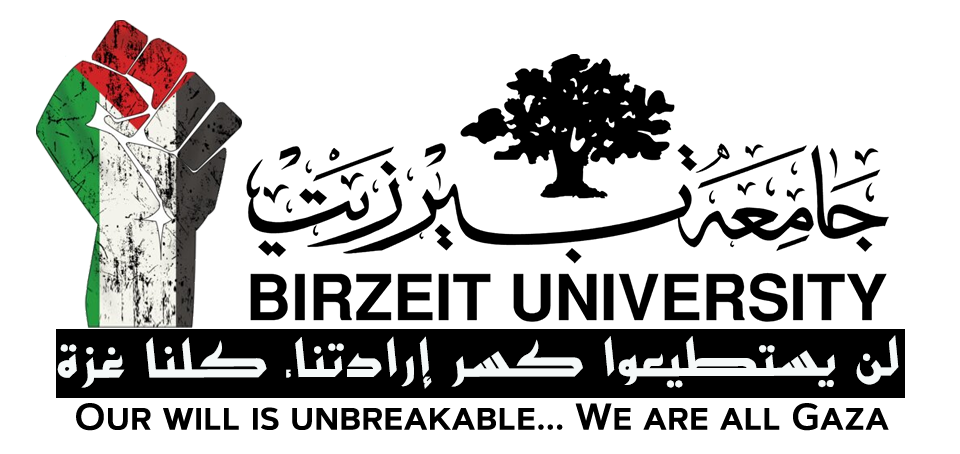يبدو غريباً للوهلة الأولى أن لدى الفلسطينيين ثقة بإمكانية مواجهة صفقة القرن أقوى بكثير من ثقتهم بإنهاء الانقسام! ولكن، إذا تفحصنا الأمر، سنجد أن ليس في الأمر غرابة: فالتقاء المصالح المتضررة من صفقة القرن أكثر اتساعاً من تلك المتضررة من الانقسام. ولكن السؤال الأهم، هو عن التقاء المصالح إزاء التخلص من الاستعمار. فهنا تكمن قضيتنا الاستراتيجية.
ولأننا ما نزال، منذ أكثر من قرن، غير قادرين على تحقيق هدفنا الأسمى - الحرية، رغم الانتصارات هنا وهناك التي حققها شعبنا بتضحياته، والتي لا يستهان بها، لكن هناك آفة ما تحجب عنا القدرة على تجيير الانتصارات المتفرقة نحو تحقيق هدفنا الأسمى. ربما تُهنا في غياهب التفاصيل، والأنانيات، وانطلت علينا بعض القشور، وتبنينا عدداً من الأوهام، أدت مجتمعة إلى انزياح بوصلتنا عن وجهتنا. ولذا، فلن أقترح إي جديد، ولكني أدعو إلى العمل على التخلص من الأوهام السياسية. وللتوضيح سأورد بضع أمثلة عليها:
الوهم الأول: إن بإمكان الشعب الفلسطيني الأعزل التخلص من القهر الاستعماري المتحالف مع أعتى قوة إمبريالية، دون الانضمام إلى الجبهة العالمية المناهضة للإمبريالية؛
الوهم الثاني: إن بالإمكان ’الانضمام‘ إلى الجبهة الإمبريالية العالمية والتحول إلى مستفيد من قوتها (وهو ما اقترح علينا في مشروع سنغافورة الشرق الأوسط)؛
الوهم الثالث: إن الفلسطينيين متوحدون بحكم فلسطينيتهم، وإن بالإمكان الاعتماد على هذه الوحدة؛
ولكن السؤال الأهم، هو عن التقاء المصالح إزاء التخلص من الاستعمار. فهنا تكمن قضيتنا الاستراتيجية.
الوهم الرابع: إن حل المسألة الفلسطينية يكمن في إقناع الإدارة الأمريكية، وأي من حلفائها بأننا على صواب، و/أو إقناع الحكومة الإسرائيلية بأننا مسالمون، ولا نشكل خطراً على وجودها؛
الوهم الخامس: إن هناك رابطاً عضوياً سحرياً بين اليهودية والصهيونية، وإن ادعاء الصهيونية بأنها تمثل يهود العالم يعكس حقيقة؛
الوهم السادس: إن الإدارة الأمريكية قادرة على إبداع خطط سياسية غير إفراغ المشاريع الوطنية من محتواها التحرري، كذلك الإفراغ الذي عرفناه في اتفاقية كامب ديفيد الموقعة سنة 1979، والذي جرت إعادة تدويره في أوسلو، وفي كامب ديفيد سنة 2000، وفي صفقة ترامب؛
الوهم السابع: إن المسألة الفلسطينية أكثر أهمية وأثر من مسألة الاحتباس الحراري؛
وبالإضافة إلى هذه الأوهام وما يشبهها، والتي تتملك بعضاً منا على الأقل، هناك قضايا ندركها، ولكننا نتناساها في خضم الصراع اليومي مع الاستعمار. قضايا كأنها اندحرت إلى مراكز خلفية في تقييمنا السياسي. أورد عليها مثالين:
أولا: إن المسألة الفلسطينية تشكل مواجهة مع الإمبريالية العالمية وليس مع المستوطنين، أو حكومة اليمين المتطرف، أو مع جنرالات الجيش الإسرائيلي وحسب. ولذلك فإن مواجهة الاستعمار في فلسطين هي مواجهة عالمية وتحتاج إلى تضافر أممي، ولا تكفيها التوازنات المحلية والإقليمية؛
ثانيا: إن القانون الدولي يشكل مستنداً للعمل التحرري الفلسطيني. غير أنه يأتي رزمة كاملة تشمل قيوداً على الطموحات التحررية للشعوب المقهورة، وهو بالتالي يشكل أداة خطرة.
ولا يكفي استخدام هذه الأداة بمهارة وحذق لدرء خطرها، فهي أداة مشاع، يستخدمها الأعداء والأصدقاء، وتخضع لعلاقات القوة، وليست منشئة للقوة؛
ولأن ما أسلفت ليس بجديد، عليّ أن أوضح دوافع العودة إليه. نعم، لم تتغير حقيقة الاستعمار، أو الصهيونية، أو الإمبريالية، ولم يتغير جوهرهم، ولا جوهر مشروعنا التحرري – الحرية. بيد أن هناك مستجدات، تتطلب منا إعادة ترتيب أوراقنا، وإعادة النظر في خططنا، وخطانا، ناهيك عن الحاجة الجلية إلى عدم الاستمرار في مسار لم يُؤت بين أُكُلِه حريتنا. ويمكننا فحص أثر المستجدات على مختلف المستويات:
الجديد عالمياً هو أن الاستعمار الجديد بات مضطراً إلى استخدام كل مخزونه الاستعماري، بما في ذلك العودة إلى أدوات الاستعمار المباشر والتدخل العسكري، وأن أزمة النظام العالمي باتت من الخطورة بمكان، بحيث بات ملموساً تهديدها للسلم العالمي. ويعني ذلك أن الحلفاء الموضوعيين لكل مشروع تحرري باتوا أكثر من ذي قبل، وأن التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني بات مصلحةً لكثيرين، ولا يقتصر على التعاطف مع قضيتنا العادلة. بيد أن إدراك هؤلاء الحلفاء الموضوعيين لهذه المصلحة منوط ببروز المكون التحرري في مشروعنا، وعلى وجه التحديد بروز المكوِّن التحرري الأممي، وليس فقط الفلسطيني الخاص، وإنما أيضأ ذلك الذي تشاركنا فيه بقية الشعوب. بكلمات أخرى، لم تعد صيغة التنافس والتفاوض مع قوى الاستعمار تجدي نفعا، بل بات لزاماً الانخراط في جبهة واسعة ضد قوى الاستعمار. وأشير في هذا السياق، إلى أن الانقسامات المتفاقمة في المعسكر الإمبريالي هي سمات ضعف وتعبير عن أزمة، وأن العنجهية والغطرسة الأمريكية والإسرائيلية هي محاولة للتغطية على هذا الضعف وهذه الأزمة. ولذا فإن بإمكاننا إعادة صوغ مشروعنا التحرري آخذين هذا الضعف بعين الاعتبار؛
كما أن هناك جديد عالمي موجه نحو إقليمنا، ويتلخص في تدمير وإضعاف، وإشغال دول الإقليم قاطبة بقضايا تهدد كيانية هذه الدول. وبدلاً من أن يؤدي ذلك إلى انشغال شعوب هذه الدول بقضاياها الداخلية، وهو ما لاحظناه في الأعوام الماضية، يجدر أن نعمل على إنشاء حلف أقوى مع هذه الشعوب التي يتهدد كيانيتها ما نعانيه؛
أما الجديد إقليميا، فهو سعي إدارة ترامب إلى إضفاء شرعية واعتراف بدور إسرائيل كشرطي إقليمي، وهو دور بات ضرورياً لتنسيق عمل عدد من القوى الشرطية الجديدة التي تمكنت الإمبريالية من تأسيسها في خضم الترويج للإفك الطائفي والإثني في المنطقة؛
ولا تفوتنا المستجدات الإقليمية بشأن فلسطين، حيث تستعر محاولة إنشاء "روابط قرى" إقليمية هدفها إلغاء تركّز الصراع إقليمياً في المسألة الفلسطينية، في مسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بدل حلها، وضمان شطبها من أجندة الشعوب العربية (أو على الأقل نقلها إلى مرتبة متأخرة في جدول أعمال الشعوب العربية)؛
أما الجديد محليا، غير استشراء التشتت والتشرذم والانقسام، هو أن الفكرة القائلة بحتمية الانتصار باتت محل شكوك، وأننا لم نعد نرى النصر قاب قوسين أو أدنى. فكيف تكون الثقة في الانتصار عندما لا نرى دور العدالة الاجتماعية في تعزيز الصمود، وعندما يبعد الانقسام الأرعن الأمل، وعندما تتلاشى مقومات وأرضية الوحدة الوطنية حتى باتت الوحدة شعاراً بلا رصيد؟
علينا، بالتالي، وضع خطة تحررية على أسس المعطيات الجديدة، وتنظيم أنفسنا بشكل يتيح النضال في سبيل تحقيقها. وتتطلب هذه الخطة مقاربات لكل جوانب المشروع التحرري، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية. أما هنا فأعرض مقدمة للمقاربة الدولية، التي أجدها مركزية لإخراج المشروع التحرري إلى السياق الذي وصفته أعلاه، والذي أراه شرطاً للولوج إلى نطاق الفاعلية، عن طريق ربطه بقضايا أخرى تشغل البشر اليوم.
يكمن مقترحي في البحث عن طريقة جديدة ومعنى مستحدث لتدويل القضية يتلخص في إدراجها ضمن مجموع القضايا التي تؤرق البشرية، وعدم الاكتفاء بأرق الحكومات، والذي يتلخص، إجمالا، في القضايا التي تؤرق من نصبوا أنفسهم ناطقين باسم إرادة المجتمع الدولي. وبكلمات أخرى، علينا تبني واقعية سياسية جديدة، تنطلق من واقع العالم وتناقضاته، وليس من الواقع المزور الذي تعرضه المؤسسة الإعلامية التي تحتكرها القوى الكبرى، ثم تروج له نخب محلية تدفعنا، تحت شعار الواقعية السياسية، إلى التضحية في سبيل مشاريع تُسَمِّن هذه النخب ليس على حساب استرداد الموارد من المستعمِر، بل عن طريق إعادة اقتسام مواردنا الشحيحة أصلاً دون اعتبار للعدالة.
واستباقا، أرجو أن أجيب الذين باتوا يعتقدون أن وصول الفلسطينيين إلى حالة الحرية وممارسة تقرير المصير هو مشروع طوباوي يجافي توازنات القوى الراهنة، باستعارة من الفيلسوف جيجك الذي قال إن "الطوباوية القصوى هي تخيل أن بالإمكان استمرار الوضع الراهن"!
بتنا في حاجة إلى تغيير ثوري، لا تجميل، ولم يعد الإصلاح يكفينا.
وبالتأكيد لن يحل مشاكلنا العتاب. ولن نستفيد من النقاش حول شطب أوسلو من عدمه. ما نحتاجه هو التفكير فيما سنَخُطُه لمستقبلنا، وكيف نحدد الحلفاء والأعداء فيما يتعلق بهذه الخطط؟ وكيف نعيد وضع أنفسنا على أجندة التحرر العالمية ونخرج من احتباسنا السياسي؟
سأكتفي بجزء صغير من الإجابة على هذين السؤالين: علينا أن نتوقف عن استهلاك المساعدات والتعاطف والتضامن. علينا أن نعود إلى إنتاج الفعل التحرري، وأن نرفد به حلفاءنا، وأن نتجه إلى الشراكة في مشروع تحرري عالمي، مشروع يشكل نقيضاً للمشروع النيوليبرالي، مشروع نجد فيه أنفسنا منتجين للفعل، ولدينا ما نقدمه إلى حلفائنا وأصدقائنا.
كانت هذه مداخلة د. مضر قسيس في بداية المؤتمر السنوي لمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين، تحت عنوان "دمقرطة السياسة الفلسطينية كأساس لإعادة بناء المشروع الوطني".