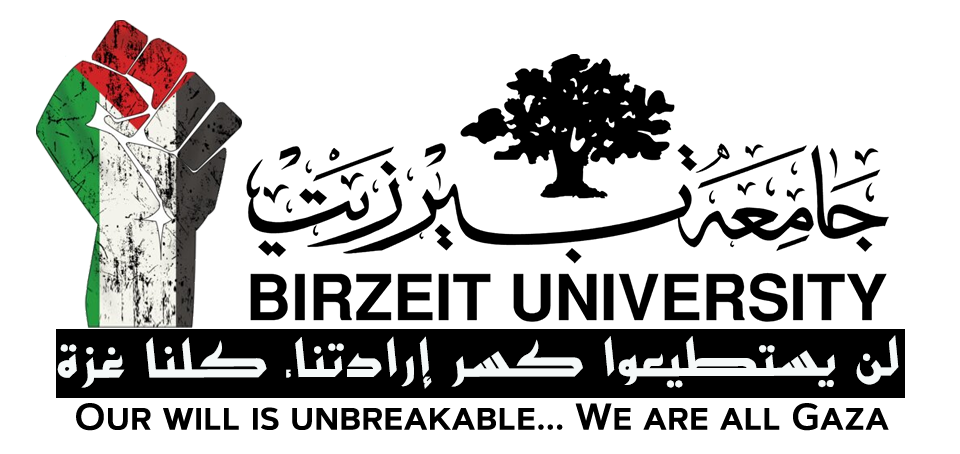توجد أربعة أخطاء رئيسية على الأقل في النقاش الذي يدور بين الحين والآخر حول حاجة السوق الفلسطينية من خريجي الجامعات وتخصصاتهم.
ويبرز هذا النقاش عادة كلما ظهرت أرقام جديدة حول نسبة البطالة بين هؤلاء الخريجين، ويجري إلى حد كبير تحميل الجامعات المسؤولية الأكبر، لمناهجها وتخصصاتها التي يُفترض أنها لا تأخذ بعين الاعتبار بالشكل المطلوب حاجات السوق. بالمقابل، لا يجري الحديث أو التعرض للنواقص الفعلية والأهم في مناهج معظم الجامعات غير التخصصات وارتباطها مع حاجات السوق، أو لا يوجد إدراك كاف لهذه الحاجات.
الخطأ الأول: الافتراض الضمني أو الصريح أن السبب الرئيسي للبطالة بين خريجي الجامعات هو عدم مواءمة مناهج الجامعات الفلسطينية لحاجات سوق العمل. هذا، بينما الواقع المعروف للجميع أن التنمية المطلوبة لخلق فرص عمل جديدة وكافية غير ممكنة بوجود القيود المتنوعة بفعل الاحتلال، مضاف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي الذي يجعل الاستثمار الذي يخلق فرص عمل جديدة مغامرة كبيرة خاصة الآن، مع تعثر حل الدولتين بالفهم الفلسطيني له، أو حتى أفوله كما يرى البعض. وقد "تعب" البنك الدولي خلال السنوات العشر الماضية، في تقرير بعد تقرير، من الإشارة للعوائق المختلفة بفعل الاحتلال التي تمنع أو تعيق التنمية المطلوبة ومعها فرص العمل الجديدة. والحل إذاً سياسي أساساً وليس تعليمياً. وهذا هو السؤال الغائب الآن حول المستقبل، والذي يندرج تحته السؤال الاقتصادي ومن ثم التعليمي.
وحتى لا يقال إن هذا من باب تعليق الأمر على شماعة الاحتلال، قد يوجد عدد من الخطوات التي قد تخفف من هذه البطالة، على سبيل المثال لا الحصر، التوسع في التعليم المهني قيد النظر فيه الآن من قبل الوزارة. ولكن هذا وحده لن يحل المشكلة حتى لو سلّمنا أنه توجد حاجة فعليه له وليس فقط لغرض التخفيف من البطالة، وإنما أيضا لرفع مستوى هذه المهن في عصر فيه تطور سريع لاستخدام التكنولوجيا في عملية الإنتاج.
الخطأ الثاني: الافتراض أن سوق العمل هو الضفة الغربية وقطاع غزة.
والواقع هو أن سوق العمل لم يُعَرَف طيلة سبعين عاماً، منذ بداية عمل الفلسطينيين في الكويت، في التعليم أولاً، على أنه محصور في الضفة والقطاع. وهذا الأمر غير خاص بفلسطين بدليل مئات الآلاف وأحيانا الملايين من مواطني الدول العربية كما في حالة مصر، الذين يعملون خارج بلادهم.
الخطأ الثالث: أن ازدياد أعداد الطلبة في الجامعات الفلسطينية خلال العقد الماضي على وجه الخصوص، جزئياً بسبب الضغط المجتمعي لقبول أعداد أكبر، ومن ثم الخريجين، هو نوع من البطالة المقنعة بسبب تضاؤل فرص العمل. فالكثيرين يرون أن قضاء فترة "محكومية" في الجامعات، لمدة أربعة أو خمسة أعوام، أفضل من مواجهة البطالة في السوق مبكراً، على أمل أن التأهيل الإضافي قد يسعف أيضاً. بالمقابل، وعلى سبيل المقارنة، كانت تقريبا نصف القوة العاملة الفلسطينية تعمل في إسرائيل خلال الانتفاضة الأولى وحتى العام 1990 تقريباً، ولم يكن التعليم الجامعي أولوية للعديدين من خريجي المرحلة الثانوية لأسباب معروفة. وقد أغلق هذا الباب تدريجياً بعد هذا العام إلى ما هو عليه الآن.
الخطأ الرابع: وهذا أهم الأخطاء. وهو يبدأ بالحديث العام والفضفاض عن حاجة سوق العمل دون تحديد ماهية هذه الحاجة وبناء على دراسة مفصلة، واعتمادا فقط على وجود بطالة كبيرة بين الخريجين. ويضاف إلى هذا الافتراض أن السوق في حاجة لتخصصات غير موجودة في الجامعات الفلسطينية، دون دليل يعتد به. لكن ما هو مهم هنا أمران: الأول، أن السوق ينتقي من بين فائض الخريجين بناء على عدة معايير، تشكل التخصصات أحدَها فقط، وأحياناً ليس أهمها. وفي الواقع هذا وضع "جيد" من منظور السوق، أي أن فائض الخريجين يتيح له المفاضلة بين خريج وآخر، بناء على عدة معايير، وليس فقط التخصص، واستبدال من وظف خلال فترة التجربة وانتقاء آخرين مكانهم.
لكن ما هو أهم هو الأمر الثاني الذي فيه قصور واضح في معظم الجامعات الفلسطينية والمتعلق بالمعايير الأخرى للتوظيف، خاصة التثبيت في العمل بعد فترة التجربة، غير التخصص. هذه المعايير تكون في معظم الأحيان هي الأساسية خاصة في الشركات والبنوك والمنشآت الكبرى، وتشكل أسساً معتمدة للتقدم والترقي في العمل. وهي نوعان: مهارات محددة مثل حيازة مستوى متقدم من المهارات التحليلية والنقدية، والمقدرة على الكتابة بدقة ووضوح وتسلسل منطقي، والمسماة خطأً مهارات كتابية، إذ إنها مهارات فكرية أساساً وتنعكس على ورق، أو هذه الأيام على شاشة. وليس المقصود هنا الإملاء والقواعد على أهميتها، وإنما المنطق الداخلي للنص والمقدرة على بناء الحجة والاستنتاج. هذا إضافة إلى إتقان اللغة الإنكليزية كونها اللغة المعولمة في عالم اليوم.
أما النوع الثاني من المعايير، خاصة كونها ضرورية للترقي والتقدم في المنصب من منظور الخريج، وضرورية للكوادر العليا في الإدارة من منظور الطرف الموظِف والمشغِل، فهي مهارات أو صفات شخصية، مثل المقدرة على العمل الجماعي، والمقدرة على حل المشاكل بتنوعها، والمقدرة على التنظيم وتحديد الأدوار، والمقدرة على الإقناع، وهي من أهم صفات القيادة في المؤسسات، والمقدرة على التفكير خارج الصندوق كما يقال، من بين صفات أخرى.
إن القصور الأساسي الموجود إلى حد كبير في الجامعات الفلسطينية والذي يتم إغفاله في الحديث الفضفاض عن حاجة السوق هو هذا النوع من المهارات الحيوية لكل المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني في عالم اليوم.
وصحيح أن بعضاً منها صفات شخصية تتشكل بفعل التنشئة الاجتماعية للفرد وظروف هذه التنشئة وعوامل طبقية أيضاً. وقد توجد حدود لمقدرة الجامعات وحدها في التأثير عليها، وتقع المسؤولية الأساسية هنا على مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وعلى التنشئة الاجتماعية من قبل الأهل، إضافة للجامعات.
لكن هذا لا ينطبق على المهارات الفكرية والتحليلية والنقدية والتي إما يجري إهمالها من قبل الجامعات أو لا تعطى الوزن الكافي في العملية التعليمية. ويحصل هذا أحيانا بسبب الاهتمام المفرط في التعليم التخصصي في موضوع محدد على حساب التعليم العام متعدد الأغراض المستقل عن التخصصات، والذي يشكل جزءاً أساسياً من المنهاج في الجامعات الرائدة في العالم. هذا إضافة للنظرة المهنية الضيقة لدى العديد من المدرسين في الجامعات وبعض الإداريين أيضا حول ما يجب أن يتعلمه طلبة الجامعات والتي لا تخدم المستقبل المهني للخريجين. هذا عدا عن الإجحاف الحاصل بفعل هذه النظرة الضيقة والقاصرة بحق الخريج كمواطن وإنسان ودوره المستقبلي في المجتمع، عدا عن كونه متخصصاً في موضوع ضيق. هنا يكمن القصور الذي لا يجري الالتفات إليه في غمرة الإطناب في الحديث عن حاجة سوق العمل.
نشر في جريدة الأيام بتاريخ 25 تموز 2019.