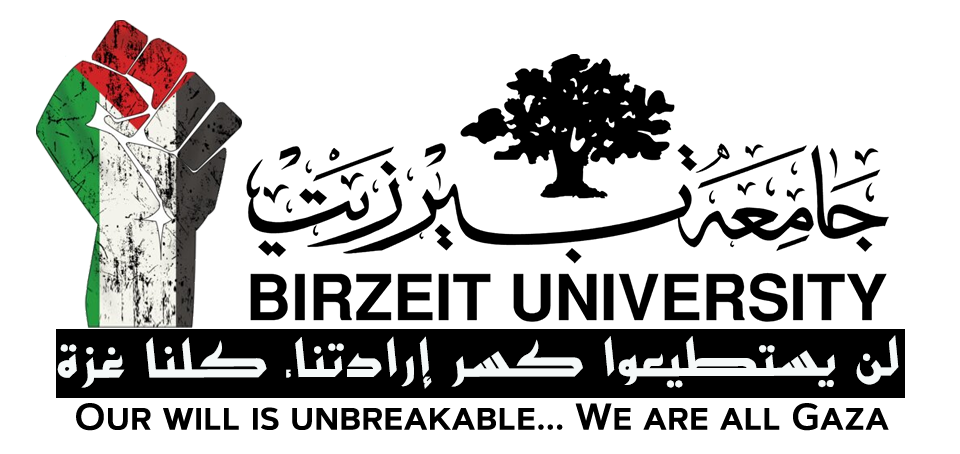أنا من الجيل المتبقّي الذي عاش في فلسطين، واستمتع بالعيش فيها، قبل نكبة العام 1948. وُلدتُ في يافا أواخرَ العام 1933، وعشتُ في مدنٍ فلسطينيّةٍ عديدة: الرملة وصفد والناصرة ونابلس والقدس. وللأوقات التي كنتُ أقضيها في السباحة في بحر يافا وبحيْرةِ طبريا ذكرياتٌ عزيزةٌ على قلبي.
لطالما حلمتُ بأن نعودَ إلى تلك المناطق التي سُلبتْ منّا. ولكنّي لم أتخيَّل أن يأتيَ ذلك في ظلّ نكبة ثانية سُمّيت "نكسة 67." لقد عدنا فعلًا إلى أرضنا، لكنّها لم تكن عودةً حقيقيّةً، بل زيارة ضمن مرحلةٍ متقدّمةٍ من النكبة التي تستمرّ آثارُها إلى اليوم.
أذكر أنّ شعورًا بالاكتئاب اعتراني حين زُرنا البحرَ الذي حُرمنا إيّاه 19 عامًا. المشهد الذي بدا غريبًا، واللغة التي لم تعد مألوفة، دفعاني إلى البكاء بلا توقّف. كان هذا الألم هو نفسه الذي شعرتُ به أثناء زيارتي بيتَنا في القدس، وبيتَ جدي في يافا؛ فقد بدونا ــــ نحن أصحابَ المنزل ــــ غرباءَ عن منزلنا الذي يسكنه غرباءُ آخرون.
عندما حلّت النكبة كنّا نسكن في البقعة الفوقا في القدس. وكان التوتّر قد بدأ بسبب العمليّات الإرهابيّة التي كانت تشنّها الجماعاتُ اليهوديّة في مواجهة الانتداب البريطانيّ والفلسطينيين. ومن أوائل تلك العمليّات تفجيرُ جناح سكرتارية الانتداب البريطانيّ في فندق الملك داود، في 22 تمّوز 1946، على يد جماعة الإرغون، بزعامة مناحيم بيغن. وعلى الرغم من أنّ الضربة كانت موجّهةً إلى الحكومة البريطانيّة فإنّها قتلت ثمانين شخصًا، نصفُهم عرب.
كنتُ ما أزال في القسم الداخليّ في كلّيّة بيرزيت، ولم أدرك أنّ عطلة عيد الميلاد سنةَ 1947 ستكون آخرَ عطلةٍ نقضيها في القدس، وأنّ العطلة التي كنّا ننتظرها لنشعر بالراحة بعد فصل دراسيّ منهِك ستُكلَّل بمقتل 11 شخصًا من عائلتيْ لورنزو وأبو صوّان على يد جماعة الهاغاناه الإرهابيّة بتفجير فندق السميراميس في حيّ القطمون في القدس.

صورة من تهجير الفلسطينيين (النكبة) عام 1948
في العام التالي، بدأت الاضطراباتُ تسود معظمَ المناطق الفلسطينيّة، ما دفع إدارةَ ّالكليّة إلى إنهاء السنة الدراسيّة قبل أوانها. في تلك الأثناء اتخذ القائد عبد القادر الحسيني من بلدة بيرزيت مقرًّا لقيادة جيش "الجهاد المقدّس،" فهبّت البلدةُ بأكملها لتساهم في هذا المجهود الخاصّ، والتحق شبابُ البلدة بالجيش على الرغم من إمكانيّاته المحدودة. ورحنا، نحن الطالبات، نحيك "الجيرزات."
كان من المقرَّر أن يكون حفلُ توزيع الشهادات في أواخر نيسان 1948 تحت رعاية القائد عبد القادر الحسيني. إلّا أنّه استُشهد في معركة القسطل قبل موعد التخرّج بأيّام، فقام السيّد إميل غوري بتوزيع الشهادات في 30 نيسان، وعمّ الحزنُ أرجاءَ البلدة.
في اليوم التالي وقعتْ مجزرةُ دير ياسين، التي راح ضحيّتَها أكثرُ من مائة شخص على يد المجموعتين الإرهابيّتين اليهوديتين شتيرن وإرغون، ومعظمُ الضحايا من النساء والأطفال. كانت هذه المجزرة عاملًا رئيسًا في إرهاب أهل القدس وحثّهم على مغادرة منازلهم، وصارت نقطةَ تحوّلٍ جذريّةً لبسط الهيمنة الإسرائيليّة على الأرض والناس.
بعد المجزرة، صارت المجموعات الصهيونيّة تتجوّل في حافلةٍ مكشوفة في المناطق العربيّة في القدس حاملةً بعضَ الناجين، وداعيةً عبر مكبّرات الصوت الأهالي إلى مغادرة بيوتهم حالًا وإلّا فسيكون مصيرُهم كمصير ضحايا مجزرة دير ياسين. ونتيجةً لهذا التهديد، دبّ الرعبُ بين الأهالي وأجبِر معظمُهم على الخروج من منازلهم في القدس.
هكذا استَقبلتْ عائلتي في بيرزيت في أواخر شهر نيسان أربعَ عائلات من أقاربنا، مكثوا عندنا عدة أشهر، حتى أدركوا أنّ الهجرة من بيوتهم لم تعد موقّتةً أو "شطحة،" وإنّما شبهَ دائمة.
سقطتْ يافا في 30 نيسان، وغادر أقاربُنا المدينةَ على متن قوارب متوجّهين إلى بيروت أو الإسكندريّة. ومن ثمّ بدأتْ معاناةُ الشعب الفلسطينيّ بعيدًا عن وطنه.
استقبالُ أهل الرملة واللد
من مآسي صيف العام 1948 هجرةُ أهل الرملة واللد في 13 تمّوز.
كنتُ يومها جالسةً على الشرفة، منغمسةً في قراءة أحد الكتب. وإذ بعينيّ تلتقطان مشهدَ مجموعاتٍ كبيرةٍ من الناس تتّجه عبر طريق يافا إلى بيرزيت. تركتُ الكتابَ جانبًا، وهرعتُ وأهلي لاستقبالهم. روى لنا أحدُهم أنّ القوّات الصهيونيّة أجبرتْهم تحت تهديد السلاح على الخروج من بيوتهم بعد أن سلبتْهم أموالَهم وانتزعتْ مصاغَ نسائهم.
كانت وجوهُ العائلات متعبةً في ذلك اليوم الحارّ من أيّام الصيف. وبدا المشهدُ أكثر إيلامًا حين رأيتُ سيّدةً مصابةً بضربة شمسٍ تكاد تهذي من كثرة التعب. كانت قصصُ المارّين التي "تشيِّب الرأس" تتردّد أمام مسامعنا: كقصّة أمٍّ خطف الصهاينةُ ابنَها، أو أخرى حملت المخدّة بدلًا من أن تحمل ابنَها، أو ثالثةٍ مُنعتْ من العودة إلى البيت حيث تنتظرها ابنتُها الصغيرة بعد أن خرجتْ لإحضار بعض الحاجيّات.
أمرتْنا العمّة نبيهة ناصر، مديرةُ المدرسة، بمساعدة طاقم المطبخ. أحضرنا ما توفّر لدينا في المخزن من أكلٍ ومياهٍ من أجل إيواء أبناء شعبنا المهجَّرين من منازلهم. كما فَتحت الكنائسُ والجوامعُ أبوابَها نتيجةً لتوافد أعداد كبيرة من الناس إلى بيرزيت، بل اضطررنا إلى استخدام بناءٍ شاغرٍ في الكليّة. ومع ذلك فقد وجد البعضُ في فيْء شجر الزيتون ملجأً مقبولًا لعائلاتهم إلى حين توفير الصليب الأحمر بعضَ الخيم لاحقًا.
كنت أرافق ممرّضةً سويسريّةً في جولاتها على العائلات من أجل استطلاع حاجاتهم ووضعهم الصحّيّ، وذلك قبل أن تستلم وكالةُ الغوث مهامَّها في كانون الأول من العام 1949 بعد أن أقرّتها هيئةُ الأمم المتحدة منظّمةً موقّتةً لتخفيف معاناة اللاجئين. وقد بدأت الوكالة بتوزيع المواد الغذائيّة، وقامت مؤسّساتٌ اجتماعيّة ودينيّة بتوفير البطانيات وبعض الملابس للأطفال.
وهنا أذكر كلماتِ الشاعر الشهيد كمال ناصر حين كتب في قصيدته "يا أخي اللاجئ" يقول: "قدَّموا السمَّ إلينا في الطعام/ فغدوْنا كالقطيعِ الأخرس."
لقد كان أجدرَ بوكالة الغوث أن تُصرّ على تنفيذ قرارات هيئة الأمم، فتؤمّنَ لهؤلاء اللاجئين العودةَ إلى بيوتهم بكرامة وأمان!
حرب حزيران 1967
عندما بدأت حربُ حزيران 1967 اتّصل بي والدي ليحثّني على الذهاب إلى بيرزيت، اعتقادًا منه أنّ الوضع سيكون هناك أكثرَ أمانًا من منزلنا في بيت حنينا الذي يقع بالقرب من معسكر الجيش الأردنيّ. هنا عادت بي الذاكرة إلى نكبة 1948، وخشيتُ أن لا أتمكّن من العودة إلى بيتي.
في ذلك الحين، أصّر زوجي أن أذهب مع الأولاد، وبقي وحده في البيت، ليدركَ متأخّرًا أنّ الكتيبة في المعسكر انسحبتْ.
وبين ليلة وضحاها سقطت الضفّة الغربيّة وغزّة والجولان وسيناء، وواجهنا واقعًا جديدًا وقيودًا جديدةً.
ومرةً أخرى فشلتْ هيئةُ الأمم المتحدة في تطبيق القرار 242، الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 تشرين الثاني 1967، والذي يفرض على "إسرائيل" الانسحابَ من المناطق المحتلّة. وأثبتت "إسرائيل" أنّ في إمكانها، بمساعدة الولايات المتحدة، أن تضرب بعرض الحائط كلَّ القوانين والقرارات والمواثيق الدوليّة: فتضمّ القدسَ الشرقيّة، وتنشئ المستعمَرات، وتَحول بين سكّان الضفّة والقدس، وتعتقل الآلاف من المعتقلين (من بينهم 350 طفلًا).
النكبة مستمرّة، فهل من أمل؟
لولا الأمل لما صمدنا كلَّ هذه السنوات، ولما أنشأنا مؤسّساتٍ علميّةً وصحّيّةً وثقافيّةً واجتماعيّةً ساهمتْ في صمود شعبنا. قضيّتنا عادلة، وحقُّنا في العودة يجمع بين الحقّ الفرديّ والحقّ الجَماعيّ. ولذلك فإنّه لا يمكننا أن نترك فلسطين، القضيّةَ والحلمَ والوطن. وكما يقول المثل "لا يضيع حقٌّ وراءه مُطالب."
نشرت هذه المقالة أيضاً في مجلة الآداب الالكترونية