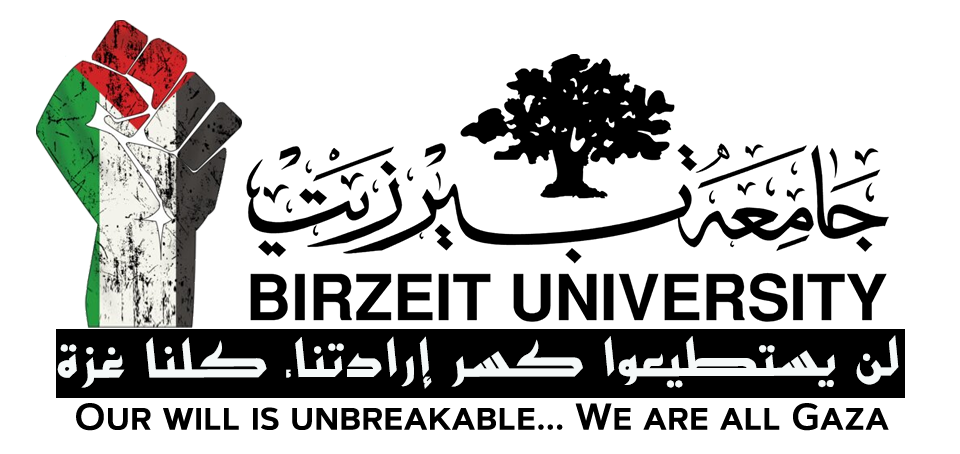كُتب العنوان أعلاه صباح أمس، ولكن مع الظهيرة عند إرسال المقال، كانت الأنباء تتحدث عن شهداء آخرين في طولكرم؛ كان هناك شهيد صباح أول من أمس، وفي المساء كان هناك شهيد آخر. ودّع الأردنيون والفلسطينيون قاضي الصلح د. رائد زعيتر. وكان الشاب ساجي من جامعة بيرزيت يسير إلى أغنامه في قرية بيتين قرب رام الله.أضاف طلبة بيرزيت، أمس، إلى الهرم الذي يحمل أسماء الشهداء من أبناء جامعتهم “جامعة الشهداء” اسماً جديداً، وحملوا الجثمان وطافوا به شوارع الجامعة، ليتخرّج منها.ربما لا يعرف غالبية الأردنيين، ولا يعرف العالم عموماً، أين قُتل زعيتر حقاً؛ فليس دقيقاً الاكتفاء بالقول إنّه قتل على نقطة الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن. الأدق وصفا، ماذا تعني هذه النقطة؟في الطريق من فلسطين إلى الأردن وبالعكس، يُفرض على المسافر الصعود والهبوط من الحافلات وسيارات الأجرة ست مرات، في مسافة لا تزيد على المسافة بين عمّان وإربد. بعض هذه المحطات لا معنى له من قريب أو بعيد، ولا فائدة أمنية أو عملية له، ما لا يُبقي إلا معنى الإهانة.على سبيل المثال، إذا خرج المسافر ممّا يسمى “الاستراحة” في أريحا؛ وهي النقطة التي يتواجد فيها أفراد من الأمن الفلسطيني يُسجّلون أسماء المغادرين، يُطلب من الركّاب بعد مسافة قصيرة للغاية النزول والمرور ببوابة تفتيش معدنية إسرائيلية، والالتحاق بحافلة أخرى مختلفة. ولا يوجد، في كثير من الأحوال، جنود إسرائيليون يراقبون. وهم يتواجدون في مكان بعيد، فقط للتأكد من أن ركاب الحافلة نزلوا ومروا بالبوابة التي تواصل الطنين مع كل شيء معدني، من دون أن يكترث الجنود لذلك، كما لا يتم تفتيش الحقائب اليدوية. هل يبقى لهذا المرور من معنى سوى الإذلال؟في الطريق المعاكس، أي من الأردن، حيث قُتل رائد زعيتر؛ فبعد أن ينهي المسافر إجراءات السفر من الأردن وقبل أن يعبر النهر، يصعد أحد أفراد الأمن الأردنيين ويجمع من الركاب بطاقات تحمل أسماء كل المسافرين في كل حافلة؛ أي أنّ أسماء جميع الشهود على جريمة قتل د. زعيتر، وعناوينهم، موجودة لدى أجهزة الأمن ويمكن سؤالهم. بعد جمع هذه البطاقات، تتحرك الحافلة قليلا، وتقف فوق الجسر على النهر، بانتظار إشارة من الجنود. هذه المحطة، كما يعرف المسافرون، تكون أحياناً تعذيباً حقيقياً، وهي دائماً إذلالٌ صريح. فأحياناً، يطول الانتظار لإشارة من أصبع الجندي ساعات، فتقف حافلات خلف بعضها في درجة حرارة تقارب الأربعين صيفاً. وتبقى نساء ورجال، ومسنون وشبان، وأطفال، وأصحاء ومرضى، ورضّع، في هذا الوضع ساعات، لا يُسمح لهم بالذهاب إلى مرافق صحية، غير موجودة أصلا. ولا يوجد ازدحام يبرر كل ما يجري؛ فلو افترضنا أنّ هناك عشر حافلات تنتظر، فإنّ عدد الركاب لا يزيد في هذه الحالة على عدد ركاب طائرة واحدة.والأنكى أنّ الخطوة التي ينتظرونها لا معنى لها؛ فبعد إعطاء الإشارة، تتقدم الحافلة قليلا، ويُطلب من المسافرين النزول منها، من دون فحص أوراقهم وتفتيشهم، فقط يصعد جندي الحافلة لثوانٍ، يلقي نظرة عليها فارغة، ولا يفتح الحقائب ولا يفتش شيئاً، ثم يطلب من المسافرين الصعود مجددا، ليذهبوا الى محطات أخرى فيها تفتيش وطوابير أخرى. في هذه النقطة تحديداً قتل القاضي عادل زعيتر. ورواية شهود عيان أن جنديا دفعه وأهانه ليصعد إلى الحافلة، ما استفزه وأثار أعصابه، وحاول الصد عن نفسه. ومن تعرض لهذه المحطة، يدرك أن مسألة خطف السلاح قصة ساذجة، وغير ممكنة.لم تؤد كل عمليات السلام والمفاوضات إلى وقف عمليات الإهانة على الحدود، ولا إلى اختصار محطات السفر العبثية.قُتل القاضي في سفره، ولم تؤد عمليات السلام إلى تحويل الحدود إلى شيء طبيعي؛ كأن يستقل رائد سيارته ويذهب بها ولا يتوقف إلا على النقطة الحدودية. ولم يشفع للطالب في قسم الإعلام في بيرزيت، ساجي، أنّه يدرس ويرعى أغنامه وخرافه.ما لا يفهمه صانعو القرار في كل مكان أنّه عندما يرتقي الشهداء، يُصبح هناك صنّاع آخرون للقرار، يأتون من الجامعات والشوارع والقرى والمخيمات.
أين استشهد الدكتور رائد.. وساجي؟
الآراء الواردة في المدونة تعبر عن رأي كتابها، وليس بالضرورة عن رأي الجامعة.