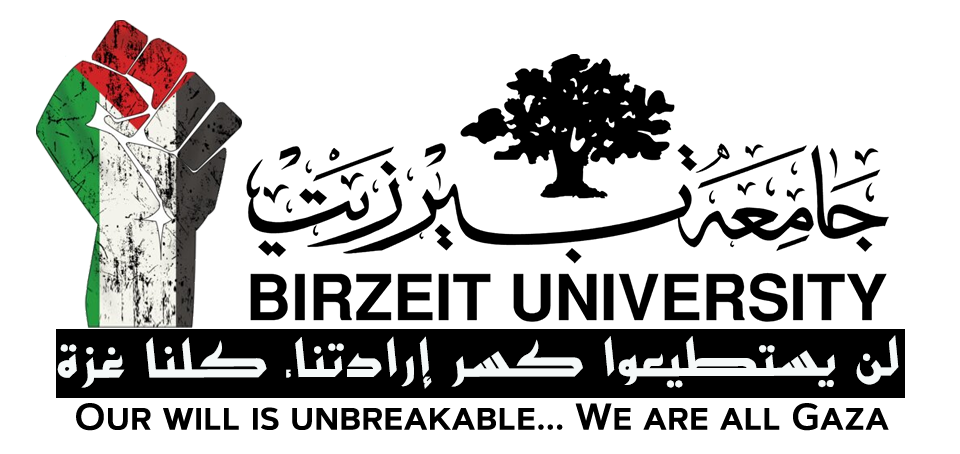نسعى في هذه المقالة إلى فهم تمثّلات الخطاب الفلسطيني الجديد حول عنف اللاعنف باعتباره بنْية خطابية متكاملة بالمعنى الفوكيانيّ، والمعيدة لإنتاج الخطابات المعيارية الجديدة، وتأثيرها على العقل الجمعي وذلك من خلال فهم تشكيلاتها ومرجعِّياتها وآليات عملها، وتشخيص الخطابات اليومية وعلاقتها بالخطابات المستبطنة، وأشكال التعبير عنها في المجتمع الفلسطيني. سنحاول، إذًا، رصد العناصر الأساسية المكوِّنة لبنْية هذا الخطاب والتعامل معها باعتبارها مخزنًا للدلالات والرموز كما يقول جاك بيرك (Berque)؛ مستعيرين كذلك ما يعبّر عنه باول ريكور (Ricœur) بقوله إنه إذا تحقق الخطاب كله بوصفه واقعة، فيجب فهم الخطاب كله بوصفه معنى.يعيش المجتمع الفلسطيني اليوم مجموعة من الاستدخالات الخطابية الرسمية وغير الرسمية لماهية العنف ودلالاته وانعكاساته. ويجري ذلك عبْر تنامي أعلى درجات الشعور بالفشل المجتمعي نتيجة لإخفاق السياسات والإستراتيجيات التي تقودها المؤسسات السياسية الرسمية من أجل إقامة المشروع الدولاتي، وعدم نجاعة وسائل مقاومة الاستعمار الإسرائيلي، وسوء السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعثُّر المشروع الوطني، وأزمة الثقة المتصاعدة بين الأفراد ومؤسسات السلطة، وتآكل قوة التأثير للفصائل السياسية، وتَعمُّق أزمة مشروع حل الدولتين، وتعاظُم الانقسام بين طرفَيْ إدارة الانقسام -حركتَيْ فتح وَ حماس- وآثاره المدمرة على حياة المواطنين وخاصة في قطاع غزة. ويظهر لنا أن ثمة سيادة للخطاب اللا عنيف في فلسطين، باعتباره الخطاب الأوحد والمقبول والصحيح، حيث تقوم تعبيرات الحقل الحجاجيّ على استحضار مستبطن للخطاب المهيمن، ويعاد استخدامه ضمن منطق علاقة إعادة الإنتاج بين المستعمِر والمستَعمَر وَفق منطق ألبير ميمّي (Memmi)، لصالح المستعمِر؛ بمعنى أن المستعمِر الإسرائيلي يفرض على المُستعمَر الفلسطيني واقعه وأدوات مقاومته أيضًا، كما هو الحال بالنسبة للجدار. وفعليًّا يقوم جيش الاستعمار بالتدريب واستخدام أسطوله الحربي وتكنولوجياته ضمن منطق البيو سياسية الذي يسميه فوكو بيوبوليتكس (biopolitique)، حيث تقوم الإدارة الاستعمارية الإسرائيلية بتجريب كل الابتكارات والأساليب للمراقبة والعقاب والقمع كل يوم جمعة (المظاهرة الأسبوعية) مما يجعل فكرة رَوْتَنة الاحتجاج -بمنطق تييلى (Tilly) - دون معنى وغير فاعلة، حيث تجرّب على أجساد الفلسطينيين كل أنواع الأسلحة، وتختبر ردود فعل المتظاهرين لتشكل لآلة الحرب الاستعمارية الإسرائيلية مختبرًا رخيصًا للتجارب؛ وتصبح -تبعًا لذلك- المقاومة الشعبية السلمية شكلاً وحيدًا مشرعنًا لا بفعل تبنّيه من قبل القوى الفلسطينية كخيار، بل بمنطق احتكاريّ للفهم الرسمي للسلطة الفلسطينية التي تفرضه كمنطق وحيد قابل لاستعطاف العالم وَفق هذا الأسلوب الوحيد وتحييد حالة الاشتباك مع المؤسسة الاستعمارية الإسرائيلية، واختزال أشكال النضال الفلسطيني في شقه القانوني الرمزي، وخاصة أنه منذ الاعتراف بهذه الدولة غير العضو، لم تحرك السلطات الرسمية الفلسطينية أي قضية ضد إسرائيل وجرائمها في المحافل الدولية القانونية. كما هو معروف، بدأت هذه الحِراكات في منتصف الانتفاضة الثانية. قوام هذه الفعاليات ناشطون من لجان المقاومة الشعبية للجدار التي تنشط مع مجموعات أخرى منذ العام 2004 للتحرك ضد إقامة جدار الفصل العنصري في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار كبلعين، ونعلين، والنبي صالح، والمعصرة. ولقد أصبحت هذه الأشكال الاحتجاجية مع الوقت رمزًا للنضال الشعبي الفلسطيني، والسلمي منها تحديدًا، والمرتكز على شبكات تضامنية عالمية واسعة.فبعد تحقيق مجموعة من النجاحات بتعديل مسار الجدار في بعض المناطق، وتدويل القضية، وجلب آلاف المتضامنين على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، عملت هذه الناشطيّة مع الوقت على ابتكار وسائل جديدة أدائية في نضالهم ضد الجدار (أساليب متغيرة؛ استحضار شخصيّات عالمية؛ أعمال احتجاجية ذات طابع مسرحي؛ مهرجانات؛ حفلات؛ عروض مسرحية وفنية راقصة؛ تقمّص شخوص؛ أفلام مثل أفاتار (Avatar)... إلخ)، وأصبحت تدريجيًّا مكانًا لحجيج الناشطين والمتضامنين الدوليين، بل وللسفراء والقناصل الأجنبية العاملة في فلسطين، ومزارًا لآلاف الزائرين الأجانب. وعلى خلفية ذلك، قررت نواة هذه المجموعات القيام بابتكار أشكال جديدة، وهي إنشاء قرى جديدة على أراضٍ مهددة بالمصادرة، وبخاصة في المناطق المسماة ج. هذه القرى الرمزية الجديدة التي قام بها ناشطون شبّان وشابّات بالتخييم في إقامة قرى رمزية بدلالات رمزية، مثل تسمية إحداها بـِ باب الشمس -رواية إلياس خوري، وهى كذلك حبكة فيلم للمخرج المصري يسري نصر الله-. استُحضِرت في القرى التي جرى إنشاؤها لاحقًا أسماء شخصيّات الرواية، مثل ما كان في إنشاء قرية أحفاد يونس، وقرية الكرامة، ثم رسميًّا قامت المؤسسات الرسمية الفلسطينية باحتواء هذه الحراكات ومَأْسَستها، إمّا عبْر إنشاء بلديات مرتبطة بها، أو من خلال تعيين قائمين عليها، أو بجعلها مكانًا للاستعراضات الاجتماعية لكسب المشروعيات المفقودة؛ حيث قام سلام فياض باستحداث مجلس بلدي لإدارة باب الشمس والقرى الأخرى مثل أحفاد يونس، ما جعل سقف هذا الحراك محدودًا، بل لقد دفع كذلك مجموعات شبابية لتركه وغياب الحاضنة الشعبية له.1من شعب تحت الاحتلال إلى دولة تحت الاحتلال:وتتكشف لنا حالة التشوه المستعمَريّ الذي يعيشه الفلسطينيون عبر فرض هذا الخطاب الجديد على المجتمع المُدار. والمقصود أن التشوّه في الواقع الاستعماري المَعيش يستحضر مجموعة من الخطابات التي تعمل من خلال وسائل الإقناع المختلفة التأثير على تمثُّلات الناس وتخيّلاتهم الجمعية عن الحياة المشوهة تحت الاستعمار والتي توحي للفلسطينيين بأنهم يعيشون في دولة تحت الاحتلال، وتُغيّب مشاريعَ التحرر وقيم العمل التوعوي وَ مقاومة الاستعمار، وتستبدل بخطابات التنمية الاقتصادية وتقارير للبنك الدولي عن جاهزية الدولةnbsp;وَ نموّ الاقتصاد الفلسطيني، تلك التقارير المتغيرة حسب السياقات، في حين أن المجتمع الفلسطيني يعيش حالة استعمارية بالمعنى الذي قصده جورج بلانديه (Balandier 2nbsp;وإن اختلفت خصوصياتها عن سياقات مستعمَرية أخرى سابقة. وتظهر لنا مجتمعيًّا الهوة بين الخطاب الرسمي وتوقعات الناس؛ ولنا أن نسرد هنا مجموعة من الإشارات: قرار المجلس المركزي -الذي اعتبر شكلاً تفريغيًّا- بتجميد التنسيق الأمني الذي وصفته تيارات رسمية بأكثر من ضروري للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، بل جرى تحميله صفة القداسة؛ إذ لم يثر هذا القرار الشارع الفلسطيني، بل أعاد كذلك فتح النقاش القديم الجديد حول دَوْر المؤسسات الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير ومدى شرعيتها ودستوريتها، بل ومدى قدرتها على تقديم نفسها بالمعنى المؤسسي وقدرتها أصلاً على اتخاذ قرارات في ظل ما يتداوله الناس عن هيمنة رؤى أحادية لإدارة السياسة في فلسطين. وتعمل المؤسسات الفلسطينية المختلفة على استبطان خطاب يقدّم على أنه خطاب يرتكز على منطوقات السياسة كفنّ للممكن وَ العقلانية وَ ضرورة مخاطبة الآخر (الغربيّ طبعًا) وموازين القوى المختلة لصالح إسرائيل وضعف الفلسطينيين وَ تخاذل العرب. ويجري بث ذلك عبر الوسائل الإعلامية المختلفة السمعيّة والبصريّة والمكتوبة، وينبري روّاد السياسة وبعض مسؤولي الفصائل للتأكيد مرارًا وفى كل المناسبات أن المقاومة الشعبية السلمية هي الطريق الوحيد والشرعي والمقبول، بدءًا بخطاب رئيس السلطة الفلسطينية عشية تقديم طلب الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة، وانتهاء بقرارات بعض الفصائل لإنشاء مجموعات لتطبيق هذه الرؤى على الأرض.يتوازى هذا مع شيوع القراءات المختلفة لمشهد الانتفاضة الثانية كمشهد لمقاومة عنيفة فوضوية، كانت لها انعكاسات كارثيّة على القضية الفلسطينية وعلى المشروع الوطني الفلسطيني، وتنظر: أن الانجرار للعنف هي ممارسة لا واعية تنسجم مع سياسة إسرائيل التي تقوم على جر الفلسطينيين إلى مربع العنف المريح لها. هذه المحاججات (التي لا يتسِّع المقام لنا هنا للتوسع فيها) تستحضرها أطياف وتيارات مختلفة، ويُستبطن بعضها مجتمعيًّا؛ والمقصود بذلك أن الجهات الرسمية -عبْر وسائل الاحتكار والهيمنة- تفرض رؤاها على المجتمع، وتعمل آلاتها الإعلامية والتوعوية على بثّ هذا الخطاب باعتباره التزامًا برؤى السلطة الشرعية. ونظرًا لغياب قدرة المجتمع على تخليق رؤى مضادة، فإنّ هذا الخطاب، الذي يمتلك السيطرة على الأجهزة الإيديولوجية الدولاتيّة، وتدعمه قوى سياسية ناشطة على الأرض، يُسانَد ويُدعَم مقابل قمع المجموعات الأخرى، حتى تلك المرتبطة سياسيًّا بالأحزاب المهيمنة في السلطة؛ وفى ظل غياب مشروع جامع لتبنّي إستراتيجية موحدة للمقاومة الفلسطينية، فإنّ أي مشروع لا ينسجم مع التوجهات الرسمية هو مشروع عبثيّ، وهذه الصفة العبثيّة تنطبق على مشاريع المقاومة غير المنسجمة معها، وتنطلي تحتها صواريخ المقاومة المنطلقة من غزة وكذلك كل أشكال الاشتباك مع الاستعمار فى الحروب الثلاث التي شنّتها دولة الاستعمار على قطاع غزة، والتي جرى تقديمها كأَجِنْدة سياسية إقليمية لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، وتقدم كممارسات غير مسؤولة تجرّ المآسي على السكان إلخ... وتقدّم خطابيًّا رؤى بديلة عنها تقوم على تبنّي التفاوض كوسيلة وحيدة تجعل من شعار الحياة مفاوضات شعارًا مؤسِّسًا للممارسات الرسمية الرؤية من 1993 -2013، ثم يستبدل بإستراتيجية جديدة تقوم على إعادة تبنّي التفاوض كخيار إستراتيجي مع ضرورة تدويل التفاوض 2015. ويترافق ذلك مع سياسات استهلاكوية تقوم على تعميم سياسات الإقراض المنسجمة مع توجهات البنك الدولي وسياسات المانحين التي تقوم على ادعاء الرغبة في تحسين الشروط الحياتية والمشاريع المجتمعية التي تبث خطابات التمكين والشفّافيّة والحَوْكَمة المُعَدّة سَلَفًا والمستقدَمة عبر تكنوقراطيّين دوليين وخبراء مُعَوْلمين. ويظهر هذا الاستبطان جليًّا في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية عبر المنظمات غير الحكومية. وبالتوازي مع ذلك، تبث قيم الاتكاليّة وتغيب العمل الطوعي والثقافة الطوعية؛ مقابل استدخال المجموعات الشبابية لخطابات العالم المهيمن، وانتشار حالات التمظهر الاجتماعي لمجموعات تحتاج إلى شرعية كما ظهر في حادثة استشهاد الوزير أبو عين الذي على أثره فرضت السلطة حدادًا لمدة ثلاثة أيام، في حين أن عشرات الشهداء سقطوا في حوادث واكتُفِيَ بإدانتها باعتبارها حوادث عادية.يُبثّ هذا الخطاب بالموازاة مع الهيمنة على الفضاءات العامة واحتكار أشكال الاحتجاج فيه لصالح مجموعات تتماهى مع هذه السياسات والرؤى وقمع وتهميش كل المجموعات الأخرى التي لا تقبل بقواعد الاشتباك المُعَد سلفًا. وعليه تتحول قرى بلعين ونعلين والنبي صالح بهذا النحو إلى مزار ومَحَجّ للقناصل وممثلي الهيئات الدولية والتي تمارس على هذه المجموعات خطاب النيو كولونيالية، تطالب فيها المجموعات التضامنية العالمية من الشركاء الفلسطينيين تبنّيَ أشكال معينة، وإلاّ فقدوا المساندة المشروطة. ويندرج جزء كبير من الممارسات الاحتجاجية ضمن طابع الاحتجاج الموسمي المرتبط بأَجِنْدات معينة مرتبطة بسياسات التوجيه وحتى الإعداد لخدمة مصالح سياسية معينة، مما يجعل مجموعات كبيرة من الناس تنأى بنفسها عن المشاركة في هذه الأشكال الاحتجاجية التي تجعل المجتمع بكامله في حالة انتظار وترقّب وفُرجة.يقوم هذا الخطاب الجديد على تبنّي مشاريع معيارية جديدة كنماذج جديدة، على نحوِ ما نجده في ظاهرة محمّد عسّاف كشكل معياري جديد لصورة البطل الفلسطيني للشاب المتوخَّى، وفي تحويل الفدائي إلى لاعب كرة قدم3، وفي إشغال السكان بالسياسات الهُويّاتيّة الرمزية القائمة على دخول “موسوعات جينيس عن طريق أكبر منسف وَ أكبر صدر كنافة وَ أكبر صحن تبولة وَ أطول عَلَم، إلخ...؛ وفي سياسات ادعائيّة عن بناء دولة القانون والتمكين وبناء المؤسسات لاستجلاب المساعدات الدولية، بينما يشعر الكثير من المواطنين أنّ ثمة غيابًا تامًّا لدولة القانون واقتصارها على تضخم ميزانية الأمن التي تبتلع أكثر من 28 بالمائة من ميزانية السلطة، يقابل ذلك تفشّي سياسات المحاباة والزبائنية والمحسوبية في التوظيف وتفشّي البطالة. وتسعى السياسة الفلسطينية الجديدة إلى اعتبار توجّه السلطة الفلسطينية إلى هيئات دولية ودخولها في المؤسسات الدولية كإنجازات وطنية. ويظهر لنا الفتور المجتمعي في التعامل معها من خلال عدم مبالاة الناس بالاحتفالات المركزية التي تقودها السلطة؛ حتى إنّ ذكرى النكبة -التي هي عبارة عن حدث مؤسِّس للوطنية الفلسطينية ومصدر للحقوق الجمعية والفردية-تصبح وفقها مقنّنة ومحدّدة مسبقًا شكلها زمانيًّا ومكانيًّا؛ مما يدفع الناس لعدم المشاركة فيها بصفتها ممارسات احتفالية طقسية، ويمنع الشباب من الاشتباك مع المستوطنين، ومن الوصول إلى أماكن الاشتباك مع جنود الاستعمار بدعوى عدم الانجرار للفوضى. ومقابل غياب هذا التحرك الشعبي، تنشط حراكات لمجموعات شبابية افتراضية وفيسبوكية مُعَوْلَمة ذات تأثر عالمي؛ وهو ما يُبقي هذه الحراكات محدودة وخجولة وضعيفة من حيث حجم المشاركات في التظاهرات والفعاليات فيها، ويغيّب عن المشهد السياسي أيّةَ مشاركة فاعلة في صناعة القرارات الجماعية، علاوة على أنّه لا قدرة لها للحد من مظاهر التهميش للمكونات الفلسطينية المختلفة للشتات وفلسطينيّي 48، وتهميش القدس جزئيًّا، لصالح المشاريع الخاصة فقط بفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة طبعًا وَفقًا لرؤية السلطة الفلسطينية؛ وتفشل التيارات الفلسطينية المختلفة في قدرتها على إعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير على أسس جديدة؛ وفشل المجموعات المجتمعية في إعادة صياغة مشروع وطني جديد يقوّض احتكار الرسمية الفلسطينية.وتستخدم الخطابات الجديدة المقاطعة الاقتصادية كأشكال احتجاجية موسمية؛ تارة لمقاطعة منتجات المستوطنات لحماية القطاع الخاص الفلسطيني؛ وتارة لمقاطعة انتقائية لبعض المنتجات كردّ فعل على تجميد تحويل عائدات الضرائب؛ تصاحبها عمليات استعراض كما حدث من قِبَل مجموعات شبابية بالتعرض لبعض الشاحنات الفلسطينية المحملة بالبضائع الإسرائيلية في رام الله؛ دون أن تتحول هذه المقاطعة إلى شكل احتجاجي مقاوِم مُمَأْسَس مناهض للاستعمار يعمل على الانفكاك من تبعية الاقتصاد الفلسطيني الذى تقيِّده اتفاقية باريس الاقتصادية. مقابل هذه الرؤى للمقاطعة الانتقائية، تنشط مقاطعة أخرى تقودها مجموعات مجتمعية تعمل بالشراكة مع مؤسسات تضامنية دولية مرتكزة على جماعات ضاغطة خاصة في أوساط الأكاديميّين والمثقفين تعمل على محاصرة إسرائيل ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها. هذه المقاطعة تتوسع وتنتشر وتُؤتي أُكُلَها في العالم، ولكنها حتى اللحظة ما زالت تفتقد للحاضنة الاجتماعية الشعبية الفلسطينية. وبالتوازي مع هذه الخطابات، تُبَثّ وتُشاع استخدامات لشعارات مثل على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة؛ هذا الذي يجري استحضاره لتهميش فكرة التضحية من أجل الحياة ومن أجل الوطن، وما يرافقها من استخدامات احتفالية وتجارية بحتة تخضع لمنطق السوق المتنامي والذي يسمح للقطاع الخاص الفلسطيني باحتكار المشهد واستحواذه على الشعارات المؤسسة للوطنية الفلسطينية المعاصرة، وتدخله في الحياة العامة والمنسجمة مع توجهات القوى المانحة وخطابات التنمية غير التنموية وأثر ذلك في بثّ وشيوع النزعات الاستهلاكوية.هذه الأزمة مكررة في سياقات استعمارية أخرى سابقة في أماكن أخرى في العالم، يجري فيها تشويه الحالة الاستعمارية للمستعمرين، أما فى الحالة الفلسطينية فإنها تقدم تحت مبررات الواقعية وحق الناس بالعيش الكريم في حين لا يترافق ذلك مع سياسات اجتماعية واقتصادية تعمل على تحشيد القوى، فيصبح فيها الراتب خبر عاجل، وتتنامى سياسات الإعواز والحاجة والاتكالية والسياسات الإقراضية لجُلّ السكان والتي تؤدي مديونياتهم لمؤسسات الإقراض لأن تصبح أشكالاً من التكبيلات الاجتماعية والاقتصادية. وتزداد الحالة الاستعمارية الفلسطينية تشوُّهًا عبر غياب مظاهر الاحتلال المباشر، أي الحضور الظاهر لجنود الاستعمار في المدن والقرى الفلسطينية، الذي يكفي المواطنين لملاحظته (أي هذا الحضور أو الوجود المباشر) مجرّدُ التنقل من مكان إلى آخر، أو من خلال عمليات القتل والهدم والاعتقالات التي تذكّر الفلسطينيين بأنهم يعيشون تحت الاستعمار، وليسوا في دولة تحت الاحتلال. وتستفحل الأزمة مع فُتور التعامل الرسمي وغير الرسمي مع حصار مخيم اليرموك، والمآسي المصاحِبة له من قتل وتهجير، في ظل الانعكاسات الكارثية للتدخل الخليجي في اليمن لصالح أَجِنْدات تعيد رسم خارطة المنطقة، مما يزيد تهميش القضية الفلسطينية من جديد، في ظل اصطفاف الرسمية الفلسطينية إلى حالة التجاذب الطائفي الحاليّ في الوطن العربي.nbsp;هذه المقالة صادرة عن مركز مدى الكرمل، مجلة جدل العدد الثالث والعشرون حزيران 2015nbsp;1 مقابلات مع ناشطات وناشطين ممن شاركوا في إقامة القرى الثلاث2nbsp;Georges Balandier, “La situation coloniale. Approche théorique”. EXTRAITS. Un article publié dans les Cahiers internationaux de sociologie, vol. 110, janvier-juin 2001, pp. 9-29. Paris: Les Presses universitaires de France.3 اسم فريق كرة القدم الفلسطيني الفدائّي
عنف اللاعنف في الخطاب الفلسطيني الجديد
الآراء الواردة في المدونة تعبر عن رأي كتابها، وليس بالضرورة عن رأي الجامعة.