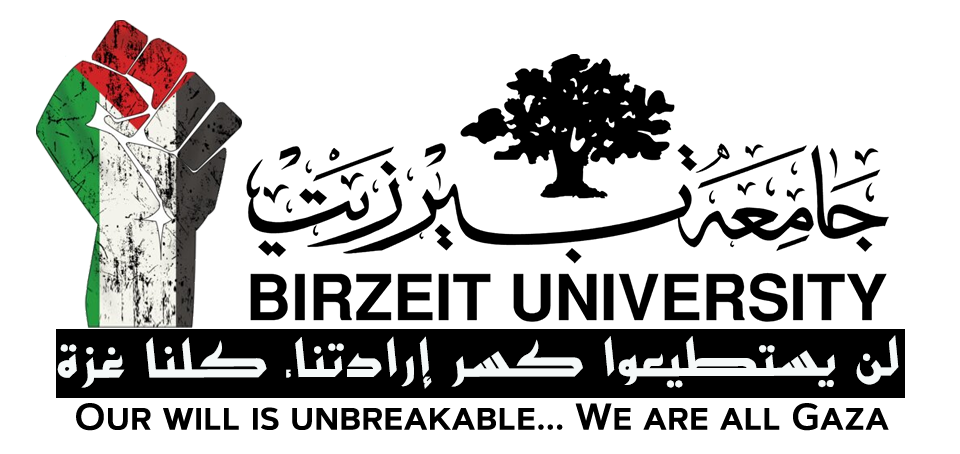أود أن أستهل بملاحظتين قصيرتين. الأولى هي أن عنوان المحاضرة قد يعطي انطباعاً بأن لي من التعليم العالي في فلسطين موقفاً سلبياً. nbsp;والواقع أن الأمر ليس كذلك. فأنا أدرك أن لشعبنا الفلسطيني أن يفخر بجدارة بإنجازات التعليم العالي في فلسطين، ذلك أنه إذا ما أخذت بالاعتبار قسوة الاحتلال وشراسة الظروف ومجمل تاريخنا المعذب، تبين أن إنشاء جامعات من سوية جامعة بيرزيت وأخواتها عمل جماعي بطولي بكل ما للكلمة من معنى. مع ذلك، لابد من مواجهة الكثير من المشاكل بغية رفع مستوى التعليم العالي الفلسطيني وجعله جديراً بشعبنا وبتضحياته الجمة. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بإمكان التنمية في ظل الاحتلال الذي ما زال، رغم كل ما يمكن أن يشير إلى غير ذلك، يجثم على صدورنا.nbsp; فمن الواضح أن العلاقة بين التنمية والتعليم بعامة، والعالي منه بخاصة، علاقة وثيقة. والواقع أن سؤال إمكانات التنمية في ظل الاحتلال ينبغي أن يكون مطروحاً علينا بقوة وأن يخضع لنقاش مجتمعي واسع معمق. غير أنني سأصدر هنا عن اعتقاد مضمر، أدرك أنه بحاجة إلى فحص وتمحيص، هو أن بالإمكان اجتراح أفعال تنموية كما لو لم يكن هناك احتلال أو كما لو أن الاحتلال إلى زوال قريب ودون أن تقوض هذه الأعمال التنموية أو تعيق إمكان مقاومة الاحتلال. بداية، يبدو لي أنه ليس لدى المجتمع الفلسطيني توافق جماعي وطني على ما هو التعليم العالي الفلسطيني. هناك نماذج للتعليم العالي مختلفة، وإن لم تكن الحدود بينها صارمة، بل بينها تراكبات وتداخلات. النموذج الأول هو نموذج التعليم العالي الجماهيري، الذي تكون نسبة المشاركة فيه عالية جداً بحيث يكاد يشمل كافة خريجي المدرسة الثانوية، وتكون نسبة النجاح فيه عالية أيضاً، لأنه إذا تحقق الشرط الأول، أي ارتفاع نسبة المشاركة، ولم يتحقق الشرط الثاني، أي ارتفاع نسبة النجاح، كانت تلك وصفة للإحباط العام لقطاع الشبيبة. ولا شك أن لهذا النموذج فوائد كثيرة. فهناك الفوائد الشخصية، أي تلك التي تتأتى للأشخاص الذين يتلقون التعليم العالي، لأن لهؤلاء، كما هو معروف، قدرة تحصيلية أعلى وقدرة على التكيف في سوق العمل أكبر، ولذا فإنهم لا يعانون من البطالة قدر ما تعاني الفئات الأخرى. كذلك فإنهم يتزودون بمعارف وأنماط تفكير وأنماط سلوك تقربهم من النجاح العملي أكثر مما يتسنى لغيرهم. وبالإضافة إلى الفوائد الشخصية، هناك فوائد مجتمعية عديدة، فمن المعروف في ثقافات مختلفة وفي اقتصادات مختلفة وفي اقتصادات على درجات مختلفة من النمو أن مراكز التعليم العالي تسهم في النهوض الاقتصادي. فالقرب من مراكز التعليم العالي، وهي في الجماهيري منه متعددة، يؤدي إلى وتائر نمو اقتصادي أعلى ووتائر توظيف أعلى ووتائر إنتاجية أعلى، كما يؤدي إلى قدرة تحصيلية أعلى لجميع العاملين، وليس فحسب لمن حصلوا على التعليم العالي، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى انتعاش البحث والتطوير. والأهم من ذلك كله أن التعليم العالي الواسع يؤدي إلى آثار عابرة للأجيال، أي آثار تنتقل من جيل إلى جيل. فمن المعروف أن أطفال من يتلقون تعليماً عالياً يتمتعون بقدرات ذهنية أعلى من غيرهم ويتمتعون بصحة أكبر وبقدر من السعادة والهناء أكثر. وتنتقل هذه الآثار من جيل إلى جيل، ولعلها أهم فوائد التعليم العالي الجماهيري. ينطبق ما سبق على المجتمعات كافة، وفي الظروف الفلسطينية المخصوصة يحتل التعليم العالي أهمية خاصة بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي ما يزال عامداً يحاول نزع التنمية، والذي لا يزال في اعتقادي يستلهم الفكرة الصهيونية الأساسية القائمة على الاستعمار الاستيطاني للبلاد واستعباد سكانها ليكونوا، كما في التعبير التوراتي، حطّابين وسقّائين في خدمة المستعمر. فإذا ما أردنا أن نجتنب هذا المصير، فلا سبيل لنا إلا بالتعليم عامة، وبالعالي الجماهيري منه خاصة. بكلمات أخرى، يمكن في الحال الفلسطيني النظر إلى التعليم العالي الجماهيري على أنه في المدى التاريخي وسيلة من وسائل مقارعة الاحتلال وتفويت مقاصده. مقابل النموذج الجماهيري، هناك النموذج النخبوي الذي يطمح إلى خلق كوادر مؤهلة تأهيلاً عاليا. يعتقد من يدافعون عن هذا النموذج أن سيادة اقتصاد المعرفة على المستوى العالمي تفرض على المجتمعات التي تريد أن تلحق بركب التقدم أو التي تريد أن تظل في صفوف الدول المتقدمة أن تعمد إلى تعليم عالي نخبوي كي تستطيع خلق وإدامة مجتمع معرفة. ويشير هؤلاء أيضاً إلى أن للتعليم العالي الجماهيري أثر سلبي، خاصة في حالة البلدان النامية، هو أنه باستيعابه لكافة خريجي المدرسة الثانوية تقريباً يحرم المجتمع من فئة الحرفيين والمهنيين، تلك الفئة التي تتطلب التنمية خلقها وتطويرها وإدامتها. والواقع أن بعض البلدان المتقدمة، إن لم يكن كلها، يعتمد حلولاً مختلطة أو مهجنة ثبتت نجاعتها، nbsp;حلولاً توفر تعليما عالياً جماهيرياً ونخبوياً في الوقت نفسه. فلو أخذنا الولايات المتحدة كمثال، لوجدنا طيفاً عريضاً من الجامعات تتفاوت فيه المستويات، وصولاَ إلى جامعات توفر تعليماً عالياً على مستوى مرتفع جداً للنخبة من حيث القدرات الذهنية. وفي بريطانيا، كان التعليم العالي نخبوياً فأصبح الآن مختلطاً، وإن كان تفاوت المستويات فيه أقل مما في حالة الولايات المتحدة (من المفارقات أن حكومة المحافظين في عهد ثاتشر، لا حكومات العمال، هي التي وسّعت نسبة المشاركة في التعليم الجامعي، ومن المفارقات كذلك أن حكومة المحافظين الحالية تعمل في الاتجاه المعاكس). وفي فرنسا، هناك نظامان متوازيان، النظام الجماهيري، المتمثل بالجامعات، ونظام المدارس العليا والعظمى الذي يخرج نخبة المهندسين والتكنوقراط والإداريين وكوادر الدولة.nbsp;nbsp; أما في حالتنا في فلسطين، فليس هناك عن وعيٍ تبنٍ لنموذج بعينه، لكن هناك في رأيي تبنياً ضمنياً للتعليم العالي الجماهيري، دون أن نفكر في عواقب هذا التبني. ونحن بحاجة ماسة إلى إطلاق نقاش جدي ومعمق حول هذه المسألة: أي نظام للتعليم العالي نريد؟ للأسباب التي ذكرت بشكل ملخص أعلاه، أعتقد أننا ينبغي أن نتبنى الحل المختلط المهجن. وتتلخص المشكلة من هذا المنظور في أن جامعاتنا كلها لا تتفاوت إلا تفاوتاً بسيطا، والأدهى من ذلك أن نظام التعليم العالي لدينا يتجه برمته إلى القاسم المشترك الأدنى، أي إلى السوية الأدنى. وإذا كانت ظاهرة تقدير التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني إيجابية جدا، إلا أنها، متضافرة مع الجهوية المستشرية، تتخذ تعبيراً سلبياً هو الرغبة في دعم التعليم العالي على إطلاقه، أي لكافة الجامعات وعلى المستوى نفسه. ولما كانت الموارد شحيحة، فإن توزيعها بالتساوي على الجامعات جميعاً، لا يمكّن أياً منها من الارتقاء فعلاً إلى مصاف أعلى، لتصبح أنموذجاً تحتذيه الجامعات الأخرى، فتشكل بذلك قاطرة للنظام كله. تلك ظاهرة سبق أن أسميتها ظاهرة توزيع التعاسة بالعدل والقسطاس. وما نحن بحاجة ماسة له هو إفراد جامعة أو اثنتين وصب الموارد فيها أو فيهما لخلق جامعة فلسطينية تجدر بالشعب الفلسطيني وتستطيع على مدى عقد من الزمن أو اثنين الارتفاع إلى سوية الجامعات العالمية. والأسباب التي تذهب بي إلى ذلك كثيرة، لعل أهمها أن بناء الدولة يحتاج كوادر على مستوى عال من التأهيل، وفلسطين بلد فقير لن يستطيع في كافة الأحوال أن يحتل مكانة بين الأمم إلا إذا أصبح اقتصادنا اقتصاد معرفة ومجتمعنا مجتمع معرفة، ولا سبيل إلى ذلك دون جامعة أو اثنتين على سوية الجامعات العالمية. المعضلة الأخرى هي تشوه مفهوم التعليم العالي لدى المجتمع الفلسطيني، الذي يبدو أنه، أيضا دون أن يكون نقاش مستفيض، يعتبر الجامعة إما مصنعاً للشهادات أو مؤسسة تدريب. لكنها في الحقيقة ليست هذا ولا ذاك، بل هي أساساً متّحد، أي جماعة متعاضدة، من المفكرين والعلماء مهمتها حماية العقلانية في المجتمع، وهي تفعل ذلك عن طريقين. أولهما طريق الإنتاج الفكري والعلمي الذي يذود عن العقلانية ويرسخها ويشذبها ويطوّرها في اتجاهات شتى وميادين متعددة، وثانيهما طريق تأهيل أجيال متشربة للعقلانية مستنبطة لها تتبناها في عاداتها الذهنية وطرائق تفكيرها. هكذا ينبغي أن تظل الجامعة سلعة عامة، كما سأحاجج لاحقاً، وفضاءً مستقلاً لتطوير المواطنة النقدية الديموقراطية المنتجة. وكما أشار أحد المربين، لعل أفضل أسباب الدفاع عن التعليم العالي يكمن لا في الخدمات التي يقدمها... بل في القيّم التي يمثلها. بالطبع ما من جامعة لا تلتفت إلى سوق العمل على الإطلاق. لكن العلاقة بين التعليم العالي وسوق العمل ليست علاقة بسيطة أحادية الاتجاه،nbsp; بل هي علاقة مركبة تفترض أن دور الجامعة هو التعليم والتثقيف وليس التدريب. وإذا كانت الجامعة تلتفت إلى الإعداد لسوق العمل، وهي تفعل، فإن هناك دوماً فترة تخلف زمنية ما بين استجابة الجامعة للتطورات الحقيقية في سوق العمل وبين حدوث هذه التطورات. ذلك أن الجامعة تستجيب بطريقتها هي، لا بالتدريب المباشر، بل بتعديل التعليم والتثقيف، ما يأخذ وقتاً. كذلك لا تستجيب الجامعة إلاّ بعد أن تتأكد من أن التطورات المعنية مستديمة وليست نزوات أو أحداثاً عشوائية في سوق العمل. على أن كون الجامعة ليست أساساً مؤسسة تدريب لا يعني أنه ليس لها دور فيه خلال الدراسة الجامعية، والأهم بعد التخرج في الوظيفة. فقد طوّرت المجتمعات المتقدمة وتلك التي بدأت تقطع شوطاً على طريق التقدم، كما في جنوب شرق آسيا، أنظمة تدريب وطنية تلعب فيها الجامعات والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات تنتمي إلى المجتمع المدني تعرف بالجمعيات العلمية أدواراً متكاملة، أهمها دور الجامعات التي تزود المساهمة الكبرى في اختطاط برامج التدريب ودور الجمعيات العلمية التي تشرف على تنفيذ التدريب في أماكن العمل. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن المجتمعات العربية عامة، ومنها المجتمع الفلسطيني، تفتقر إلى وجود جمعيات علمية، وخاصة جمعيات علمية مهنية. ففي بلادنا، اتحادات المهنيين من مهندسين وأطباء ومحامين وما إلى ذلك أشبه بالنقابات العمالية، بينما هي التي تقوم في المجتمعات المتقدمة بدور الجمعيات العلمية التي تأخذ على عاتقها التطوير العلمي للمهن المختلفة، وفي غالب الأحيان هي التي تتولى نشر أرقى المجلات العلمية الأكاديمية المتخصصة في حقول المعرفة المتعلقة بالمهن.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp; كذلك لابد من الالتفات إلى أن انصراف الجامعة إلى التدريب المباشر على التقنيات الراهنة وباستخدامها، بدلاً من التعليم والتثقيف وما يتضمنانه من تكوين وتشكيل عادات تفكير وتعلّم، يؤدي إلى عكس الغرض المقصود منه. فهو وصفة أكيدة للتقادم السريع للخريجين الذين يعجزون إذ ذاك عن مواكبة التطور التقني والعلمي المتسارع أبداً، فيصبحون عبئاً على سوق العمل بدل أن يكونوا ذخراً له. وإذا ما قبلنا مفهوم التعليم العالي الذي أوردناه فيما سبق التفتنا إلى مشكلة أخرى هي أن هذا التعليم في فلسطين تقني أكثر مما ينبغي ولا يعطي الثقافة العامة الحيز الذي تستحقه كي تتمكن الجامعة من لعب الدور الذي ينبغي أن يكون منوطاً بها من حيث تطوير المواطنة النقدية المنفتحة. لقد كانت جامعة بيرزيت فيما مضى تزود طلابها بثقافة ليبرالية عامة قيّمة وواسعة. ولذا ليس من قبيل الصدفة أن يكون الجيل الحالي من قادة المجتمع والاقتصاد والسياسة في فلسطين من خريجيها. ومما يؤسف له أن هذا الدور قد تأكل بعض الشيء في بيرزيت وربما ما كان موجوداً أصلاً في الجامعات الفلسطينية الأخرى. وبالفعل، أصبحت إعادة الاعتبار للتثقيف العام مهمة ملحة. وهنا يجدر الانتباه إلى أن بعض من يدعون إلى ذلك من الأكاديميين في فلسطين يعرّفون الثقافة العامة تعريفاً ضيقاً، مؤدلجاً بعض الشيء، يجعلها مقتصرةً على دراسة الأفكار وتاريخها. هذا في حين أخذت الجامعات في العالم وبتزايد تتبنى في صياغة برامج الثقافة العامة مبدأ التوزيع الذي يقوم على أن الجامعي ينبغي أن يكون ملماً بطرائق التفكير العلمي والرياضي والاحتسابي، بالإضافة إلى طرائق التفكير في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. ومن البديهي أن تكوين شخصية الطالب وإكسابه المهارات القيادية والمهارات العامة غير المرتبطة بحقل معرفة محدد بعينه، مثل مهارات الاتصال والتفاوض والذكاء الاجتماعي، هي أيضاً من مهام التعليم العالي. وليس ذلك رهن بالتثقيف العام فحسب، بل هو مرهون كذلك بتوفير حياة طلابية جامعية ثرية متنوعة، وتلك مشكلة أخرى سأتطرق لها فيما بعد. ها قد أتينا إلى المعضلة التي لأهميتها البالغة يكثر المهتمون بالتعليم العالي في بلادنا الحديث عنها، أقصد معضلة التمويل. غير أنني أولاً أود الإشارة إلى أنه ليس هناك في مجتمعنا إدراك لمدى ارتفاع التكاليف الحقيقية للتعليم العالي الجيد الذي يفترض فيما يفترض نسبة منخفضة للطلاب إلى الأساتذة المؤهلين تأهيلاً عالياً ومنشآت ومختبرات ووسائط تعليم وموارد تدريسية ومكتبات مجهزّة بالكتب والمطبوعات الإلكترونية وقواعد البيانات. إلى ذلك تتشكل غالبية مصاريف الجامعة من رواتب أعضاء الهيئة الأكاديمية، وهؤلاء يؤدون وظائف بالغة التخصص معقدة تصعب كثيراً زيادة إنتاجيتها. أضف إلى ذلك أن التطورات التكنولوجية التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية في الاقتصاد العام، وبالتالي تخفيض التكاليف، هي ذاتها تؤدي إلى زيادة التكاليف في التعليم العالي الذي يتوجب عليه حينئذ الحصول على التكنولوجيات الجديدة لاستخدامها في التعليم. ومن هنا، يجمع الاقتصاديون على أن وتائر التضخم أو زيادة الأكلاف في التعليم العالي تفوق دوماً مثيلاتها في الاقتصاد عموماً. كل هذا يعني أن هذا التعليم ليس مكلفاً جداً فحسب، بل أيضاً أن تكاليفه تتزايد باطراد وبنسب كبيرة نسبياً. ولا يقتصر الإشكال على الافتقار إلى إدراك مدى ارتفاع تكاليف التعليم العالي، بل يتعداه إلى كون النموذج التمويلي نموذجاً غير مستدام. فالرسوم تشكل حوالي 70 في المائة من عوائد الجامعة والأجور تشكل حوالي 70 في المائة من مصاريفها. أما الرسوم فمنخفضة ولم تعد منذ زمن تغطي الأجور وإمكانات زيادتها محدودة جداً، بينما تتزايد الأجور باستمرار من عام لآخر لتغطية الارتفاع في تكاليف المعيشة كما تحدده الاتفاقات الجماعية بين اتحادات عمال وموظفي الجامعات ومجلس التعليم العالي. هكذا يتفاقم العجز التمويلي عاماً إثر عام، ولا يحتاج المرء لأن يكون عالم اقتصاد أو مالية ليدرك أن الأمر إن لم يتدارك يدفع باتجاه إفلاس النظام كله. من ناحية ثانية يسود المجتمع الفلسطيني عامة اعتقاد بأن التعليم العالي يجب أن يكون مجانياً أو شبه مجاني. والواقع أن ذلك غير ممكن إلا إذا تكفلت الحكومة بالتكاليف كلها، وهو ما لا يتأتى إلاّ في اقتصاد مزدهر تقوم فيه السياسةnbsp; الضريبية على توفير السلع العامة عند نقاط الطلب مقابل ارتفاع النسب الضريبية. ومن الواضح أن ذلك ليس ما نحن فيه، كما أنه ربما ليس ما يرغب فيه المجتمع إذا ما اتخذنا من تجربة فرض الضرائب وجبايتها حتى الآن دليلا. على أن اعتبار أن التعليم العالي سلعة عامة، وهو في اعتقادي ما يجب أن يكون، لا يعني بالضرورة أن يكون شبه مجاني، بل يكفي توفيره لمن هو مؤهل له ولا يستطيع تحمل نفقاته، أي ضمان ألا يحرم منه المؤهلون له بسبب ضعف الحال المالي، فيما يدفع من يستطيعون ذلك رسوماً تقارب الكلفة الحقيقية. أما الوضع الراهن فيعني في واقع الحال تقديم دعم للطبقة الوسطى التي تشير الدلائل إلى أن قسماً كبيراً، إن لم يكن الأكبر، من الطلاب ينتمون إليها. كما أن انخفاض الرسوم دون تقديم منح كاملة تغطي تكاليف المعيشة للفقراء حقاً، كما هو الحال الآن، قد يعني أن هؤلاء لا يلتحقون بالتعليم العالي بالمعدلات المرغوبة. ومن هنا، قد يبدو النظام التمويلي الراهن ذا ملامح اشتراكية، لكنه قد يكون في الواقع نظاماً يميز ضد الفقراء.nbsp; ومن المسائل التي تثير جدلاً في مجتمعنا مسألة البنية التنظيمية للتعليم العالي ومسألة الحوكمة المرتبطة بها. والواقع أن التركيبة الحالية، على الأقل من حيث المبدأ، متقدمة على ما في منطقتنا العربية. ذلك أن الغالبية العظمى من الجامعات مستقلة غير ربحية تديرها مجالس أمنائها، لكنها مؤهلة للدعم الحكومي (الشحيح والذي في كثير من الأحيان لا يأتي). ولا تتدخل الحكومة في شؤون هذه الجامعات الأهلية إلا، كما يقولون، من على مسافة ذراع، بينما الجامعات في باقي المنطقة إما حكومية أو خاصة ربحية. غير أن التركيبة الحالية تتعرض لهجوم قوي من اتجاهين. فهناك من ذوي النزعة الدولتية ( أي من يريدون أن تهيمن الدولة على كل شيء) من ينادون بأن تصبح الجامعات كلها حكومية، وهناك بالمقابل من ينادون بأن تصبح الجامعاتnbsp; ربحية خاصة يملكها الشركاء أو المساهمون فيها. ومن الواضح أنه إذا أريد للجامعة أن تلعب دور حماية العقلانية وخلق المواطنة الديموقراطية النقدية فلا بد لها من أن تنتمي إلى المجتمع المدني، وبالتحديد إلى القطاع التطوعي منه، وأن تحافظ على استقلالها عن الدولة وعن القطاع الخاص في آن معاً. وبالمناسبة، ليس صحيحاً الاعتقاد السائد بأن الجامعات الأمريكية العظيمة جامعات خاصة، أي ربحية، فهي إما جامعات ولايات تعاملها حكومات الولايات من على مسافة ذراع أو جامعات مستقلة غير ربحية. ثم هناك مشكلة شح البحث العلمي في جامعاتنا. تتردد أحياناً نغمة أن جامعاتنا تعليمية لا بحثية، فلماذا يطلب من الأساتذة أن يقوموا بالبحث العلمي؟ صحيح أن هناك جامعات تعليمية وأخرى بحثية، لكن الجامعات التعليمية تصّر اليوم على أن يقوم الأساتذة فيها بالبحث العلمي حتى ولم تصب الأبحاث التي يقومون بها مباشرة في التعليم الذي يمارسونه. فقد ثبت بالممارسة أن الانقطاع عن البحث العلمي يفقد الأستاذ الجامعي القدرة على متابعة التطورات في موضوعه (مشكلة أوراق المحاضرة الصفراء لقدمها). ولا يعود سبب العزوف عن العمل البحثي في كثير من الأحيان إلى نقص الموارد، بل إلى الانقطاع الطويل عن المجتمع العلمي العالمي بسبب الاحتلال والظروف التي مرت بها بلادنا. ففي كل مجال من مجالات البحث العلمي، هناك ما يسمى بالكلية غير المنظورة التي ينتمي إليها من يعملون فيه. فهؤلاء يلتقون في المؤتمرات والندوات ويتواصلون ويتبادلون أوراق العمل قبل نشرها، ما يثري جهود كل منهم. وبما أن نشر ورقة بحث جدية في مجلة مرموقة يستغرق وقتاً طويلاً قد يصل السنتين، فإن من يعتمد على المنشور فقط قد يتخلف عن الركب زمناً. لهذا لا بد من السعي حثيثاً إلى إعادة إلحاق الأساتذة الجامعيين في بلادنا بمثل هذه الكليات غير المنظورة وتسهيل ارتباطهم بها. أما في مجالات البحوث الاجتماعية بخاصة فهناك مشكلة طغيان الدراسات السياساتية غير المستندة إلى أبحاث جديّة كما يفعل الكثير من المنظمات غير الحكومية، التي يبدو أنها ناجمة عن تشجيع الممولين لها. وهذا بالطبع لا ينفي ضرورة الأبحاث السياساتية التي تشكل الحاجات الحقيقية للمجتمع حافزها ومبررها. ومما لا يشجع البحث العلمي بل ويعمل على إضعاف جودة التدريس أيضاً تشوه نظام الحوافز والعواقب. فمن جهة لا تشكل الترقية من رتبة إلى أخرى حافزاً مادياً كبيرا، ومن جهة ثانية ليست هناك عواقب جدية لسوء الأداء بسبب الأمن الوظيفي الذي تمنحه قوانين العمل وتفرضه صعوبة تجنيد أساتذة. وتشكل هذه العقبة الأخيرة، أي صعوبة تجنيد أساتذة، معضلة حقيقية، ذلك أن سيطرة الاحتلال على الحدود والمعابر وانتهاجه سياسة عدم إعطاء تصاريح عمل للأكاديميين تعني أن الجامعات لا يمكنها أن توظف إلاّ من كان يحمل هوية، ما يحول دون الاستفادة من المخزون الهائل من القدرات الأكاديمية الفلسطينية المغتربة ممن يحملون جنسيات مختلفة.nbsp; ومن المعروف أن الجامعة الوطنية تلعب في بناء الأمم دوراً مركزيا. ومن بين مشاكلنا أن التقطع الجغرافي الذي يفرضه الاحتلال وعدم سماحه لطلاب غزة بالالتحاق بجامعات الضفة وبالعكس أدى بالجامعات كلها إلى أن تصبح جامعات محلية. ويبدو أن بيرزيت أفضل من غيرها من هذه الناحية، إذ أن 28 في المائة من طلبتها هم من غير منطقة رام الله والوسط. ومن الواضح أن ذلك ليس مرضياً بحال، وهناك ما يمكن عمله لتشجيع انتقال الطلبة من مناطقهم للدراسة في جامعات خارجها. وهناك من بين المشاكل الملحة الحاجة إلى إصلاح الحياة الطلابية الجامعية ومجابهة استيلاء السياسة المشوهة الصدامية الفصائلية ذات النفس العشائري عليها. ينبغي بالطبع للطلاب أن ينخرطوا في السياسة الجدية، السياسة بما هي دراسة الواقع والتفكير الاستراتيجي واستعمال الحجة والمنطق. ولكن ينبغي أيضاً توسيع الاهتمامات لتشمل الأدب والفن والرياضة والتاريخ والآثار والعمارة وكل ما يوسع المدارك ويشحذ الذائقة. أخيراً، هناك تشوهات بنيوية كثيرة، أذكر منها على سبيل المثال ثلاثة. الأول أن احتساب الدعم المادي الحكومي، وإن يكن متقطعاً وغير ثابت، يقوم على مؤشرات عددية، ما يدفع باتجاه زيادة أعداد الطلبة ربما دون أي مبرر آخر. والثاني هو أن بالإمكان جباية رسوم مجزية على البرامج الجديدة ولا يمكن إلا في حدود ضيقة رفع الرسوم على البرامج القديمة، ما يدفع إلى إطلاق برامج جديدة حتى ولو لم تكن هناك حاجة حقيقية لها أو لم تكن الجامعة المعنية مؤهلة لها حقاً. أما المثال الثالث فهو أن مدفوعات نهاية خدمة الأساتذة تتصاعد بشكل غير خطي مع مدة الخدمة، ولا يستطيع الأستاذ إذا ما انتقل إلى جامعة أخرى أن ينقل ما توفّر له معه. ولذا ما أن يلتحق أستاذ بجامعة حتى تصبح له مصلحة راسخة في أن لا يتركها، فيحدّ ذلك من حركية الأساتذة وانتقالهم إلى جامعة أخرى حتى ولو كانت جذابة لهم لأسباب أكاديمية. وهذا بدوره يفاقم مشكلة انتفاء التفاوتات في المستويات بين الجامعات. ختاماً، أخشى أن أكون قد رسمت صورة قاتمة. مع ذلك، دعوني أقول إنني فخور جداً بإنجازات التعليم العالي الفلسطيني وإنه يحق للشعب الفلسطيني فعلا أن يفتخر بما حققه بالمقارنة مع قساوة الظروف وبالمقارنة مع التضحيات الجمة التي قدمها الناس حتى نستطيع الوصول إلى ما وصلنا إليه، وهو ليس بالقليل. محاضرة المرحوم برهان الدجاني التي تقيمها مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنوياً، ألقيت في رام الله في 26/11/2012 nbsp;
معضلات التعليم العالي في فلسطين
الآراء الواردة في المدونة تعبر عن رأي كتابها، وليس بالضرورة عن رأي الجامعة.