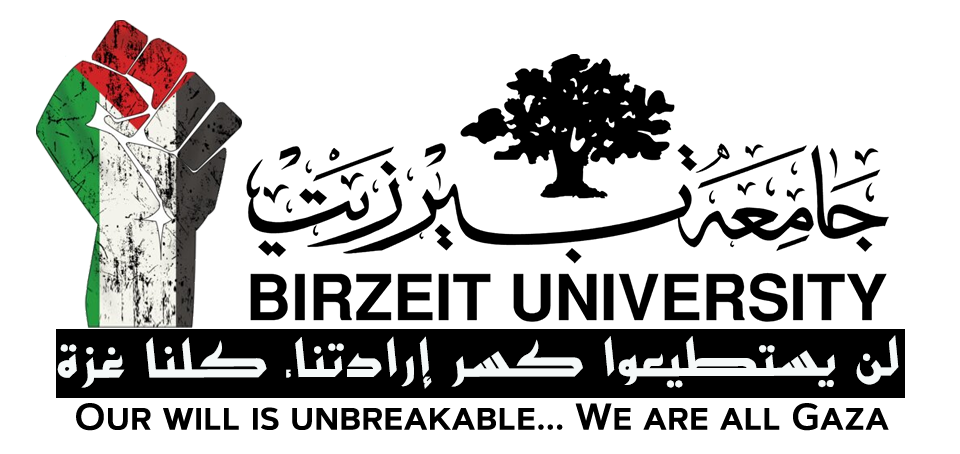للإجابة عن هذا التساؤل وما علاقته بصفقة القرن والتحول الذي حصل على هذه «الصفقة» ينبغي البدء بأثر الانتفاضات والثورات العربية على عدد من دول المنطقة كإطار تحليلي يسعف في تفسير تسلسل الأحداث.
وتشكل الانتفاضات والثورات العربية التي بدأت في تونس في 17 كانون الأول 2010، وبخاصة ثورة 25 يناير 2011 في مصر، نقطةَ الانطلاق هنا؛ ذلك أن خشيةَ عددٍ من الدولِ العربيةِ من انتقالِ هذه الانتفاضاتِ إليها أمرٌ معروف، وبخاصةٍ بعد اندلاعها في مصر. وقد شكل عددٌ من الدول العربية الركنَ العربيَّ من الثورةِ المضادة، وقد راقب بعض هذه الدول بدقة مسارَهَا وتطورَهَا، وبخاصةٍ في مصر، بما في ذلك موقفُ إدارةِ الرئيسِ أوباما مباشرةً بعد اندلاعها.
وقد حصل تطورٌ تدريجيٌ في موقفِ إدارةِ أوباما خلال عشرةِ أيامٍ أو ما يقارب ذلك بعد 25 يناير، وانتقالٌ متدرجٌ من الدعوةِ إلى المحافظةِ على «الاستقرار»، إلى الدعوةِ إلى مغادرةِ مبارك لمنصبه. وقد شكلَ هذا الموقفُ الأخيرُ غضباً كبيراً في عددٍ من الدولِ العربية، وبخاصة في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ التي كان ردُّ فعلِهَا حنقاً وسخطاً كبيرين يشوبهما الهلع، «لتخلي» الولاياتِ المتحدة عن «أصدقائها»، بعد أن كان التصورُ عن هذه «الصداقة» أن المطلوبَ منها أساساً أن توفرَ الحمايةَ لهذه الأنظمة، وتضمنَ ديمومتَهَا وأمنَهَا. وقد خرجَ عددٌ من الناطقين بلسانِ النظامِ في السعودية، بما في ذلك جوقةٌ من الكُتَّابِ في الصحفِ الممولةِ سعودياً، خرجوا علناً في نقدهم لموقفِ إدارةِ أوباما، في سابقةٍ ليست معهودةً كثيراً في تاريخِ هذه العلاقة.
أنا أتحدثُ، هنا، عن الفترة ما بين 25 يناير واعتزالِ مبارك في 11 شباط، وما بعد ذلك، وبخاصةٍ أن السعوديةَ عرفت أن عزلَ مبارك تمَّ بالتنسيقِ بين الولاياتِ المتحدةِ والمجلس الأعلى للقواتِ المسلحة، كضرورةٍ لا بدَّ منها للسيطرةِ على الثورة، الأمرَ الذي أتمَّهُ المجلسُ الأعلى للقواتِ المسلحة بعد ذلك من خلالِ خارطةِ طريقٍ رَسمَتْ معالمَهَا «الإعلاناتُ الدستورية»، وانتهاءً بالانقلابِ على الرئيسِ مرسي، وبعد ذلك على شبابِ الثورة. وكانت السعوديةُ والإماراتُ خلال فترة تزيد على عامين، وحتى الثالث من تموز 2013، وما بعد ذلك أيضاً، كانتا طرفاً في الثورةِ المضادةِ بتمويلٍ سخيٍّ للنظامِ كما هو معروف.
لم يكن هذا السببَ الوحيدَ في عدمِ رضا السعودية والإمارات عن سياساتِ الولاياتِ المتحدة في المنطقة، وبخاصةٍ فيما يتعلقُ بإيران، بما في ذلك قيادةُ إدارة أوباما المفاوضاتِ التي انتهت بتوقيعِ اتفاقيةٍ في تشرين الثاني 2013، بين الأعضاءِ الدائمينَ الخمسةِ في مجلسِ الأمن زائد ألمانيا والاتحادِ الأوروبي، مع إيران. فإضافةً إلى الثورةِ في مصر، تطابقَ هذا، أيضاً، مع موقفِ إسرائيلَ من الاتفاقِ مع إيران، التي ناهضتْ أي اتفاق منذ بدأتْ المفاوضاتُ في العام 2006. وفي العام 2010، كانت إسرائيلُ، بقيادة نتنياهو، على وشكِ قصفِ إيران، وقد أفشلَ هذا المسعى عددٌ من قيادات جيشه في حينه.
وفي مسعى لرأبِ الصدعِ مع السعودية تحديداً، قام الرئيس أوباما بزيارتها في نيسان من العام 2014. وكانت زيارةً باردة، سعى أوباما من خلالها إلى التأكيدِ على دور الولاياتِ المتحدةِ في «تأمينِ أمنِ المنطقة»، كما قال، أي حمايةَ الأنظمةِ التي فقدتْ الثقةَ بالولاياتِ المتحدة بعد عزلِ مبارك، وبعد الاتفاقِ مع إيران حول الملفِ النووي. وأصبح من الواضحِ أن هذه الأنظمةَ في حاجةٍ إلى حليفٍ آخر قويٍّ لغرضِ هذه الحمايةِ دون ضرورةِ التخلي عن الولايات المتحدة. لكن سياسةَ أوباما في المنطقة، بما في ذلك في سورية، زعزعتْ هذه الثقةَ إلى حدٍّ كبير. وبدا أن إسرائيلَ قادرة، إلى حد ما، على أن تقومَ بهذا الدور.
هذا التطابقُ في المواقفِ بين مصالحِ عدد من الأنظمةِ العربية، وبخاصةٍ في الخليج العربي، وإسرائيل، تَعَزَّزَ بعد انتخابِ الرئيسِ ترامب. وكانت السعوديةُ قد خرجتْ علناً حول حاجتها إلى تقاربٍ أوثقَ مع إسرائيلَ من خلال زيارةِ وفدٍ بقيادةِ الجنرالِ المتقاعدِ أنور عشقي إلى إسرائيل في تموز 2016 عشيةَ الانتخاباتِ الرئاسيةِ الأميركية. وكانت إحدى الرسائل الأساسية التي تم إيصالُها في اجتماعاتٍ عدة مع أعضاء كنيست، أن هذا التقاربَ، والتطبيعَ مع الدول العربية عامةً، يلزمُهُ حل للصراع مع الفلسطينيين. وكانت السعوديةُ ودولةُ الإماراتِ في الفترةِ نفسِها على تواصلٍ مع عددٍ من مستشاري ترَامب لغرضِ التأثيرِ على سياساتِ إدارة ترامب المستقبليةِ فيما يتعلقُ بإيران والموضوعِ الفلسطينيِّ أيضاً. وبحسبِ أحدِ المصادر، مع زيارةِ ترامب إلى الرياض في أيار 2017، كانت المعالمُ الرئيسيةُ للخطة التي سُمِّيت «التحالفِ الاستراتيجيِّ للشرقِ الأوسط»، والتي تضمنتْ «صفقةَ القرن»، أي الجانب المتعلق بمسار سياسي مع الجانب الفلسطيني، يضاف إليه كجزء من «التحالف الإستراتيجي» التطبيع مع عدد من الدول العربية قد تم الاتفاقُ حولَهَ بين جاريد كوشنير ومحمد بن سلمان. وقد قال محمد بن سلمان لأحدِ الزائرينَ الأميركيين في وصفها: «سأتولى أنا أمرَ الفلسطينيين، وسيتولى ترامب أمرَ الإسرائيليين».
وفعلا، «تولى ترَامب أمر الإسرائيليين» فقدم لهم عددا من «الهدايا» من بينها القدس «الموحدة» ونقل السفارة وضم هضبة الجولان وقطع التمويل عن «الأونروا» وتقليص عدد اللاجئين الذين تعترف بهم الولايات المتحدة كلاجئين، هذا إضافة إلى تصميم «الحل السياسي» المقترح من منظور كلي صهيوني الذي يتماثل أيضا مع توجه فريق كوشنير بما في ذلك هو نفسه. وبعد عرض الخطة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لم يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية أي موقف واضح منها، ربما بانتظار رفضها من الجانب الفلسطيني، أو أيضا إرضاء لحلفائه من اليمين المتطرف الذين تحفظوا على وجود «دولة فلسطينية» في الخطة، حتى لو كانت هذه «الدولة» داخل دولة إسرائيل ودون سيادة.
وفعلا رفض الجانب الفلسطيني الخطة وبقوة وعزم كبيرين، بحيث لم يعد في الإمكان تنفيذها في غياب طرف فلسطيني. وبعد مرور بضعة أشهر على الرفض الفلسطيني خاصة تكرار الموقف بعد الإعلان عن الخطة في بداية العام 2020، وأصبح من الواضح عدم إمكانية وجود أي مسار سياسي بموجبها، أعلن نتنياهو ولأسباب سياسية داخلية أنه ينوي الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة الغربية. وتأزم الوضع السياسي خاصة بعد إعلان الجانب الفلسطيني قطع الاتصالات مع إسرائيل، وتبع ذلك شجب من الدول الأوروبية والأردن ودول أخرى لفكرة الضم. هنا كانت نقطة التحول في الموقف الإماراتي والسعودي أيضا.
ففي أواسط حزيران الماضي، نشر سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة مقالا بالعبرية في جريدة «يديعوت أحرونوت» وعلى موقع نفس الجريدة بالإنكليزية حذر فيه من الإقدام على الضم قائلا، إن هذا يتعارض مع الإجماع العربي والدولي، وأن خطوة مثل هذه ستؤجج العنف في المنطقة وتهدد الأردن الذي طالما حرصت المنطقة على استقراره وبما في ذلك أيضا من مصلحة لإسرائيل. وأضاف، إن الضم سيوقف أي تقدم في العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الدول العربية بما في ذلك العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.
ومن الواضح أن أحدا ما في فريق كوشنير أو مستشارا له التقط الإمكانية الموجودة ضمنا في هذه المقالة، أي «إنقاذ» الجزء المتعلق بالتطبيع في الخطة عن طريق استبدال المسار السياسي مع الفلسطينيين، بإيقاف الضم مقابل التطبيع مع دولة الإمارات، على أن تتبعها تدريجيا دول عربية أخرى. وقد بدا هذا التعديل جذابا لأنه يحقق ثلاثة أغراض: إنقاذ ذلك الجزء من الخطة المتعلق بالتطبيع إزاء فشل الجزء المتعلق بالمسار السياسي بسبب صلابة الموقف الفلسطيني، وتقديم العذر «المقبول» داخليا لتخلي نتنياهو عن إعلانه المتعلق بالضم، وتسجيل «نجاح» لترامب في السياسة الخارجية التي لا يوجد فيها نجاحات تذكر حتى الآن، حتى لو أن ذلك لن يسعفه كثيرا في الانتخابات نظرا لأن القضايا الداخلية هي في العادة التي تؤثر على نتائجها، باستثناء بعض الأوساط مثل الإنجيليين المسيحيين واللوبي الصهيوني الذي كان أصلا مؤيدا له.
ولعل ما حصل عشية الإعلان عن بدء مسار التطبيع بين إسرائيل والإمارات فيه أكثر من عبرة. ذلك أن نص الإعلان المشترك للولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات جاءت فيه العبارة المحورية التالية: «إن إسرائيل ستعلق إعلان السيادة على المناطق المحددة في رؤية الرئيس للسلام». لكن النص لم يحدد ما إذا كان «التعليق» مؤقتا أم مستمرا ودائما. أيضا، وما هو أهم، لم يقل النص أنه سيجري تعليق الضم، وإنما تعليق الإعلان عن السيادة على هذه المناطق. والفارق هو أن إسرائيل عندما تبني المستوطنات التي توافق عليها الحكومة، هي «تضم» هذه المناطق لها من ناحية فعلية، وموقفها معروف منذ مدة، أي أنها لن تتخلى عنها. بالتالي، الإعلان عن إيقاف الضم قد يفهم على انه إعلان عن إيقاف الاستيطان. بينما إعلان السيادة يعني ضمها لدولة إسرائيل من منظور القانون الإسرائيلي.
المهم هو، أن نتنياهو سارع للقول في مؤتمره الصحافي الذي عقد عشية الإعلان أن هذا الامتناع عن إعلان السيادة مؤقت وما زال ضمن برنامجه. وأيد هذا الكلام سفير الولايات المتحدة في إسرائيل في تصريح له في اليوم التالي. هذا بينما كانت وسائل إعلام الإمارات تتحدث عن إيقاف الضم وكأنه نهائي وعلى أنه إنجاز كبير للفلسطينيين، فقامت إسرائيل بسكب الماء البارد على موقف الإمارات ولم تأبه بتوفير حتى ورقة تين لحفظ ماء الوجه. بالتالي، العبرة هي أن إسرائيل لا تكن أي احترام للمطبعين وتتصرف وكأن بعض الدول العربية تحتاج التطبيع أكثر مما تحتاجه إسرائيل. وهذا يثير أسئلة كثيرة عن طبيعة هذه الدول وعن سيادتها وتبعيتها وعن مقومات وجودها كدول.
نشرت هذه المقالة في جريدة الأيام بتاريخ 16 أغسطس 2020.