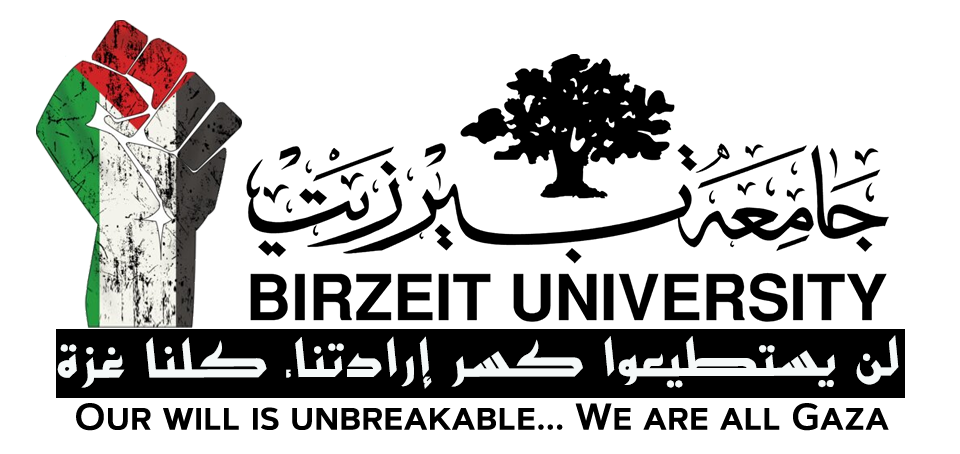قرأت بمزيد من التروي والتمعن مقال الأستاذ يونس العموري حول الأزمة الحالية في جامعة بيرزيت. لقد سبق لي وأن قرأت للأستاذ العموري مقالات عديدة على صفحات جريدة القدس واحترمت فيها ما يتطرق إليه من مواضيع عن هموم الوطن. ولكنني للأسف وجدت في مقالته عن جامعة بيرزيت تخبطا وابتعادا كليا عن الموضوعية من حيث إلقاء الكلام والأحكام جزافا بدون سندٍ وبدون أبسط المعلومات، كما أنه ابتعد عن المسؤولية الوطنية الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها كل من يتصدى لتناول الشأن العام والهم الوطني خاصة في هذه الظروف. فجاءت مقالته مليئة بالتحريض وكاد أن يدعو إلى الانقضاض على جامعة بيرزيت على اعتبار أنها انحرفت عن دورها كمؤسسة وطنية وأصبحت مشروعا تجاريا ربحيا تتحكم به عائلة إقطاعية برجوازية ما من هدف لها سوى استغلال طلابها بأبشع الطرق. إن الخطأ الأكبر الذي وقع به الأستاذ العموري عندما قرر،هكذا، أن السؤال الأساسي وراء الأزمة المالية الحالية لجامعة بيرزيت إنما هو أزمة هوية الجامعة وماهيتها. هل هي جامعة وطنية تقوم بالأساس على خدمة المسيرة التعليمية الوطنية أم أنها شركة بمعنى البزنس والربح وتسيطر عليها النزعة العائلية الإقطاعية المتحالفة مع الطبقة المخملية في البلد وتهدف إلى تحديد روادها من خلال انتمائها الطبقي؟ إنني أعتقد أن أسوأ ما في هذا الطرح هو أنه إهانة لطلبة جامعة بيرزيت الذين أسماهم بروّادها وكأن الجامعة مقهى وطلابها رواد لهذا المقهى. لا يا أستاذ عموري، إن الأغلبية الساحقة من طلبة جامعة بيرزيت (بل والجامعات الفلسطينية عموما) هم من أبناء هذا الشعب المقهور تحت الاحتلال. لم تنشأ جامعة بيرزيت كأول جامعة في فلسطين، ثم تلتها سلسلة الجامعات الفلسطينية الأخرى إلا لتوفر فرصة التعليم الجامعي لمن لا تمكنه ظروفه المادية أو ظروف أخرى كقيود الاحتلال من تلقي هذا التعليم خارج الوطن. وفي حينها أدركت منظمة م.ت.ف (عندما كانت م.ت.ف في عز مجدها) عمق الرؤيا والخطوة الاستراتيجية لمبادرة إنشاء جامعة بيرزيت والتي أصبحت بحق حاضنة الحركة الوطنية. فكانت هدفا مباشرا للاحتلال وسياساته تجاه شعبنا، وكانت بحق جامعة الشهداء والمعتقلين والمبعدين، وأصبحت ليست فقط جامعة شرف الطيبي ومروان البرغوثي بل جامعة كل هذه الأجيال من الخريجين الذين يعتز بهم الوطن والذين يملأونه طولا وعرضا بل ويملأون بلدانا عربية وعالمية أيضا. لا يا أستاذ عموري، جامعة بيرزيت ليست بدون هوية حتى تصبح أزمتها أزمة هوية وماهية. ثم ما الخلل وما العيب في أن يبادر شخص أو عائلة أو مجموعة من المواطنين لإقامة أو رعاية مشروع تنموي أو تعليمي لا يهدف إلى الربح الشخصي، وينسجم مع احتياجات وطموحات وتطلعات شعبنا. هل أصبحت مبادرات من هذا النوع تهمة؟ هل يجوز لنا مثلا أن نتهم السيد صبيح المصري عندما أنشأ جامعة النجاح الوطنية في نابلس أو نتهم عائلة الجعبري عندما رعوا إنشاء جامعة الخليل بأنهم أنشأوا جامعات ذات هوية ربحية إقطاعية برجوازية .. إلخ.؟ إن الحكم على أية مبادرة تنموية سواء تعليمية أو صحية أو غيرها يجب أن ينطلق أولا من تفهم أو دراسة هذه المبادرة وهل هي منسجمة مع احتياجات وتطلعات وطموحات شعبنا خاصة ونحن تحت أطول احتلال في العصر الحديث. والمعيار الثاني للحكم هو دوافع هذه المبادرات هل هي دوافع تنطلق من الإيمان بدور العمل الأهلي والمجتمع المدني في الاستجابة لاحتياجات وطموحات شعبنا أم هي دوافع ربحية بحتة؟ علما بأن وجود دوافع ربحية لا يضير الكثير من المبادرات سواء كانت جامعات محلية أو عالمية مرموقة هي في الأساس مشاريع ربحية لكنها تصب في سياق احتياجات وتطلعات وطنية. وهناك معيار ثالث يتعلق بالمنتوج ونوعية هذا المنتوج، أيُ نوع من الخريجين ومدى جودة التعليم وجدواه للمجتمع وسد احتياجاته. ولدينا المئات والألوف من المبادرات الأهلية غير الربحية في كافة المجالات التنموية والتي لولاها لما تمكنت قطاعات واسعة من شعبنا من الصمود أمام كل العسف الإسرائيلي. فتساؤل الأستاذ العموري عن هوية وماهية جامعة بيرزيت تساؤل خاطئ ولا مبرر لطرحه لأن هوية جامعة بيرزيت كباقي جامعاتنا الأهلية هوية واضحة ومحسومة. ولا أسمح لنفسي هنا بأن أقول للأستاذ العموري إن دوافعه من طرح هذا التساؤل هي أيضا دوافع خاطئة، بل أدعوه بكل صدق إلى أن يراجع معلوماته ويتحقق من طروحاته وإنني على أتم الاستعداد لمرافقته في زيارة للجامعة بعد أن تفتح أبوابها للاطلاع على واقع جامعة بيرزيت وملامسة هويتها الأصيلة علما بأنه لم يبدِ أسفه ورفضه لإغلاق الجامعة بالجنازير أسوة بما عبر عنه الرئيس أبو مازن قبل أيام حين أبدى رفضه لإغلاق الجامعة ودعا للبدء في الحوار. وبعيدا عن المحاولة غير الموفقة للأستاذ العموري لفهم أزمة جامعة بيرزيت وإذا ما أردنا أن نقارب جوهر الأزمة التي تعاني منها جامعة بيرزيت وبقية جامعاتنا الوطنية والتعليم العالي في فلسطين عموما فلا بد من طرح الوقائع التالية: إن التعليم، تماما كالصحة، هو حق أساسي من حقوق الإنسان، كما أن التعليم العالي أيضا حق من حقوق الإنسان لمن يحتاجه ويسعى لتحصيله. ولا يجوز حرمان أي طالب من حقه في السعي للتعليم العالي بسبب وضعه الاجتماعي وعدم قدرته المادية. وكأي حق من حقوق الإنسان هناك طرفان: صاحب هذا الحق الذي يطالب به ويجب أن يتمتع به من جهة، والمسؤول عن إنفاذ هذا الحق من جهة أخرى وهي الدولة. إن أغلب مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية هي مؤسسات أهلية غير ربحية، وتقدم خدمة التعليم العالي نيابة عن الدولة وبدعم منها. في الواقع الحالي للجامعات يشكل القسط الجامعي 60% من التكلفة الحقيقية. أي أن القسط الجامعي مدعوم لجميع الطلبة مقتدرين وغير مقتدرين بما نسبته 40% من التكلفة. وهذا الدعم يأتي إما مباشرة من ميزانية السلطة أو من مساعدات من خارج هذه الميزانية على شكل تبرعات من القطاع الخاص أو مؤسسات عربية أو دولية تتكفل بأقساط ومنح للطلبة غير المقتدرين أو المتميزين أو كليهما. للأسف الشديد إن التزامات السلطة الوطنية تجاه الجامعات لا يتم الإيفاء بها بانتظام وجزئيا في أغلب الأحيان مما ينجم عنه عجز متواصل ومتراكم في ميزانيات الجامعات. حاجة الجامعات إلى رفع الأقساط بين حين وآخر تنبع أولا من حاجتها لسد العجز الناتج عن تقصير السلطة في أداء التزاماتها. وبعد أن تقوم الجامعات بمحاولة سد هذا العجز من مصادر أخرى. كما تأتي هذه الحاجة ثانيا من ارتفاع تكاليف ونفقات الجامعات فهناك زيادة طبيعية متواصلة في فاتورة الرواتب لكوادر الأساتذة والموظفين والعاملين، بالإضافة إلى الاحتياجات التطويرية سواء في البنية التحتية أو الأجهزة والمختبرات، أو لاستقطاب كفاءات أكاديمية مطلوبة خاصة إذا كان طموحنا رفع جودة التعليم بشكل متواصل. فهل يعقل أن نرى الأسعار من حولنا ترتفع باستمرار على كل بند من بنود حياتنا ولا نتوقع ولا نريد أن نقبل أن يرتفع القسط الجامعي بنسبة 10% مثلا طالما لا توجد جهة على استعداد لأن تسد العجز والاحتياجات المتزايدة؟ وأولى هذه الجهات طبعا هي السلطة الوطنية وميزانيتها. ثم هناك سبب آخر للعجز ويتعلق بتثبيت سعر الدينار بـِ 5.6 شيكل والذي بُدِئ العمل به قبل عدة سنوات إثر أزمة بين الجامعات ونقابات العاملين فيها بسبب تآكل الرواتب نتيجة تدهور سعر الدينار وغلاء المعيشة. فكان الاتفاق حينها أن تم تثبيت سعر صرف الدينار على هذا النحو ونظرا لأن ذلك لم يشمل في حينه تثبيت سعر صرف الدينار بالنسبة للأقساط أيضا وليس بالنسبة للرواتب فقط، فقد تسبب هذا في نزيف متواصل أضيف إلى العجز المذكور أعلاه. فالجامعات أصبحت تقبض القسط من الطالب بسعر السوق للدينار بينما تدفع الراتب بسعر أعلى وثابت بالدينار. وهذا الفرق يشكل فعلا نزيفا شهريا أو فصليا. إن السؤال المطروح هنا خاصة مع وصول حكومة جديدة، ولحسن الطالع أن يرأسها أكاديمي تولى رئاسة جامعة النجاح الوطنية لسنوات طويلة ومطلع على أزمة الجامعات بكل تفاصيلها ومن ألفها إلى يائها، يصبح السؤال المطروح بإلحاح هو إعادة النظر بكيفية توزيع بنود الميزانية كي يحصل التعليم (كما الصحة والزراعة والشؤون الاجتماعية) على النصيب الكبير الذي يستحقه من الميزانية. فلا يعقل أن تستمر في تخصيص 30 – 35% من الميزانية على الأمن! والمفارقة الصارخة هنا أن الدول المانحة (وهي مانحة مجازا) تفرض علينا إنفاق 30 – 35% على الأمن ونحن تحت الاحتلال ثم تريدنا أن نكون دولة منزوعة السلاح عندما ننال الاستقلال. إن من أهم القيم التي اكتسبناها كمجتمع فلسطيني خاصة في العقود الأولى من الاحتلال وتجلت بأروع صورها أثناء الانتفاضة الأولى هي قيمة التكافل الاجتماعي التي تراجعت للأسف الشديد بعد اتفاقات أوسلو وتداعياتها الاقتصادية وإنشاء السلطة الوطنية.nbsp;ما المانع الأخلاقي والوطني من أن يتحمل المقتدرون فقط من الطلبة زيادة في القسط بـِ 10% مثلا طالما أنهم مقتدرون كي تتمكن الجامعات من إعفاء غير المقتدرين من هذه الزيادة في القسط، إعفاؤهم أيضا من كامل القسط أو جزء منه حسبما تقتضيه الحالة الاجتماعية للطالب وبناء على مسح اجتماعي. إذا كان من واجب الجامعة ومن حق الطالب غير المقتدر أن يتمتع بإعفاءات مختلفة من القسط الجامعي، بأي مبرر أخلاقي أو وطني أن تشمل الإعفاءات أيضا من هم متقدرون عن دفع القسط كاملا خاصة وأن القسط كما ذكرت سابقا لا يشكل إلا 60% من التكلفة الحقيقية، وعلما أن تكلفة الدراسة الجامعية خارج الوطن هي أضعاف تكلفتها في الجامعات المحلية. أمام كل ما سبق يصبح السؤال الحقيقي ذو شقين: أولا، كيف نحل الأزمة المالية المستحكمة بالجامعات وتعصف بها بين حين وآخر وتكاد تودي بها وبمستوى أدائها؟ وثانيا كيف نرفع جودة التعليم العالي (والتعليم عموما) ولا نكتفي فقط بوقف تدهور مستواه؟ من هنا ضرورة المبادرة سريعا وبرعاية رئيس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والمالية إلى عقد مؤتمر وطني تتمثل فيه كل أطراف التعليم العالي، وأولها الحركة الطلابية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وعن المجتمع عموما لطرح خطوات عملية لإنقاذ التعليم العالي في فلسطين قبل فوات الأوان، لماذا لا نفكر مثلا بإضافة شيكل واحد على كل فاتورة كهرباء أو ماء أو تلفون أو جوال؟ هل يجوز أن نصمت على الغلاء الفادح في الأسعار في كل بند من احتياجاتنا اليومية دون أن نحرك ساكنا، بينما نثور على جامعاتنا بسبب زيادة 10% على القسط الجامعي ينطبق على المقتدرين من الطلبة فقط؟nbsp;كما أن على المؤتمر أن يضع الوسائل التي تضمن تغذية وتوسيع صناديق إقراض الطلبة، كما أن على القطاع الخاص أن يضاعف من حجم صناديق مسؤولياته المجتمعية. هناك خطط كثيرة يجب أن تلجأ إليها الجامعات لتعزيز قنوات وآليات التواصل والحوار المستمر ما بين إداراتها وموظفيها وطلبتها، مما يعزز التفاعل بين أطراف العملية التعليمية كأسرة واحدة يتم حل النزاعات، التي لا بد وأن تحصل بحكم طبيعة الأمور، بالحوار الديمقراطي وبالشفافية وبالمساءلة. ولا يجوز الانزلاق إلى التعاطي مع أي نزاع بين هذه الأطراف وكأنه تحد أو صراع إرادات يجب أن يتغلب فيه طرف على الآخر، أو أن يحطم طرف إرادة الطرف الآخر. وفي هذا السياق يجب علينا تحريم، بل وتجريم اللجوء إلى إغلاق جامعاتنا بالعنف. وأخيرا وليس آخرا، هناك مبادرتان من كل من وزارة التعليم العالي ومن نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت وكلاهما تتمتعان بقسط كبير من العقلانية والتوازن وقد وافقت أو رحبت بهما ادارة الجامعة، فماذا ننتظر حتى نفتح أبواب الجامعة ونبدأ الحوار المطلوب؟ nbsp; د. ممدوح العكرمفوض/الهيئة المستقلة لحقوق الإنسانعضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت
دفاعا عن جامعة بيرزيت.. دفاعا عن جامعاتنا الوطنية
الآراء الواردة في المدونة تعبر عن رأي كتابها، وليس بالضرورة عن رأي الجامعة.