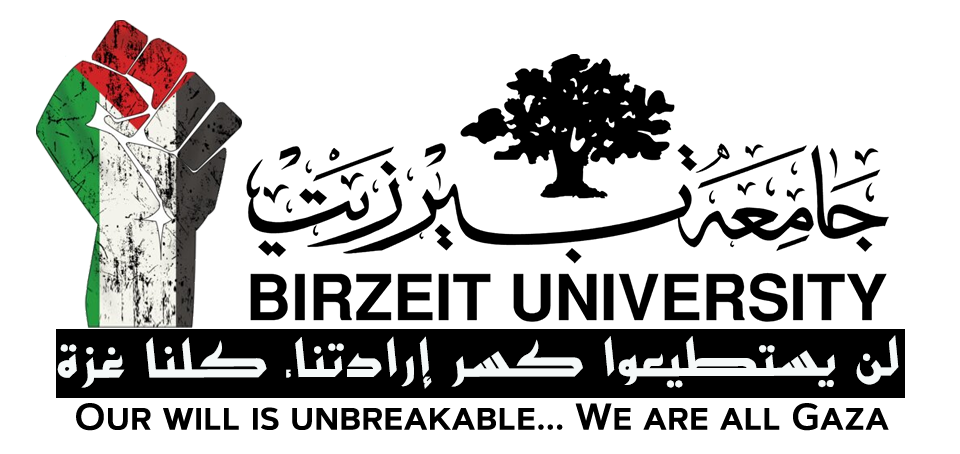nbsp;ما يحصل في جامعة بيرزيت منذ أسابيع ليس مفاجئا كونه يأتي في سياق حالة عامة من التشنج تمر بها البلاد منذ أمد وفي جميع المجالات، رغم الإنجازات التنموية النوعية التي أشرفت على تحقيقها الحكومات المتعاقبة. ويصاحب حالة التشنج هذه تزايد ملفت في وتيرة القهر والتذمر والغضب لدى قطاعات واسعة من الناس، يتحول أحيانا الى صراع الكل ضد الكل، كما يقول توماس هوبس، يهدف كل طرف الى شطب الطرف الآخر عوضا عن التعايش معه على قاعدة ما هو مشترك. اليوم، الكل يستوطنه التوتر والقلق وغياب اليقين، بدءا بالرئيس عباس وانتهاء ببائع المناديل الورقية على أرصفة الطرقات. الجميع غاضب على يجد نفسه به من عجز في تحقيق ما هو مرغوب، فيلقي باللوم على الآخرين ويرى بهم سببا لفشله. وقد قاد هذا الحال الى تقسيم البلاد والعباد وحوّل الوطن الى مساحة من الأسلاك الشائكة والمواطن إلى شيء مستنزف تنهشه البنوك وتتجبّر به السلطة السياسية. السلطة السياسية لدينا هي برأسين واحد يطل من رام الله والآخر من غزة، وهما يتشابهان بفقدانهما القدرة على الإحساس؛ هما هنا لتحقيق كل الأهداف والغايات ما عدا الحرص على كرامة المواطن التي تطحنها البنوك والمصارف وأجهزة الأمن. أمام هذا الحال يتنفس الإسرائيلي المحتل الصعدا! هذا القهر المركب (قهر الإحتلال ورأسيْ السلطة) هو مَن يُنتج التوتر والغضب الذي ينتشر في كل مكان والذي نراه في الشارع والمدرسة والجامعة والمسجد وفي الوزارة والبلدية وفي النادي والنقابة والجمعية وفي الشركة والبنك والمصرف وحتى في السجون. في هذا الوطن الشائك تًصبح حِدّة الأنياب وقوة المخالب وصلابة القرون أعظم أهمية من قوة المنطق والبصيرة والتأمل. هذا هو السياق الذي يمكن عبره فهم الأزمة التي تعصف بجامعة بير زيت. إغلاق الجامعة و جنزرة أبوابها وتحويل مداخلها إلى ثكنة من غضب وتعطيل العملية التعليمية وإلحاق خسائر مادية ومعنوية فادحة هو ليس السبيل الأوحد لتسوية الخلاف بين إدارة الجامعة والطلبة. المشترك بينهما أهم بكثير من أن يُضَحّى به عبر اللجوء للعنف. الإدارة مُحقة عندما تقول انها تعيش وضعا ماليا صعبا يستدعي اتخاذ تدابير مختلفة لمواجهة ذلك الوضع بما في ذلك ربط الدينار بالشيكل (بسبب تآكل قيمة الأول) أو حتى اللجوء الى رفع الأقساط بنسبة ما، تماشيا مع ازدياد كلفة التعليم الجامعي في كل مكان. والطلبة أيضا بدورهم محقون بأنهم (وأسرهم) يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة تحول دون تمكّنهم من دفع أي زيادة مالية مهما كان مبررها. أمام هذا الحال لا بد من طرح الأسئلة التالية: أين هو دور السلطة التي تشرف على إنفاق مليارات الدولارات سنويا؟ اين هو دور القطاع الخاص الذي تُسجِّل شركاته معدلات ربح طائلة (شركتي الإتصلات الخليوية مثلا) في بلد ما زال منكوباً؟ لماذا لا نراه يُوظّف روح الإبداع entrepreneurship) ) لديه لوقف انهيار قطاعي التعليم والصحة، بينما نراه يُبدع في انشاء المستوطنات (كروابي مثلا) وفي دعم فوز محمد عساف؟ أين موقعه من المسؤولية الإجتماعية تجاه الإجيال القادمة؟ الا يُلحق الضرر بنفسه عندما يُهمل التعليم كونه المستفيد الأول منه؟ بدون الدعم الحقيقي والدائم للجامعات من السلطة والقطاع الخاص، كيف يمكن للجامعة ان تستمر بعملها (تدريس الطلبة)؟ إن لم تستطع الجامعة توفير الموارد، أليس الطالب هو المتضرر الأول من انحدار مستوى التعليم في الجامعة ومن صعوبة العثور على عمل أو على فرص لاستكمال الدراسات العليا بسبب ذلك الإنحدار؟ في حالة قبوله بهذا الحال ألا يكون الطالب كمن يطلق الرصاص على قدميه؟ لماذ الإعتراض على ارتفاع كلفة التعليم الجامعي دون سواه مع ان تكلفة الخدمات الأخرى كالوقود والغذاء والمسكن والطبابة والاتصالات ... وغيرها) في ارتفاع دائم؟ هل لدى الطلبة الإدراك والعزيمة للتصدي لارتفاع كلفة تلك الخدمات أيضا؟ هل سيتصدون لذلك بذات الوسيلة العنيفة التي تم اللجوء لها مع إدارة جامعة بيرزيت؟ الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ليس بالأمر السهل لكن يمكن استشرافها من ثنايا المعطيات التالية: إن أولوية السلطة من حيث الإنفاق والإهتمام والرعاية هي للأمن ولمخصصات وامتيازات الرسميين؛ ان خطط التنمية الراهنة لا تأخذ بالإعتبار جوهر حق المواطن (بما في ذلك الطالب) وكرامته الإنسانية؛ أن البلد برمته اليوم هو بقبضة أثرياء الأزمات - أزمات الحرب وأزمات السلام - وشركاتهم القابضة (القابضة على أقوات وأرواح الناس)؛ ان إنارة مداخل المدن والضواحي وتزيين أرصفتها ووضع يافطات شكر شعب الولايات المتحدة هو أهم بكثير من دعم المؤسسات التي تُنير القلوب وتوقد العقول؛ الاهتمام اليوم هو بالإقتراض من البنوك وبقضايا تفريغية كحالة محمد عساف وإنتاج أكبر أطباق الكنافة والمفتول والمسخن، وليس بقضايا الفقر والبطالة والفساد وهدر المال العام والمديونية المتصاعدة وبؤس الخدمات الصحية وتلف الأغذية والأدوية وإفلاس الجامعات. ربما ستجد الازمة الراهنة في جامعة بير زيت حلا لها في القادم من الأيام، وعلى الأرجح أن يكون الحل تخديريا، لكن جذور الأزمة ستبقى فهي عميقة وتُنذر بما هو اسوأ في السنوات القادمة، فهناك ألغام كثيرة تستبطن مسيرة الجامعات ككل، الأمر الذي تستوجب تخطيطا سليما لتأمين الموارد المادية والمعنوية اللازمة لإنقاذ هذه الصروح التي فشل الإحتلال بكل جبروته في تركيعها وكسر شوكتها عبر السنين.nbsp;
محاولة لفهم ما يجري في جامعة بيرزيت
الآراء الواردة في المدونة تعبر عن رأي كتابها، وليس بالضرورة عن رأي الجامعة.