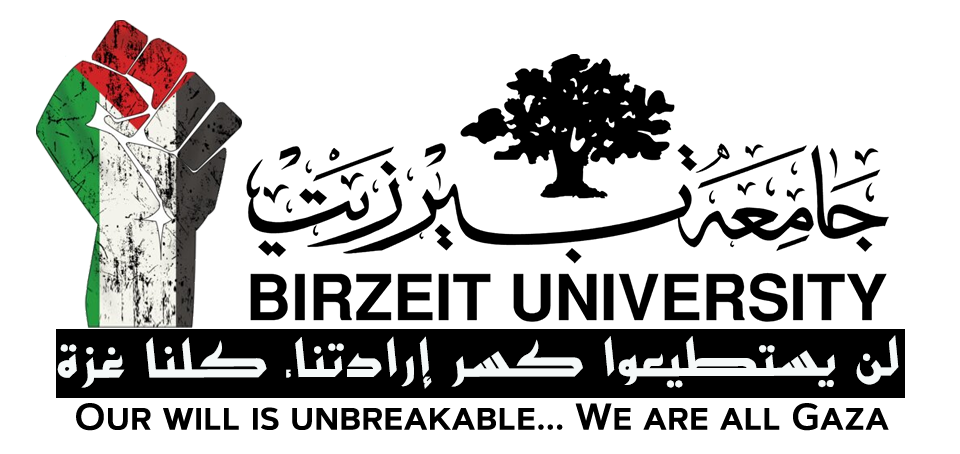مضت رفاته في شوارع المدينة في السابع والعشرين من هذا التموز الفلسطينيّ الحزين والأبيّ، بينما لا تزال تتردد كلماته، أستاذي السابق وزميلي وحبيبنا الدكتور تيسير العاروري وأحد مؤسسي «حزب الشعب» الفلسطيني وقادته، تروي عن ضرورة كتابة جوانب عدّة منسيّة من تاريخ فلسطين. في لقاءٍ مطوّلٍ عذبٍ دار بيني وبينه قبل ثلاثة أشهرٍ، حدّثني عن رغبته بالتفرّغ بشكلٍ كامل لكتابة أجزاء من القضية التي عرفها وعايشها.
في الثالث من أيار من 2016 في مقهى «قمح» في حيّ الطيرة في رام الله، كان لقائي مع د. تيسير العاروري، أقصد مع «أحمد حسن». لا يزال نصّ مقابلة الساعات الثلاث مفتوحاً على جهازي، فقد علّمت بالأصفر كلّ ما أحببته فيها.. معظمها يبدو لي بالأصفر. يقولون أننا عند الموت نصبح «نستالجيون»، ولكن نستالجيتي مع تيسير كانت منذ ذهبت إلى البيت وقرأت ما قد سجلته بصوته. كان لقاء راقياً ومفعماً..
«تعليم عالٍ ونقدي وثوري ومتحدٍّ»
علمني تيسير «مختبرات فيزياء» في بيرزيت خلال العام الدراسي 1994 – 1995، قبل أن أحوّل تخصصي للدراسات الإجتماعية. وكان لقاؤنا الثاني قبل ثلاثة أشهر. أنا لا أعرف تيسير جيداً، ولم يكن صديقي قبل المقابلة، وأصبح عزيزاً عليّ بعدها. فالأفكار والأهداف تؤلف القلوب والأذهان.
بدأت المقابلة بالحديث عن التعليم في فلسطين تحت الاحتلال، وتفرّعت نحو فكره ومسيرته والحركة الوطنية. تحدّث بروحٍ واقعية عن إبعاده وسجنه. لم أسمع منه أيّ أسفٍ على الماضي، بل صلابة ولين في الروح يفرضان على من يجالسه الإحترام والحب. والأكثر تاثيراً عليّ كان حديثه عن التعليم وأهميته للقضية: «... لو لم يكن لدينا هذا المستوى من التعليم وهذا العدد المعقول من المتعلمين والمثقفين الفلسطينيين من أيام الانتداب، بالتأكيد كان مصيرنا راح يكون مثل الهنود الحمر. كنا اتشتتنا وما عاد في شيء اسمه فلسطين. بالتالي، إحياء القضية الفلسطينية أساسه وجود هذه المجموعة المعقولة من المتعلمين والمثقفين».
في قلبه، هو مدرّسٌ ومعلّمٌ حتى الصميم، ولديه إيمان بأن حلّ الصراع لن يكون إلا بمستوى تعليمٍ فلسطينيّ عال ونقدي وثوري ومتحدّ. روى لي قصصاً عدة أجد صعوبة في انتقاء ما أرويه منها. حدّثني عن مساعدة غابي برامكي له، وهو طالب في سنة أولى فيزياء في «جامعة بيرزيت» التي كان قسطها في 1970 حوالي 130 ديناراً، ما يفوق دخل والده الشهري بأربعة أضعاف حسبما قال. فقد ساعده غابي على إكمال السنة الأولى بعشرة دنانير تسجيل فقط، كان قد أخذها من والده: «أصلاً، إحنا كان معنا طلاب من إلي في هديك الأيام كان معهم سيارات، شوفي التعليم أديش مهم. عشان أعوض أني إبن فلاح صرت أعملّهم دروس مجانية بعد الدوام للي بده أساعده». كان يتحدّث بروح الفخر كطالبٍ متفوقٍ وفقيرٍ، وبفخرٍ عن «بيرزيت» كجامعة وادارة.
بعد السنة الأولى في «بيرزيت»، سأله سليمان النجاب (أحد أبرز قيادات «الحزب الشيوعي») عمّا إذا كان يرغب بالذهاب إلى المدرسة الحزبية في موسكو لمدة سنتين بغرض دراسة الفلسفة والاقتصاد قبل أن يدرس الفيزياء، وقد كان الالتحاق بالمدرسة سرياً حينها، ويتطلب تغييراً في هوية الشخص. ومن هنا، أعطي لتيسير إسم «أحمد حسن». ابتسم بفرح وخفة حين لفظه، كشيءٍ لمس فؤاده. تغيير الإسم مكّن تيسير من الذهاب إلى سوريا عند اندلاع حرب 1967، بحسب توصيات فؤاد قسيس (عضو اللجنة المركزية في «حزب الشعب» الفلسطيني)، ليعود إلى موسكو كطالبٍ جديدٍ يبغى دراسة الفيزياء، وباسم تيسير العاروري! كنت أستمع إليه يروي، ويعود فيقول لي: «لنعد الى موضوعنا عن التعليم»، بينما أشعر أنا بأن كلّ ما يقوله هو موضوعي وموضوعنا!
الفاعل والمبتسم!
قصة تيسير مع سجنه في 1974 لمدة أربع سنوات ومع الإبعاد في 1988، هي مثالٌ حيّ على محاولة الإحتلال الإسرائيلي احتلال العقول الفلسطينية بعد إحتلال الأرض. تعامل تيسير بواقعية مع تجربة الإبعاد، بكلّ تداعياتها المرعبة على حياته! فقد روى لي بكل فخر عن العملية اليتيمة (على حدّ تعبيره) لـ «الجبهة الوطنية» (مكونة من شيوعيين و «فتح» والجبهتين «الشعبية» و «الديمقراطية»، لإدارة الشؤون المحلية) في 1974 ضد «بنك لؤمي» الإسرائيلي. نفذتها الخلية العسكرية في الجبهة، باستخدام الأدوات الحادّة من دون أسلحة، وتم قتل الجنود الاسرائيليين الذين كانوا يحرسون البنك، وسرقة أسلحتهم. تيسير كان قد عاد إلى الوطن في 1973 حاملاً شهادة الماجستير بالفيزياء، وبدأ التدريس في «جامعة بيرزيت» بطلب من الدكتور حنا ناصر، ولم تكن له علاقة بالجناح العسكري للجبهة. ولكن إسرائيل شنّت حملة اعتقالات شملته ليسجن أربع سنوات في الحبس الاداري بلا محاكمة وبلا تهمة. بعد سنتين ونصف السنة، تغيّر مدير السجن واستجاب نائبه لطلب تيسير بأن يخبره عن سبب اعتقاله، فاجابه: «هم بفكروا إنك كنت تفكر تعمل إشي ضد إسرائيل». ضحك تيسير بتباهٍ حين قالها، وأعتقد أنه أراد أن يقول أنهم يخافون من «عدم الفعل» أكثر من الفعل نفسه! وظلّ ما يجول في خاطر تيسير وتخيلاته يؤرق الإحتلال، لينفوه بعد اندلاع الانتفاضة الاولى في 1987 لمدة خمس سنوات على الأرضية ذاتها التي توقظ الهاجس الاسرائيلي تجاه الفلسطيني الصامد، أي: الفاعل والمبتسم!
تحدّث تيسير إليّ عن الذات الفلسطينية الجمعية والفاعلة، وعن دور القيادات المحلية في عدّة قضايا، مثل «كامب ديفيد» والعمل التطوعي. «بيرزيت» كانت محوراً أساسياً في الحديث، فاستذكر تيسير العمل النقابي القوي الى جانب إدارة الجامعة، ودورها في التصدي للقرار العسكري رقم 854 القاضي باخضاع الجامعات للاحكام العسكرية، إلخ. كان واضحاً بأطروحاته حول كيفية تحسين التعليم في جامعاتنا، ولكن هذه المقالة ليست المكان المناسب للتوسع في هذا الموضوع.
هذه المقالة التي تؤبنك هي دعوة لكتابة المذكرات الشخصية لمن عاصروا مراحل حياة هذا الشعب، وهي دعوة لاستكمال كتابة التاريخ الفلسطيني، خاصة بعد النكبة ومع وصول السلطة: فـ «مَن يكتب الرواية، يرث أرضها». هناك عملٌ طويلٌ وحثيثٌ ينتظر الأكاديميين/ات الفلسطينيين /ات، وواجبٌ وطنيّ على
جامعاتنا، وخاصةً البرامج المعنية. فضياع «الحلّ» السياسي ترك ربما المتسع للتوثيق وأتاح بدايةً جديةً لجمع شتاتنا الأكاديمي هنا في الوطن المحتل. هي دعوةٌ للصمود الفاعل الباسم!
وداعاً تيسير، ولنا لقاء.. في كتابٍ ما، في ٍقصة ما، في محاضرةٍ ما، في حديثٍ حميمٍ بين الأصدقاء، وفي ابتسامةٍ «كرملية» ما!
نشر هذا المقال في جريدة السفير بتاريخ 2016-08-08.