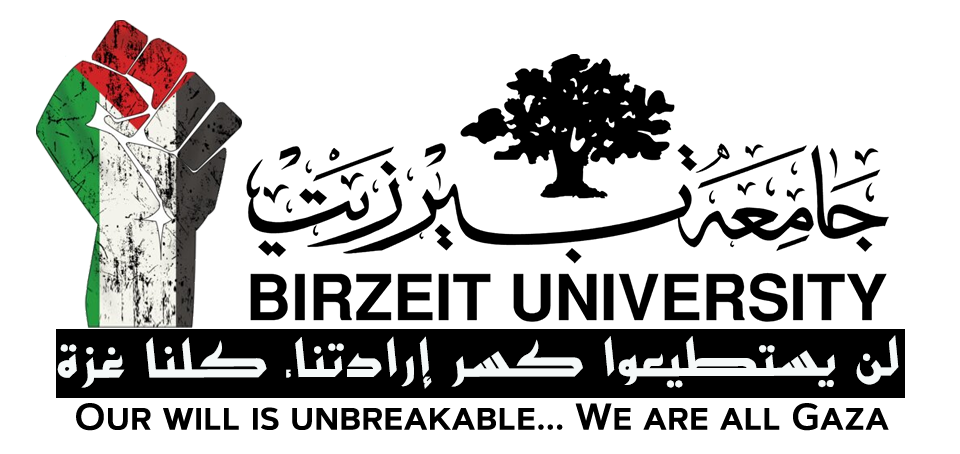موضوع التعليم الجامعي يعتبر بين أهم المواضيع التي يدور حولها الكثير من الكتابات والتعليقات والتنبئات, ذلك أن هذا الموضوع مرتبط بمصالح ورؤى قطاعات وشرائح متعددة داخل المجتمعات وتتداخل فيه عناصر الإقتصاد والسياسة والثقافة وغيرها من ثوابت ومتغيرات غير محكومة بالمعطيات المحلية فحسب. على سبيل المثال فقد كتب الكثير خلال العقد الأخير عن المستقبل اللامع الذي ينتظر التعليم عن بعد وعن الحيز الكبير الذي يتوجب منحه لمصادر التعليم الإلكتروني, وانتشر عبر الإنترنت ما يعرف بالإنجليزية ب MOOC وهي مواقع تحوي مواد مكتوبة, مواد مصورة, مسائل وتمارين, بالإضافة إلى ملتقيات إفتراضية للنقاش وتبادل المعلومات. وقد ذهب بعض الأختصاصيين للقول بأن عولمة التعليم ستؤدي إلى إختفاء التعليم العالي بصورته التقليدية خلال عقد أو إثنين, وفي المركز من ذلك التوقعات بإنحسار الحاجة إلى الحرم الجامعي بأبنيته وساحاته المحددة جغرافياً لصالح التوسع اللامحدود لإنتشار التعليم عبر الفضاء الإفتراضي.على الرغم من كل ما قيل وكتب على هذا الصعيد فإن الواقع لا يبدو منسحباً على التوقعات كما كان منتظراً, على الأقل حالياً, إذ لا زال الحرم الجامعي يحتفظ ببريقه ولا زالت قلوب طلبة الثانوية تتوق إليه.
يمكن ربما النظر لجاذبية الحرم الجامعي كإنعكاس لقوة تأثير عامل التواصل الإنساني المباشر سواء فيما بين الطلبة أو بين الطلبة وأساتذتهم, ولكن من باب الإستدراك يجدر القول بأن الحال في واقعنا المحلي ليس هكذا تماما, فمع محدودية إمكانيات التعليم من خارج الحرم الجامعي يمكن تفسير التقيد المكاني بأبنية الجامعة كتعبير عن محدودية الخيار.إلا أن عدم انسحاب الواقع بالكامل على التوقعات لا يجب أن يسمح بإغفال الأهمية التي باتت تحتلها المصادر الإلكترونية للتعليم. فخلال العقدين الأخيرين حدثت في العملية التعليمية تغييرات هامة على صعيد الآليات والأهداف والجمهور وكان للتكنولوجيا دور أساسي فيها. من حيث الآليات إزداد دور تكنولوجيا المعلومات في طريقة عرض المواد التعليمية.
ومن حيث الأهداف تعزز التركيز على تطوير المهارات للتعامل مع التكنولوجيات والأجهزة الحديثة واستخدام مصادر المعلومات بفاعلية من أجل إنتاج معارف جديدة, ومن حيث الجمهور أصبح التعليم عابراً بشكل متزايد للفئات العمرية عن طريق توفير الفرص للعمل والتعليم في آن واحد.ولا شك بأن التغيرات والثورات المعلوماتية والتقنية المتلاحقة خلال العقود الأخيرة قد فرضت تغيرات لا تطال العملية التعليمية فحسب بل أخذت كذلك تفرض على الجامعات تغييرات أفقية, على مستوى بناها التعليمية التقليدية, وعمودية على المستوى الإداري والتنظيمي, وهو ما نجم عنه تغيرات على المستوى الوظيفي للجامعة وما تضطلع بها من رسالة.قبل عدة أعوام تنبأ البرفسور الهولندي J.G. Wissema, وهو متخصص في الإدارة والريادة الأكاديمية ويمتلك شركة استشارية تحمل اسمه بالإضافة إلى مهنته الأكاديمية, بأن الجامعات بشكلها الحالي آخذة في الزوال ليحل مكانها تدريجياً نموذج جديد أسماه جامعة الجيل الثالث.
وقام بتأليف كتاب يحمل العنوان “Towards the Third Generation University” وهو كتاب لاقى رواجاً كبيراً بين الأكاديميين ويتوفر جزء هام منه من خلال كتب جوجل مجاناً للقراء.يبدأ الكاتب بالحديث عن التطور التاريخي للجامعات بدءاً بالجيل الأول الذي ظهر في العصور الوسطى معتبراً بأن هذه الجامعات انبثقت عن مدارس الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية في العصور الوسطى من أجل الدفاع عن الحقيقة, ومن ثم قامت بتأسيس بنىً أكاديمية للتعليم المنظم تهدف إلى نقل المعرفة كما تراها. وقد مر هذا النموذج من الجامعات بفترة انتقالية خلال عصر التنوير الذي شهدته أوروبا مما أثر بشكل رئيسي في رسالتها التي ارتقت من نقل المعرفة إلى إكتشاف معارف جديدة.ومن ثم ينتقل للجيل الثاني من الجامعات معتبرأ أن هذا النموذج قد أدخل البحث كعنصر إضافي للتدريس من أجل إكتشاف الطبيعة كهدف أساسي, وكرس أخذ القوانين العلمية بعين الإعتبار في الإنتاج الفكري. تشكلت هذه الجامعات من بنى علمية تخصصية (كليات) يقوم عليها أكاديميون لتخريج علماء ومهنيين. وقد انتشر هذا النموذج في بقاع جغرافية واسعة برؤى تحمل طابعاً محلياً مما فتح المجال لإستخدام اللغات المحلية في التعليم وبالتالي كسر احتكار اللغة اللاتينية للعملية التعليمية.
يعتبر الكاتب أن معظم الجامعات في العالم لا زالت قريبة من هذا النموذج.يتحدث الكاتب بعد ذلك عن مجموعة من الأسباب التي تفرض على الجامعات تحولات جوهرية تقود لظهور ما أسماه جامعة الجيل الثالث مورداً أن الجامعات الكبرى التي تقوم بالبحث العلمي المتقدم تقود هذا التحولات, وأن القوة الدافعة الأولى في ذلك تتمثل في الحاجة إلى تمويل البحث العلمي بالشراكة مع القطاعات التقنية نظراً لإرتفاع تكلفته, وهو ما يصادف حاجة لدى تلك القطاعات التي تسعى للإستفادة من البنى التحتية والخبرات المتوفرة لدى الجامعات. أما القوة الدافعة الثانية فتتمثل في العولمة التي تساهم في كسر الإحتكار المناطقي للجامعات وتدفعها للتنافس في اجتذاب أفضل الطلبة وأفضل الكفاءات البحثية من أجل الإستثمار في إنتاج التكنولوجيا والمعرفة. تتمثل القوة الدافعة الثالثة في التغير الحاصل في مواقف الحكومات والتي أصبحت تقتصد في تمويل النشاط البحثي وتوجه دعمها نحو تحويل الجامعات إلى حاضنات للإنتاج والإستثمار التقني. فيما يعتبر الكاتب أن القوة الدافعة الرابعة تنجم عن التغير الحاصل في طبيعة البحث العلمي الذي أضحى بيني التخصص مما يستلزم تغييراً في الهيكلية التقليدية المتمثلة في الكليات وإفراد مساحة أكبر للمعاهد ومراكز البحث.
يورد الكاتب أسباباً أخرى لهذه التحولات منها التزايد الكبير في عدد الطلبة والتحديات التي تفرضها المؤسسات البحثية الكبرى خارج حدود الجامعات. ومع أن الكاتب يرى أن جامعات كبرى تقود حالياً هذا التحول إلا أنه يرى كذلك بأن التغير سيطال لا محالة الجامعات الأخرى في العالم.
ويشدد الكاتب على أن اللغة الإنجليزية قد أضحت لغة العلم دون منازع.يتميز نموذج جامعة الجيل الثالث بإعتماده الأساسي على استثمار المعرفة الكيفية (know-how exploitation) من خلال الحاضنات التقنية وما شابه دون الإكتفاء بالتدريس والبحث العلمي, ويولي إهتماماً كبيراً لموضوع الريادة وإنتاج الرواد (entrepreneurs) بالإضافة إلى العلماء والحرفيين, معتمداً على الأساليب العلمية العابرة للتخصصات وتصميم مساقات خاصة تخاطب مواضيع منتقاة لها قيمة إضافية في السوق تسعى لتطوير المعارف والمهارات لجمهور منتقى من الطلبة والمهتمين. كذلك فإن هذا الجيل من الجامعات يتميز بالحرص على النزاهة الأكاديمية, وهو منفتح على العالمية وعلى التعاون مع جهات متعددة وأهمها القطاع التقني والإنتاجي تحت شعار حتى الأفضل لا يستطيع أن يمضي وحيداً.
في هذا الإطار يركز الكاتب على ما يسميه ظاهرة كامبردج وهي الجامعة التي تحوي ما يفوق ثلاثة آلاف شركة للتقنيات المتقدمة يبلغ عدد مستخدميها قرابة الستين ألفاً.وفي الجزء الأخير يتحدث الكتاب على الهيكلية الإدارية والجانب التمويلي لجامعة الجيل الثالث. في المجال التمويلي فإن هذه الجامعات تعتمد على أقساط الطلبة في تمويل كامل نشاطاتها التعليمية, دون أن تتلقى في هذا المجال مساعدات مباشرة من الدولة التي تؤمن بدورها بالشراكة مع مؤسسات مدنية صناديق إقراض ومساعدات للطلبة المحتاجين. أما النشاط البحثي والتطويري فيتم تمويله بشكل أساسي عن طريق منح حكومية, ووقفيات, وبالشراكة البحثية مع القطاع الصناعي, ويتم الإستثمار من أجل تحويل مخرجات صناعة المعرفة إلى مدخلات تمويلية للجامعات. بحسب الكاتب فإن التحول التمويلي من نظام يرتكز على المدخلات المالية التقليدية إلى نظام يرتكز على مردود المخرجات المعرفية سيفضي حتماً إلى نمو وتطور الجامعات التي تستثمر في البحث وإنتاج المعرفة ولكنه سيفضي في المقابل إلى إفلاس جامعات كثيرة لا تتبنى ذات النهج على المستوى الإداري فإن التغيير الحاصل في طبيعة الجامعات ودورها سيعني الحاجة إلى أن تدار بشكل حرفي إلى حد ما دون أن يعني ذلك الذهاب بالكامل إلى طريقة إدارة المؤسسات الصناعية لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلبياً في الطابع الأكاديمي وأن يؤدي إلى فقدان غير ضروري للحوافز والفاعلية داخل الجامعات.
وعليه فإن المهمة الأساسية لرئيس الجامعة, حسب الكاتب, تتمثل في تطوير الحرم الجامعي وإيجاد وقفيات تمويلية, أما نوابه فتتوزع بينهم الأدوار بحيث يتولى أحدهم موضوع نوعية التدريس وتطبيق التقنيات الحديثة في التعليم, ويتولى آخر موضوع البحث العلمي وتميزه, وتوكل إلى ثالث مهمة التعاون مع القطاع الصناعي واستثمار المعرفة في السوق, فيما يشرف رابع على النشاط المالي والإداري. ويتناول الكتاب في الختام نماذج مقترحة لمساعدة إدارات الجامعات في عملية التحول بإتجاه جامعة الجيل الثالث ويطرح طريقة تعتمد التغيير خطوة فأخرى على ثلاثة مستويات: الاستراتيجية الشاملة, البنية والثقافة, التعليم الأكاديمي والدعم غير الأكاديمي.ختاماً, فإنه ليس بالأمر اليسير الحكم على حتمية التحولات المذكورة أعلاه وانطباقها على كافة الجامعات في العالم أو إلى أي مدى يمكن أن تتحقق. كما أن الحكم على الجامعات الفلسطينية بناءً على ما سلف ذكره قد ينطوي على شيء من الغبن نتيجة خصوصية الحالة الفلسطينية وما ينجم عن تلك الخصوصية من معضلات ذاتية وموضوعية. وتبعاً لذلك فإن التغيرات المفترضة ليس بالضرورة أن تلتقي بالكامل مع مصالح تلك الجامعات على وجه الخصوص ومع المصلحة الوطنية بشكل عام. إلا أن تعدد الآراء حول هذا الموضوع لا ينفي عن جامعاتنا ضرورة التغير باتجاه تبني الأنماط والتوجهات الحديثة في التعليم خصوصاً ما يتعلق بطرح التخصصات البينية, والمساقات الموجهة لتطوير المهارات في مواضيع محددة لجمهور محدد, وتطوير قدرات الطلبة في التعامل مع مصادر التعليم الالكترونية والإفادة من الزخم المعلوماتي الذي توفره في إنتاج معارف جديدة. كذلك فإنه من غير الممكن المحاججة ضد ضرورة تنشيط البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية وتطوير العلاقات مع القطاعات الصناعية والإنتاجية ضمن ما هو متاح ولما فيه مصلحة الأطراف المتبادلة.